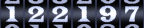أغدا ألقاك ؟
م يحيى حسين عبد الهادى;
أُفسح المساحة اليوم لهذه القصة الحقيقية التى عاشتها وحَكَتها الطبيبة العراقية المقيمة فى بريطانيا علياء الكندى .. تقول الطبيبة:
فى ظهيرة أحد الأيام فى شمال إنجلترا، تَطَّلَب عملى زيارة مريضٍ ثمانينى عاجزٍ يعيش وحيداً فى منزله ولا يقوى على الذهاب للطبيب بنفسه .. عرفتُ من سجله الصحى أن اسمه (جوشوا) وهو مصابٌ بسرطانٍ متقدمٍ فى أحد أعضائه ولا أمل فى شفائه .. يعيش على المسكنات، بعد أن رفض كل أنواع العلاج، وفَضَّلَ البقاء فى بيته ويموت فيه.
فتحتُ باب البيت بالرقم السرى المعروف لدينا ضمن السجلات .. ما أن دخلتُ حتى رَكَضَتْ نحوى كلبتُه الهزيلة .. و فهمْتُ من نظرتها دون أن يصدر عنها صوتٌ أنها تستنجد بى لكى أساعد صاحبها .. قادتنى نحو غرفته، فوجدته منزلقاً على كرسى كبير يكاد يسقط منه .. والوضع من حوله يُرثى له، فالسجاد مُلطخٌ ببقعٍ من كل الألوان، والرسائل والجرائد وعلب الطعام الفارغة ملقاةٌ فى كل مكان .. حتى طعام كلبته مُبعثرٌ فوق السجاد، إذ أنها كانت تُخرجه بنفسها من كيس طعام الكلاب المتروك قرب المدفأة .. المدفأةُ نفسها غطاها التراب لأن أحداً لم يُشعلها منذ زمن .. كان البيت بارداً جداً وكئيباً .. ولما وجدتُ الحبوب المُسكنة للألم مبعثرةً على الأرض أدركتُ أنها كانت تسقط من يديه المرتعشتين قبل أن يوصلها إلى فمه .. وسط كل هذه الفوضى، لفت انتباهى صورةٌ لأم كلثوم معلقة على الحائط.
نظر المريضُ إلىَّ وسألنى عن اسمى فأجبتُه، فقال: هل أنتِ عربية؟ قلتُ: نعم، عراقية .. فأشار إلى الصورة على الحائط وسألنى: هل تعرفين هذه؟ قلتُ له: بالطبع أعرفها .. قال: ما اسمها؟ .. قلت مُتعجبةً: إنها أم كلثوم، ولكن كيف تُعلق صورةَ امرأةٍ دون أن تعرفها؟ .. فقال: زوجتى (حسيبة) هى التى علقت صورتها، كانت تحبها كثيراً، هى عراقيةٌ مثلك لكنها يهودية .. اضطرت عائلتها لترك العراق، لأنهم يهود، ولكنهم كانوا ضد مبدأ اغتصاب الأرض فرفضوا العيش فى إسرائيل، ولجأوا إلى بريطانيا .. والتقيت بها أنا اليهودى البريطانى فى المعبد، وأحببتها، ووعدتها أن أعود بها إلى العراق لتعيش هناك، ولكننى لم أفِ بوعدى، إذ لم أجرؤ على المجازفة بالعودة بها، ولم تتوقف هى عن حلم العودة، وعن سماع أغنيةٍ مكررةٍ لهذه المطربة كل يومٍ على مدى أربعين عاماً، إلى أن ماتت .. سألتُه: هل تعرف الأغنية؟ فقال: للأسف لم أحفظ كلماتها، ولكن حسيبة أخبرتنى مرةً أن الجملة الأولى منها تعنى: هل سألتقيك غداً؟ (قالها بالإنجليزية) .. ففهمتُ أن زوجته كانت تستمع لأغنية (أغداً ألقاك؟) .. وأخبرتُه أننى أعرف الأغنية .. تَوَّسل إلىَّ أن أُسمعها له لأن حسيبة كانت تسمعها يومياً وتهديها للعراق .. وهو يريد أن يَسمعها ويهديها لحسيبة .. كان الرجل بين الحياة والموت .. لم يكن عندى وقتٌ، إذ كان علىَّ أن أغادر سريعاً لكى ألحق بباقى مرضاى .. أخبرتُه أننى سأتصل به من تليفون العيادة الأرضى وأترك هاتفى الجوال إلى جانب السماعة وأتركه يسمع الأغنية .. وهو ما حدث بالفعل .. تركتُه على الخط مع الأغنية .. وذهبتُ لمتابعة مرضاى .. عُدتُ إليه بعد ساعةٍ وربع الساعة.. كانت الأغنية قد انتهت منذ دقائق .. شكرنى وقال: أنتِ أفضلُ مِنِّى .. فقد حققتِ أمنية إنسانٍ على وشك الموت .. أما أنا فلم أحقق أمنية زوجتى قبل أن تموت .. تمنيتُ له ليلةً سعيدة وأغلقتُ الهاتف.
صباح اليوم التالى علمتُ أنه مات .. ارتحتُ إلى أن أمنية جوشوا قد تحققت بعد أن استمع للأغنية والتقى بحسيبة .. ومن يومها وأنا أستمع لأم كلثوم كل يومٍ تغنى (أغداً ألقاك) راجيةً أن أكون أوفر حظّاً من حسيبة .. وألتقى بالعراق غداً .. أو بعد غد.
هذه هى القصة (بتصرفٍ) كما رَوَتها د. علياء الكندى، ويمكن قراءتها من زوايا متعددة بالتأكيد .. أما أنا فقد استدعت من الذاكرة لقائى فى أمريكا منذ 35 عاماً بالطبيب المصرى د. حنا كبير أطباء مستشفى البلدة التى كنتُ أتدرب بها وزوجته المصرية .. كانا (يتنشقان) على أى قادمٍ من مصر ليكرماه ويخدماه .. كان حُبهما المتدفق لمصر ممتزجاً بشجنٍ غامضٍ .. عرفتُ سببه تحت إلحاح .. أستاذٌ ظالمٌ متعصبٌ حَرَمه من حقه كمصرىٍ متفوقٍ فى أن يكون معيداً فى إحدى جامعات الأقاليم فهاجرا حاملين فى قلبيهما الحب والجرح معاً .. عرفتُ الآن لماذا كان صوت أم كلثوم لا ينقطع من بيتهما، وكيف تحولت (هَجَرتَك) مثل (أغداً ألقاك) إلى أغنيةٍ وطنية، تنساب معها دمعتان صامتتان من عينيهما، لا سيما مع قول الست (لقيت روحى فى عز جفاك بافكر فيك وأنا ناسى) .. سامَحَ اللهُ بلاداً تُعَذِّبُ عشاقها .. ورَحِم الله أم كلثوم.
م يحيى حسين عبد الهادى;
أُفسح المساحة اليوم لهذه القصة الحقيقية التى عاشتها وحَكَتها الطبيبة العراقية المقيمة فى بريطانيا علياء الكندى .. تقول الطبيبة:
فى ظهيرة أحد الأيام فى شمال إنجلترا، تَطَّلَب عملى زيارة مريضٍ ثمانينى عاجزٍ يعيش وحيداً فى منزله ولا يقوى على الذهاب للطبيب بنفسه .. عرفتُ من سجله الصحى أن اسمه (جوشوا) وهو مصابٌ بسرطانٍ متقدمٍ فى أحد أعضائه ولا أمل فى شفائه .. يعيش على المسكنات، بعد أن رفض كل أنواع العلاج، وفَضَّلَ البقاء فى بيته ويموت فيه.
فتحتُ باب البيت بالرقم السرى المعروف لدينا ضمن السجلات .. ما أن دخلتُ حتى رَكَضَتْ نحوى كلبتُه الهزيلة .. و فهمْتُ من نظرتها دون أن يصدر عنها صوتٌ أنها تستنجد بى لكى أساعد صاحبها .. قادتنى نحو غرفته، فوجدته منزلقاً على كرسى كبير يكاد يسقط منه .. والوضع من حوله يُرثى له، فالسجاد مُلطخٌ ببقعٍ من كل الألوان، والرسائل والجرائد وعلب الطعام الفارغة ملقاةٌ فى كل مكان .. حتى طعام كلبته مُبعثرٌ فوق السجاد، إذ أنها كانت تُخرجه بنفسها من كيس طعام الكلاب المتروك قرب المدفأة .. المدفأةُ نفسها غطاها التراب لأن أحداً لم يُشعلها منذ زمن .. كان البيت بارداً جداً وكئيباً .. ولما وجدتُ الحبوب المُسكنة للألم مبعثرةً على الأرض أدركتُ أنها كانت تسقط من يديه المرتعشتين قبل أن يوصلها إلى فمه .. وسط كل هذه الفوضى، لفت انتباهى صورةٌ لأم كلثوم معلقة على الحائط.
نظر المريضُ إلىَّ وسألنى عن اسمى فأجبتُه، فقال: هل أنتِ عربية؟ قلتُ: نعم، عراقية .. فأشار إلى الصورة على الحائط وسألنى: هل تعرفين هذه؟ قلتُ له: بالطبع أعرفها .. قال: ما اسمها؟ .. قلت مُتعجبةً: إنها أم كلثوم، ولكن كيف تُعلق صورةَ امرأةٍ دون أن تعرفها؟ .. فقال: زوجتى (حسيبة) هى التى علقت صورتها، كانت تحبها كثيراً، هى عراقيةٌ مثلك لكنها يهودية .. اضطرت عائلتها لترك العراق، لأنهم يهود، ولكنهم كانوا ضد مبدأ اغتصاب الأرض فرفضوا العيش فى إسرائيل، ولجأوا إلى بريطانيا .. والتقيت بها أنا اليهودى البريطانى فى المعبد، وأحببتها، ووعدتها أن أعود بها إلى العراق لتعيش هناك، ولكننى لم أفِ بوعدى، إذ لم أجرؤ على المجازفة بالعودة بها، ولم تتوقف هى عن حلم العودة، وعن سماع أغنيةٍ مكررةٍ لهذه المطربة كل يومٍ على مدى أربعين عاماً، إلى أن ماتت .. سألتُه: هل تعرف الأغنية؟ فقال: للأسف لم أحفظ كلماتها، ولكن حسيبة أخبرتنى مرةً أن الجملة الأولى منها تعنى: هل سألتقيك غداً؟ (قالها بالإنجليزية) .. ففهمتُ أن زوجته كانت تستمع لأغنية (أغداً ألقاك؟) .. وأخبرتُه أننى أعرف الأغنية .. تَوَّسل إلىَّ أن أُسمعها له لأن حسيبة كانت تسمعها يومياً وتهديها للعراق .. وهو يريد أن يَسمعها ويهديها لحسيبة .. كان الرجل بين الحياة والموت .. لم يكن عندى وقتٌ، إذ كان علىَّ أن أغادر سريعاً لكى ألحق بباقى مرضاى .. أخبرتُه أننى سأتصل به من تليفون العيادة الأرضى وأترك هاتفى الجوال إلى جانب السماعة وأتركه يسمع الأغنية .. وهو ما حدث بالفعل .. تركتُه على الخط مع الأغنية .. وذهبتُ لمتابعة مرضاى .. عُدتُ إليه بعد ساعةٍ وربع الساعة.. كانت الأغنية قد انتهت منذ دقائق .. شكرنى وقال: أنتِ أفضلُ مِنِّى .. فقد حققتِ أمنية إنسانٍ على وشك الموت .. أما أنا فلم أحقق أمنية زوجتى قبل أن تموت .. تمنيتُ له ليلةً سعيدة وأغلقتُ الهاتف.
صباح اليوم التالى علمتُ أنه مات .. ارتحتُ إلى أن أمنية جوشوا قد تحققت بعد أن استمع للأغنية والتقى بحسيبة .. ومن يومها وأنا أستمع لأم كلثوم كل يومٍ تغنى (أغداً ألقاك) راجيةً أن أكون أوفر حظّاً من حسيبة .. وألتقى بالعراق غداً .. أو بعد غد.
هذه هى القصة (بتصرفٍ) كما رَوَتها د. علياء الكندى، ويمكن قراءتها من زوايا متعددة بالتأكيد .. أما أنا فقد استدعت من الذاكرة لقائى فى أمريكا منذ 35 عاماً بالطبيب المصرى د. حنا كبير أطباء مستشفى البلدة التى كنتُ أتدرب بها وزوجته المصرية .. كانا (يتنشقان) على أى قادمٍ من مصر ليكرماه ويخدماه .. كان حُبهما المتدفق لمصر ممتزجاً بشجنٍ غامضٍ .. عرفتُ سببه تحت إلحاح .. أستاذٌ ظالمٌ متعصبٌ حَرَمه من حقه كمصرىٍ متفوقٍ فى أن يكون معيداً فى إحدى جامعات الأقاليم فهاجرا حاملين فى قلبيهما الحب والجرح معاً .. عرفتُ الآن لماذا كان صوت أم كلثوم لا ينقطع من بيتهما، وكيف تحولت (هَجَرتَك) مثل (أغداً ألقاك) إلى أغنيةٍ وطنية، تنساب معها دمعتان صامتتان من عينيهما، لا سيما مع قول الست (لقيت روحى فى عز جفاك بافكر فيك وأنا ناسى) .. سامَحَ اللهُ بلاداً تُعَذِّبُ عشاقها .. ورَحِم الله أم كلثوم.
 Hitskin.com
Hitskin.com