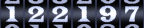لا انتقائية في التسامح
د. يوسف الحسن
* أتمنى ألا تتحول كلمة «التسامح»، لفرط استخدامها، إلى مجرد شعار، له جاذبيته الخطابية، أو موضة رائجة، تتردد على ألسنة الكثيرين من دون وعي وإدراك لمعناها الفلسفي والأخلاقي والقانوني، ومن دون تمثل جوهرها في سلوك الفرد تجاه الآخرين، المغايرين في فكرهم أو عقيدتهم أو لونهم أو عرقهم أو هويتهم أو أنماط عيشهم.
* التسامح، لا يعني التنازل عن حقوق، بل هو في حقيقته اتخاذ موقف إيجابي، يقر فيه الفرد بحق الإنسان الآخر في التمتع بحقوقه وحرياته الأساسية كإنسان، وهو إقرار بالتعددية والتنوع في المجتمع، وبأن العالم مكون من شعوب وثقافات وأمم وأعراق وألوان وألسنة، وبالتالي فإن هذا التنوع هو سنة إلهية وفطرة بشرية، والحوار والتعارف والتعاون والاعتراف المتبادل، هي السبيل لاستنباط المشتركات الإنسانية، والمصالح الموجودة في الاجتماع الإنساني.
ولا شك أن الحوار المتكافئ والإيجابي، يولد التواد، في حين أن الجهل بالآخر يقود إلى الافتراق والشكوك والتخاصم.
* إن الطبيعة الإنسانية واحدة، ورسالة الحضارة قائمة على الإيمان بوحدة الأصل البشري، وعلى الرغبة المشتركة في بلورة تفاهم وتعايش إنساني، يبطل المناخات المفعمة بالمخاوف، وبمشاعر العنصرية والكراهية، وبنزعات الهيمنة وإهدار كرامة الإنسان.
* إن اختلاف الناس، هو المدخل للتواصل والتعاون وتبادل الخبرة والتجربة، والتسابق إلى عمران الكون، ولا يعني التسامح، أن الاختلاف قد انتهى، فالتنوع سوف يستمر، لكن التعامل بين البشر، ينبغي أن يتم على قدم المساواة في القيمة الإنسانية، وفي احترام كرامة الفرد. ولنتذكر دوماً، أن رسالة الإسلام كانت «الرحمة للعالمين». أي الرحمة لكل البشر، كما تجلى مبدأ «عدم الإكراه في الدين»، في أن الديانات القديمة في الأقطار التي دخلها الإسلام، بقيت حية، وظلت أكثرية السكان في مصر والشام والأندلس مسيحية، حتى عصر حروب الفرنجة.
* باعتماد مفهوم التسامح، اجتازت أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر حروباً أهلية ودينية وحشية، وحققت تعايشاً بين مواطنيها، وقادها إلى عصور العقلانية والتنوير، لكن، من أسف.. فإن أوروبا لم تطبق هذه القاعدة في تعاملها مع الآخرين في إفريقيا وآسيا وعالم خارج أوروبا، خلال عصور الهيمنة والتمدد الكولونيالي، حتى أواسط القرن العشرين.
* إن المفهوم المعاصر للتسامح، ارتبط في الأساس بالدين، بعد أن شاعت في القرون الوسطى، دعوات الهرطقة والزندقة والتكفير، والتي أفضت إلى العنف.
* وها هو اليوم أكثر حاجة لتعزيز مفهوم التسامح الأخلاقي والديني والحقوقي، في مجتمعات العالم، وبخاصة في ظل تداعيات ثورات المعلومات والاتصال والتواصل الاجتماعي، وانتشار التشدد والتطرف والكراهية الجماعية.
* والتسامح لا يعني التنازل عن خصوصيات الهوية أو التراث، كما لا يعني التسامح مع العنصرية أو الظلم أو الاستبداد، باعتبار أن هذه الممارسات منبوذة ومذمومة أخلاقياً وقانونياً، ولا تستحق الاحترام.
* ولا يعني القول «بأنني أتسامح معك»، أنني أنا الغالب أو الأعلى، وأنت المغلوب أو الأدنى، فهذا المعنى فيه الكثير من معاني الفوقية، أما جوهر التسامح، فمؤداه هو الاعتراف بالاختلاف، واحترامه، وفي سياق الاختلاف، ينبغي أن نتعايش، ولا نقصي بعضنا بعضاً، وأن نراعي مشاعر الآخرين، ونقر بحق التنوع، في إطار إنسانيتنا المشتركة.
* وكثيراً ما سألني أصدقاء: هل للتسامح حدود؟ ومن يضع هذه الحدود وآلياتها؟ بمعنى آخر: هل سنجبر الآخر على أن يكون متسامحاً أيضاً، أم أن التسامح هو وعي ذاتي، وشرط ضروري لبناء السلم والتعاون والتضامن، بدلاً من الصدام والتوتر؟ وأقول دوماً إن التسامح ليس مجرد واجب أخلاقي، إنما هو أيضاً واجب سياسي وقانوني ومسؤولية.. لا تعرف الانتقائية.
* والتسامح، ليس مجرد فضيلة أخلاقية، كالعفو والصفح والمغفرة، وإنما هو اعتراف واحترام لحرية الاختلاف، وتحمل ما لا نحبه، أو ما هو غير منسجم مع أحكامنا ومعتقداتنا، والصبر على ما لا يعجبنا من أفكار وطرز حياة، ومقابلته بالحوار بعيداً عن ممارسة نفي الآخر، واتهامه بصفات ونعوت تسبب الشقاق والكراهية.. وفي حضرة التسامح، يتعزز التعايش، وتقبل احتمال وقوع الخطأ.
* ما زال الأمر بحاجة إلى تعزيز جهود نشر ثقافة التسامح، من قبل مؤسسات التعليم والإعلام، حتى يتحول مفهوم التسامح إلى قيمة أساسية في سلوكنا، وضمائرنا وهويتنا الثقافية الوطنية.
د. يوسف الحسن
* أتمنى ألا تتحول كلمة «التسامح»، لفرط استخدامها، إلى مجرد شعار، له جاذبيته الخطابية، أو موضة رائجة، تتردد على ألسنة الكثيرين من دون وعي وإدراك لمعناها الفلسفي والأخلاقي والقانوني، ومن دون تمثل جوهرها في سلوك الفرد تجاه الآخرين، المغايرين في فكرهم أو عقيدتهم أو لونهم أو عرقهم أو هويتهم أو أنماط عيشهم.
* التسامح، لا يعني التنازل عن حقوق، بل هو في حقيقته اتخاذ موقف إيجابي، يقر فيه الفرد بحق الإنسان الآخر في التمتع بحقوقه وحرياته الأساسية كإنسان، وهو إقرار بالتعددية والتنوع في المجتمع، وبأن العالم مكون من شعوب وثقافات وأمم وأعراق وألوان وألسنة، وبالتالي فإن هذا التنوع هو سنة إلهية وفطرة بشرية، والحوار والتعارف والتعاون والاعتراف المتبادل، هي السبيل لاستنباط المشتركات الإنسانية، والمصالح الموجودة في الاجتماع الإنساني.
ولا شك أن الحوار المتكافئ والإيجابي، يولد التواد، في حين أن الجهل بالآخر يقود إلى الافتراق والشكوك والتخاصم.
* إن الطبيعة الإنسانية واحدة، ورسالة الحضارة قائمة على الإيمان بوحدة الأصل البشري، وعلى الرغبة المشتركة في بلورة تفاهم وتعايش إنساني، يبطل المناخات المفعمة بالمخاوف، وبمشاعر العنصرية والكراهية، وبنزعات الهيمنة وإهدار كرامة الإنسان.
* إن اختلاف الناس، هو المدخل للتواصل والتعاون وتبادل الخبرة والتجربة، والتسابق إلى عمران الكون، ولا يعني التسامح، أن الاختلاف قد انتهى، فالتنوع سوف يستمر، لكن التعامل بين البشر، ينبغي أن يتم على قدم المساواة في القيمة الإنسانية، وفي احترام كرامة الفرد. ولنتذكر دوماً، أن رسالة الإسلام كانت «الرحمة للعالمين». أي الرحمة لكل البشر، كما تجلى مبدأ «عدم الإكراه في الدين»، في أن الديانات القديمة في الأقطار التي دخلها الإسلام، بقيت حية، وظلت أكثرية السكان في مصر والشام والأندلس مسيحية، حتى عصر حروب الفرنجة.
* باعتماد مفهوم التسامح، اجتازت أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر حروباً أهلية ودينية وحشية، وحققت تعايشاً بين مواطنيها، وقادها إلى عصور العقلانية والتنوير، لكن، من أسف.. فإن أوروبا لم تطبق هذه القاعدة في تعاملها مع الآخرين في إفريقيا وآسيا وعالم خارج أوروبا، خلال عصور الهيمنة والتمدد الكولونيالي، حتى أواسط القرن العشرين.
* إن المفهوم المعاصر للتسامح، ارتبط في الأساس بالدين، بعد أن شاعت في القرون الوسطى، دعوات الهرطقة والزندقة والتكفير، والتي أفضت إلى العنف.
* وها هو اليوم أكثر حاجة لتعزيز مفهوم التسامح الأخلاقي والديني والحقوقي، في مجتمعات العالم، وبخاصة في ظل تداعيات ثورات المعلومات والاتصال والتواصل الاجتماعي، وانتشار التشدد والتطرف والكراهية الجماعية.
* والتسامح لا يعني التنازل عن خصوصيات الهوية أو التراث، كما لا يعني التسامح مع العنصرية أو الظلم أو الاستبداد، باعتبار أن هذه الممارسات منبوذة ومذمومة أخلاقياً وقانونياً، ولا تستحق الاحترام.
* ولا يعني القول «بأنني أتسامح معك»، أنني أنا الغالب أو الأعلى، وأنت المغلوب أو الأدنى، فهذا المعنى فيه الكثير من معاني الفوقية، أما جوهر التسامح، فمؤداه هو الاعتراف بالاختلاف، واحترامه، وفي سياق الاختلاف، ينبغي أن نتعايش، ولا نقصي بعضنا بعضاً، وأن نراعي مشاعر الآخرين، ونقر بحق التنوع، في إطار إنسانيتنا المشتركة.
* وكثيراً ما سألني أصدقاء: هل للتسامح حدود؟ ومن يضع هذه الحدود وآلياتها؟ بمعنى آخر: هل سنجبر الآخر على أن يكون متسامحاً أيضاً، أم أن التسامح هو وعي ذاتي، وشرط ضروري لبناء السلم والتعاون والتضامن، بدلاً من الصدام والتوتر؟ وأقول دوماً إن التسامح ليس مجرد واجب أخلاقي، إنما هو أيضاً واجب سياسي وقانوني ومسؤولية.. لا تعرف الانتقائية.
* والتسامح، ليس مجرد فضيلة أخلاقية، كالعفو والصفح والمغفرة، وإنما هو اعتراف واحترام لحرية الاختلاف، وتحمل ما لا نحبه، أو ما هو غير منسجم مع أحكامنا ومعتقداتنا، والصبر على ما لا يعجبنا من أفكار وطرز حياة، ومقابلته بالحوار بعيداً عن ممارسة نفي الآخر، واتهامه بصفات ونعوت تسبب الشقاق والكراهية.. وفي حضرة التسامح، يتعزز التعايش، وتقبل احتمال وقوع الخطأ.
* ما زال الأمر بحاجة إلى تعزيز جهود نشر ثقافة التسامح، من قبل مؤسسات التعليم والإعلام، حتى يتحول مفهوم التسامح إلى قيمة أساسية في سلوكنا، وضمائرنا وهويتنا الثقافية الوطنية.
 Hitskin.com
Hitskin.com