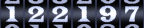اختراع العرق الأبيض: الإمبراطورية ومخاضات الأفول
أحمد حسن
«لم تولد العبودية من العنصرية. على العكس، العبودية هي التي استولدت العنصرية»
إريك ويليامز «الرأسمالية والعبودية»
جرياً على عادة أسلافه من الأباطرة، اتخذ «رومولوس أوغسطس»، الإمبراطور الأخير للإمبراطورية الرومانية الغربية (حكم من 460-476)، لنفسه لقب «أوغسطس». لكن الناس، والتاريخ، سيطلقون عليه استهزاء «موميلوس (العار أو الفضيحة) أوغسطولوس (الصغير)». كانت هذه إشارة، وحتى حكماً على دور ومسؤولية رومولوس أوغسطس عن سقوط الإمبراطورية. لكن «الإمبراطورية هي التي صنعت الأباطرة، وليس العكس»، تخبرنا المؤرّخة ماري بيرد في دراستها «مجلس الشيوخ والشعب الروماني: تاريخ روما القديم»* (1).
وفي الولايات المتحدة المشتعلة الآن بالاحتجاجات، ليست القضية، ولم تكن أبداً، في عنصرية ترامب، أو أي رئيس قبله أو بعده، برغم وقاحته، وحتى فاشيته، إن أردتم* (2). فيمكن للأقليات، وبحق، أن يلوموه على الكثير (حتى على الطقس السيّئ)، لكنه لم يخترع العنصرية، وليس سبب مأسستها وقوننتها، ولم يخترع همجية الشرطة ولا قتل الأقليات. هو ورثها فقط، ويستغلها انتخابياً متى ظن أن ذلك ممكن. فالعنف المستمر ضد الأقليات هو حاجة دائمة ومستمرة وبنيوية للنظام القائم على إخضاعهم، ولا يمكنه إخضاعهم والاستمرار بالعمل والربح من دون العنف. ومن يعرف كيف تمّت كتابة الدستور الأميركي، ومن كتبه، وظروف كتابته، وحتى المساومات الموثقة التي جرت بخصوص «تجارة العبيد» تحديداً، سيعرف أن جذور القضية ضاربة في التاريخ الأميركي وبنية مؤسساته وقوانينه، حتى قبل حتى تأسيس الجمهورية بقرون* (3). ومن قرأ ما كتبه الرئيس الأسود الأوّل* (4)، أوباما، وسمع ما قاله لاحقاً* (5) في الأيام الأولى للانتفاضة، سيعرف حقاً حدود وإمكانية مسار الحراك الراهن (وهو برأيي يمثّل قاعدة مهمة من الطبقة الوسطى السوداء التي ستدافع عن النظام حتى اللحظة الأخيرة، ولها مصلحة في النظام القائم، وحتى في العنصرية ضد أبناء جلدتها). وأوباما سيدخل التاريخ، كالرئيس الذي أضرّ بالأقليات أكثر من غيره، سواء عبر الأوهام التي انتشرت في أعقاب انتخابه عن دخول أميركا مرحلة «ما بعد الأعراق» والعنصرية، أو سياساته بخصوص العلاقات العرقية وعنف الشرطة، حتى لا نتحدث عن القتل بالطائرات بدون طيار في دول الجنوب – كان الحل الذي اجترحه أوباما، مثلاً، أثناء رئاسته، لاعتداء شرطي أبيض على أستاذ أسود معروف من جامعة هارفرد هو دعوة الاثنين لشرب كأس من البيرة معه في البيت الأبيض (عُرفت لاحقاً بـ«قمّة البيرة»).
يبدو من الأكيد أن ما يجري الآن من احتجاجات لن يقود إلى «إعادة بناء الجمهورية»، التي فشلت حتى بعد حرب أهلية طاحنة (انتصر فيها سياسياً من هُزِم عسكرياً)، أو أنها ربما لن تغيّر كثيراً حتى في موازين القوى في الانتخابات بعد أشهر. فالإمبراطورية عاجزة بنيوياً عن حل المشكلة العنصرية، وفي الحقيقة هي لن تكون أميركا، ولا حتى إمبراطورية، إن فعلت ذلك (إلا إذا كنا نظن أن تمويل طريقة حياة الغرب تتم فعلاً من عائدات السياحة والتجارة والدبلوماسية، ولا دور للعنصرية في ذلك). فالعنصرية، والتمييز ضد المرأة أيضاً، مربحان تماماً لرأس المال وهما بعض آليات تراكمه. فمعدل القيمة الفائضة يرتفع بالضرورة مع ارتفاع نسبة الاضطهاد، لما له من أثر على تخفيض الأجور وزيادة القوة الشرائية للشرائح المتوسطة والغنية، تماماً كما يرتفع أيضاً معدّل القيمة الفائضة مع العولمة النيوليبرالية في حالة دول المركز الرأسمالي (ما يسمّيه إيمانويل والرشتين «التوتر الأيديولوجي للرأسمالية»)* (6). رغم كل ذلك، فإن ما يجري على الأرض الآن لن يكون بلا تبعات، ويمكن اعتبار ما يجري الآن أحد المخاضات المتزايدة لمسار الأفول الذي دخلته الإمبراطورية منذ سنين* (7)، ومؤشراته البنيوية (اقتصادياً، سياسياً، حال البنية التحتية، إلخ) تحظى بإجماع الخبراء منذ سنين. ربما يكون هذا هو المهم في كل ما يجري الآن بسبب تبعاته البعيدة المدى خارج أميركا أيضاً.
لهذا، ففي الوقت الذي يمكن أن ترتفع فيه الآمال بتخفيف العنصرية لدى البعض نتيجة ما يحدث، فإن النتيجة قد تكون العكس تماماً، طالما لم تهتز مكانة الإمبراطورية وصورتها وأدواتها الناعمة كثيراً، وهو ما ليس بمقدور الحراك بشكله الحالي فعله. ففي غياب البديل الأيديولوجي مطلقاً، وفي ظل الهيمنة الأيديولوجية للرأسمالية المتوحّشة، حتى في صفوف غالبية المحتجين الذين ينظر بعضهم إلى القضية فقط من زاويتها الأخلاقية (بلا تغييرات بنيوية)، وفي ظل توفر قدرة هائلة لدى «أجهزة الدولة القمعية»، كما يسميها لوي التوسير، لقمع الانتفاضة وتدمير الأيديولوجية المناهضة للعنصرية، وسحق طرق تنظيم المعارضة، ربما سيجد رأس المال فرصة أخرى لإعادة إنتاج العنصرية وستكون النتيجة في المدى البعيد (بمعنى الزمن الاجتماعي وليس الوقتي) عكس ما يريد المحتجّون تماماً. هذا متوقّع أساساً بسبب القوة الأيديولوجية الهائلة للمنظومة الليبرالية القائمة – أوباما، مثلاً، في أقل من جملتين في كلمته أعاد إنتاج شخصيتي مالكولم إكس، الذي تبنى نظرية الاستعمار الداخلي وحتى طالب بالانفصال في البداية، ومارتن لوثر كنغ، الذي أدرك في آخر أيامه على الأقل علاقة الرأسمالية بالعنصرية، ليظهرا كأنهما كانا مؤمنين بالمنظومة العنصرية ولا يريدان سوى إصلاحها فقط* ( . هنا يكمن الخطر الحقيقي على الحراك ومساره.
. هنا يكمن الخطر الحقيقي على الحراك ومساره.
أدوات الإمبراطورية الأيديولوجية
حين تقرأ عبارة عالم الاجتماع الفرنسي آلان تورين: «إن جوهر علم الاجتماع هو مقاومة كل أشكال السلطة»* (9)، أو عبارة عالم الاجتماع الأميركي هوارد بيكر الشهيرة: «في صَفِّ مَنْ تَقِفْ؟»، التي توحي بأن الاختصاصيين في هذا الحقل المعرفي يقفون دوماً وأبداً مع المضطهدين* (10)، وغيرها الكثير، فربما ستنطلي عليك فعلاً أسطورة الدور والوظيفة التحرّرية لعلم الاجتماع الغربي، ووعده المزور باسم «ملاك التاريخ لإنقاذ وعد التقدّم»، كما ادعى رئيس جمعية علم الاجتماع الأميركي مايكل برواي، في اجتماع الجمعية العامة في 2004* (11). هذه العبارات الطنانة تُخفي من السجل التاريخي لعلم الاجتماع الغربي نظريّات مُؤَسِسة لهذا الحقل المعرفي سادت لفترة طويلة، مثل «الداروينية الاجتماعية» و«التطورية الثقافية»، وحتى «علم تحسين النسل»، وتخفي الدور الأساسي لعلماء اجتماع أميركيين مؤسسين للحقل في صياغتها وتسويقها من وليام سومنر وليستر وارد إلى إدوارد روس، كما تخفي من هذا السجل الاستثناء المنهجي والمتعمّد لـ«زنادقة» علم الاجتماع، أو ما أصبح يسمى بـ«علم الاجتماع الأسود»، فقط لتجرّئهم على التفكير بطريقة مختلفة جوهرها التنظير للعلاقة العضوية بين الرأسمالية والعنصرية، مثل ويليام دوبويس وأوليفر كوكس. هذه النظريات، المحسوبة على التيار العام لم تؤسس حقاً لأي فهم تحرري أو علمي في أي من قضايا العرق والإثنية والقومية والجندر. بل، على العكس. فلقد ساهمت لاحقاً في إنتاج المزيد من طبقات التشويش المعرفي التي ساعدت، ولا تزال، على تعزيز وحتى تبرير الممارسات التمييزية العنصرية المستمرة ضد الأميركيين من أصل أفريقي، وكل ما يقع تحت ما يسمّى فئة «الأجناس الأدنى».
وهذا ليس خللاً معرفياً، أو حتى خطأ أو جهلاً مرحلياً تم تجاوزه لاحقاً. فعلم الاجتماع الغربي، كـ«حقل معرفي»، كما يعرف من يعرف جيّداً، هو في الحقيقة أحد حرّاس القلعة وإحدى أدوات صناعة الأيديولوجيا، كغيره من العلوم الاجتماعية والإنسانية التي حوّلت الجامعات ودورها الأيديولوجي إلى جيش تفوق أهميته أحياناً وفعلاً الجيوش التقليدية. وليست القضية فقط هنا أننا نادراً ما نرى إضاءة، ولو بالحد الأدنى، على أهمية ودور العنصرية في صنع وتشكيل الحداثة الرأسمالية الغربية فقط وتشكيل النظام الرأسمالي العالمي – في الحقيقة لا توفّر الأدوات التحليلية ولا المفردات اللغوية التقليدية لعلم الاجتماع الأميركي السائد إمكانية كبيرة لكشف العلاقة التاريخية والعضوية بين الرأسمالية والصراعات الطبقية والعنصرية، وخصوصاً أن الحُكم الرأسمالي، كما سنرى، تَعَزَّزَ جداً من خلال عملية «التفاضل العرقي» والترتيب الهرمي للبروليتاريا في العالم، أو ما يسميه إيمانويل والرشتين «عرقنة العمل»، التي أسس لها أصلاً بعض علماء الاجتماع وعلم الإنسان. فمن استعمار فرجينيا في القرن السابع عشر إلى بريطانيا الفيكتورية وما بعدها، كانت العنصرية سلاحاً مهمّاً وأساسياً ولا غنى عنه في ترسانة نُخَب الدول الرأسمالية والاستعمارية، واستخدمت بفعّالية كبيرة لاحتواء الصراعات الطبقية وتشتيت الطبقة العاملة بهدف جعل النظام أكثر أمناً وحتى أكثر فعّالية لتراكم رأس المال.
قصّة الرأسمالية السائدة في الغرب عموماً، وفي الولايات المتحدة تحديداً، مزوّرة لحد كبير باستثنائها الدور البنيوي للعنصرية. هذا التزوير، طبعاً لم ينته، ويستمر إلى الآن في حقول معرفية عديدة، حتى بعض تلك الحديثة منها، والتي يعتقد البعض أيضاً أن لها دوراً تحررياً أيضاً، كنظريات «ما بعد الاستعمار»، مثلاً، التي تميل إلى التنظير عن المواجهة الحضارية بين الغرب (كلّه) ومستعمراته السابقة (كلّها) فتساهم في إخفاء تعددية العنصرية، بما في ذلك عرقنة واضطهاد أجزاء من البروليتاريا الأوروبية (الجنوب في الشمال، أو الشرق في الغرب، إن أردتم). هذا الفهم مهم في هذه الحالة، فرؤية وإدراك الدور البنيوي للعنصرية والطرق المتباينة والمختلفة التي تم بها دمج البروليتاريا في علاقات الهيمنة الرأسمالية ستكون لهما آثار مهمة وحاسمة على أي سياسة تحررية. فتجاهل الدور الكبير للعنصرية ماضياً وحاضراً (مثل الدعاية الليبرالية الخبيثة عن «سياسة عرقية عمياء») سيُبقي الظلم الناتج عن العنصرية التاريخية والمعاصرة، وسيعيد إنتاج وظيفته في تراكم رأس المال. حتى الآن، لم نسمع عن أي نهج (أو حتى شعار) بديل للأسف يشدد وبوضوح لا لبس فيه على ترابط مطالب العدالة الاقتصادية بمكافحة العنصرية. هكذا فقط يتم إزالة أي غموض عن الاختلافات المتأصّلة في الجسم الجماعي للبروليتاريا والفقراء والأقليات من قبل الرأسمالية.
لكن مشكلة الأقليات (والحراك) في الولايات المتحدة ليست علم الاجتماع فقط، وليست حتى أجهزة الشرطة ولا عنصريتها (سواء كانت مؤسسة أم أفراداً) أيضاً – في الحقيقة ربما تكون أجهزة الدولة القمعية، من الشرطة إلى الحرس الوطني، وحتى المنظمات اليمينية المسلحة، هي الأقل خطورة في المواجهة الدائرة الآن، كون دورها القمعي وانحيازاتها مكشوفة وواضحة. فالأقليات، والسود منهم تحديداً، يواجهون كل المنظومة الليبرالية الهائلة، وكل أدواتها الناعمة وعدتها من الديمقراطية الليبرالية إلى هوليوود، ومن فلاسفة اللاعنف إلى وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث والجامعات، التي هيمنت على رواية الانتفاضة منذ البداية (وخدمها أوباما وأمثاله من طواويس الأقليات وأبناء النظام أكثر من غيرهم ربما)، وبدأت بإعادة توجيهها بطريقة سيحسدها عليها جداً جماعة «المجتمع المدني» في بلادنا (رغم أن نجاحهم للحق، نسبة إلى حجم الدعم الخارجي ورخص ثمنهم، كان لافتاً). فكل تلك البنية التحتية المؤسسية الهائلة لإنتاج الأيديولوجيا كانت في المعركة حتى قبل أن تبدأ، وترى أنه بإلقاء اللوم على ترامب وسياساته وأسلوبه فقط ليس وسيلة لتبرئة نفسها وغسل دورها التاريخي الفاعل جداً في الاضطهاد، بل فرصة (ليس لإنقاذ النظام، فلا خطر عليه حقاً) لاستخدام الحراك في الصراع بين النخب، وإعادة إنتاج ذات النظام العنصري بشكل أكثر كفاءة، وربما (ربما) أيضاً التخلّص من ترامب. أحد آخر استطلاعات الرأي الذي أجرته «أي بي سي» و«واشنطن بوست» يظهر تفوّق بايدن على ترامب (53٪ - 43٪) بين المنتخبين المسجلين، وهو ما يضع بايدن (في هذا الوقت قبل الانتخابات، وبهذه النسبة الآن) في أفضل موقع لمرشح رئاسي يواجه الرئيس منذ عام 1930، حسب «سي أن أن»* (12). لكن، هل يملك بايدن الإجابة على أسئلة ومطالب المحتجين؟ أحد خطابات بايدن (ذي التاريخ العنصري الموثّق) في مجلس الشيوخ من عام 1993 يؤكد أنه يمكن أن يكون أكثر فظاظة حتى من ترامب* (13)، وهذا كان في الوقت نفسه الذي أطلقت فيه هيلاري كلينتون وصفها الشهير «المفترسين الفائقين» على الأطفال السود في سعيها لتمرير «قانون الجريمة» الذي تبنته إدارة زوجها وكانت الأقليات ضحاياه الأولى. لكنهم لا يرون أي وقاحة في طلبهم الصوت الأسود في الانتخابات دائماً بتحذير الأقليات أن البديل هو أمثال ترامب وباري غولدووتر* (14).
هكذا اخترعت بريطانيا العِرق الأبيض
في أيّار عام 1607، «كانت ثلاثُ سفنٍ صغيرة تُبْحر عبر خليج تشيسابيك، بين ميريلاند وفيرجينيا، باتجاه نهر جايمس، بحثاً عن مكانٍ لإقامة المستوطِنة الإنكليزيّة الأولى الدائمة في أميركا الشماليّة». لم يكن خيارُ شبهِ الجزيرة تلك، المعروفةِ اليوم باسم جايمس تاون، مثالياً على الإطلاق، لكونها منخفضةً ومليئةً بالمستنقعات. لكنّ هذا السبب بالضبط (أيْ لكونها شبهَ جزيرة) هو الذي جعلها الخيارَ الأفضلَ للمستوطنين من الناحية الدفاعيّة في مواجهة أيّ «اعتداءاتٍ» محتملةٍ من السكّان الأصليين* (15). وفي هذا الخيار، كان المستوطنون الإنكليز يؤكّدون حقيقتين مهمّتين: الأولى، أنّ هذه البلاد ليست خاليةً من السكّان، وهو ما يفسِّر إعطاءهم الهمَّ الأمنيَّ أولويّةً قصوى في تحديد المكان. والثانية، أنّ جايمس تاون ليست مجرّدَ جسرٍ بحريّ آخر أقامته القوى الاستعماريّةُ في مناطق مختلفة من العالم ليكونَ قاعدةً متقدّمةً للحراسة، أو لحمايةِ الطرق التجاريّة، بل هي مشروعٌ استعماريّ من نوعٍ جديد، سيؤدّي إلى تأسيس الإمبراطوريّة الأميركيّة. فخلال أقل من ثلاثين عاماً على تلك الحادثة، تم تأسيس أربع مستوطنات إنكليزية أخرى: جزر سومرز (برمودا) عام 1612، مستعمرة بليموث (في ولاية ماساتشوستس) عام 1620، باربادوس (شرق الكاريبي) عام 1627، وميريلاند في عام 1634.
لكن واجه المستعمِرون الأوروبيون، بلا استثناء، معضلة مزدوجة، يقول ثيودور ألين، في المجلد الثاني من «اختراع العرق الأبيض»* (16)، هدّدت إمكانية نجاح المشروع الاستعماري برمّته: «كيفية تأمين إمدادات كافية من العمالة»، وأيضاً، وربما حتى أكثر أهمية في حالة إنكلترا تحديداً، «كيفية تأسيس واستدامة درجة معيّنة من السيطرة الاجتماعية اللازمة لضمان التوسع السريع والمستمر لرأس المال من خلال استكشاف هذا العمل». لكن في كل من هذه القضايا، اختلفت الحالة الإنكليزية بطرق كان لها تأثير حاسم على أصل وشكل «مؤسسة العبودية» أوّلاً، والقمع العنصري الأبيض لاحقاً، تحديداً في القارة الأميركية الشمالية.
ففيما واجهت كل الدول الاستعمارية معضلة توفير «العمالة الكافية» في المستعمرات حينها، لأسباب سياسية، اقتصادية، ديموغرافية (انتشار الطاعون 1596-1602 الذي قضى على أكثر من 10% من سكان إسبانيا،) وعسكرية (جزء مهم من الجيش الإسباني كان من المرتزقة، وكان عليهم بالإضافة إلى المشروع الاستعماري محاربة الدولة العثمانية ومنافسة الدول الأوروبية الأخرى، فيما اضطرت البرتغال بـ 1,4 مليون مواطن فقط للتنازل مؤقتاً عن البرازيل إلى هولندا لانشغالها في صراعات متعددة)، كانت بريطانيا وحدها تشهد فائضاً سكانياً كبيراً نتيجة ثلاثة عوامل على الأقل: تطور اقتصاد صناعة الملابس والصوف (وبالتالي تطور صناعة الرعي وتربية الماشية) المربح حينها، على حساب الزراعة ما دفع الكثير من الفلاحين إلى الفقر والبطالة، وزيادة عدد السكان بسبب بُعد الجزيرة عن الأمراض التي ضربت الدول الأخرى، وعودة عشرات آلاف الجنود من الخارج في عام 1546 في فترة هنري الثامن. وعدا عن كون الهجرة طريقة للتخلّص من الفائض السكاني وحل مشكلة البطالة، كانت بريطانيا الدولة الوحيدة القادرة على إرسال يد عاملة بيضاء إلى المستعمرات، لدرجة أن البحث عن الفلاحين العاطلين عن العمل والفقراء والمجرمين وإغراءهم للهجرة ثم نقلهم إلى المستعمرات أصبحت صناعة مربحة مسؤولة حينها عن نمو مدن كليفربول ومانشستر التي كانت مراكز للهجرة. لكن اليد العاملة البريطانية لم تكن تكفي حتى للعمل في المستعمرات البريطانية لوحدها، فيما كان السكان الأصليون الذين تم استعبادهم وإجبارهم على العمل يتعرّضون للإبادة بسبب ظروف العمل والأمراض (تراجع عدد سكان المكسيك إلى ما يقارب الـ 14 مليوناً عام 1492، عام وصول كولومبوس، إلى مليون ومئة ألف فقط عام 1605، فيما تمّت إبادة سكان هايتي كلياً). كان الحل الذي اقترحه القسيس (والمؤرخ) برتولومي دي لا كاسس، ووافق عليه ملك إسبانيا في عام 1517 هو استقدام يد عاملة من أفريقيا. وفي عام 1517، أصدر الملك الإذن بتصدير 15 ألف مستعبد أفريقي إلى سان دومينغو. وهكذا «أطلق الكاهن والملك على العالم العبودية وتجارة العبيد الأميركية»، كما كتب سي. ل. ر. جايمس في «اليعاقبة السود».
لكن صناعة «تجارة العبيد» المربحة جداً حينها، بالإضافة إلى الفائض الهائل للقيمة الذي أنتجته اليد العاملة الأفريقية المستعبدة في المستعمرات، لم يؤسسا للنظام الرأسمالي العالمي الذي نعيش فيه فقط ولم يجعلا من العنصرية عاملاً بنيوياً ومؤسساً للرأسمالية، بل وجعل من بريطانيا اللاعب الأهم فيه. فبريطانيا لم تكتف بتجارة العبيد واستخدامهم في زراعة وحصاد محاصيل السكر، التبغ، القطن، وغيرها في المستعمرات، بل وحتى كانت توفّر وتبيع المستعبدين لمنافسيها الأوروبيين لاحقاً. لكن الدور البريطاني ربما الأهم، كان في الدور الكبير المتمثل بسياسات ومؤسسات الإخضاع والسيطرة الاجتماعية التي كانت تمتلك من الخبرة فيها بسبب تاريخ طويل من قمع تمردات العمال والفلاحين والفقراء أكثر من أي دولة استعمارية أخرى.
العامل الحاسم الذي ميّز بريطانيا عن غيرها من الدول الاستعمارية، وجود طبقة عاملة بيضاء من أصل إنكليزي في المستعمرة البريطانية في أميركا يمكن لها أن تتمرّد مع حليفها الأفريقي المستعبد والحر، كما حصل في ثورة ناثانيال بيكون في عام 1675 (رغم أنها كانت موجهة في البداية ضد السكان الأصليين، إلا أنها تطورت لاحقاً ضد الحاكم البريطاني، وانتهت بإحراق جايمس تاون). الرد الإنكليزي نتيجة للرعب الذي أصاب كبار الملاك البيض من احتمال تحالف العامل الأفريقي والأوروبي والثورة على النظام، كان بسلسلة من القوانين أصدرها مجلس ولاية فرجينيا على مدى أكثر من نصف قرن جعلت من سواد البشرة تدريجياً دلالة على الدونية (من خلال مراقبة السود المستعبدين والأحرار على حد سواء وقمعهم واستعبادهم جميعاً لاحقاً) وفي الوقت نفسه جعلت بياض البشرة مقياساً للتفوّق من خلال سلسلة من الامتيازات لم يكن أقلها قانون تحرير كل عمّال السخرة البيض. هكذا صُمّمت فكرة العرق الأبيض لخلق طبقة عازلة من العمّال البيض، بين كبار الملاك والمستعبدين وعمّال السخرة، وتحوّلت تدريجياً مع مأسستها إلى الأيديولوجيا السائدة وحتى الرسمية.
خاتمة: باكس أمريكانا؟
لكن مأسسة العنصرية وقوننتها تصاعدتا أكثر منذ كتابة الدستور الأميركي الذي بنيت على أساسه كل القوانين والمؤسسات اللاحقة (القسم التاسع من المادة الأولى، مثلاً، لم يُشَرِّعْ تجارة العبيد فقط، بل وحتى حظرّت على الحكومة الفيدرالية إلغاءها قبل عام 1808 وفقط بتفويض من الكونغرس، فيما المادة الرابعة، القسم الرابع، يفرض على الحكومة الفيدرالية المساهمة مع الولايات في قمع أي انتفاضات محتملة للمستعبدين). وحتى حين تمّت تجربة عكس بعض قرارات المحكمة العليا بعد سنين مثلاً، يكون ما تم التأسيس له بعد سنين واقعاً يصعب، وأحياناً يستحيل، تجاوزه، وهو ما يفسّر لماذا يتزايد الفصل العرقي في السكن في بعض المناطق الآن أكثر من السابق (كما حصل في قرار براون ضد مجلس التعليم في عام 1954 الذي عكس قرار بليسي ضد فيرغسون الذي شرع الفصل العنصري في عام 1896).
مشكلة الحراك الأميركي الأساسية أن الهيمنة الأيديولوجية للمنظومة الليبرالية تنجح تدريجياً في وضع الناس أمام خيار ترامب أو بايدن. ومن يعرف قليلاً من تاريخ بايدن في مجلس الشيوخ، ودوره في تمرير قوانين عنصرية تمسّ بحياة الأقليات يومياً، سيتأكد من دقة حكم الصحافي كريس هيدجيز أن «ترامب ورث النظام، أما بايدن فقد بناه».
لكن يبقى أن الحراك مؤشر ضعف بنيوي للإمبراطورية وسيعجّل من الأفول، وخصوصاً بسبب العجر البنيوي للنظام عن حل مشكلة العنصرية، بغضّ النظر عن نتائجه المباشرة والقصيرة المدى. ما يجري اليوم في الولايات المتحدة وتعاطي أجهزة الدولة معه يكشفان لنا، ولو جزئياً، جواب السؤال الذي طرحه مرة إيمانويل والرشتين: «انتهى باكس أمريكانا. كشفت التحديات من فييتنام والبلقان إلى الشرق الأوسط و11 سبتمبر عن حدود التفوّق الأميركي. هل ستتعلّم الولايات المتحدة كيف تتأقلم مع الأفول بهدوء، أم أن المحافظين الأميركيين سيقاومون ذلك، وبالتالي سيحوّلون التدهور التدريجي إلى سقوط سريع وخطير؟»* (17).
هوامش:
* (1) Mary Beard. 2015. “SPQR: A History of Ancient Rome”. NY: Liveright. P: 257
* (2) انظر: أميركا والقابلية للفاشية: تشريح مختصر للترامبية
https://www.almayadeen.net/butterfly-effect/679803
* (3) http://www.al-safsaf.com
* (4) https://medium.com/@BarackObama/how-to-make-this-moment-the-turning-point-for-real-change-9fa209806067
* (5) https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-today.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage#link-2f9c7b40
* (6) Immanuel Wallerstein. 1996. The Ideological Tensions of Capitalism: Universalism Versus Racism and Sexism. In Balibar, Etiene and Immanuel Wallerstein. Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. Pp 29-36.
* (7) Immanuel Wallerstein. “The Eagle has Crash Landed”. Foreign Policy. November 11, 2009.
https://foreignpolicy.com/2009/11/11/the-eagle-has-crash-landed/
* ( https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-today.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage#link-2f9c7b40
https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-today.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage#link-2f9c7b40
* (9) A. Touraine. (2007). "Public sociology and the end of society". In Public sociology (pp. 67–78).
Berkeley: University of California Press.
* (10) Becker, H. (1967). Whose side are we on? Social Problems, 14, 239–247
* (11) Michael Burawoy, M. (2005). For public sociology. British Journal of Sociology, 56, 259–294.
* (12) https://www.cnn.com/2020/05/31/politics/biden-maintains-strong-position/index.html
* (13) https://www.cnn.com/videos/politics/2019/03/05/joe-biden-tough-on-crime-speech.cnn
* (14) نتائج الانتخابات في نوفمبر ٢٠١٦ تؤكد مسار التحول نحو اليمين الذي بدأ منذ عقود. فكما تشير البيانات المتوفرة، حدث الانزياح يميناً في ٤٢ ولاية من أصل خمسين، وليس في الولايات المتأرجحة السبع فقط. هذا عدا عن أن هذا الميول إلى الانزياح يميناً ليس وليد عام ٢٠١٦ فقط. فمنذ عام ٢٠١٠، مثلاً، خسر الحزب الديمقراطي (الليبرالي) تدريجياً أكثر من ٩٠٠ مقعد في المجالس التشريعية المحلية للولايات (من أصل حوالى ٧٣٠٠) لصالح الجمهوريين (الجمهوريون يسيطرون على ٤١٦٤ فيما الديمقراطيون يسيطرون على ٣١٨٠ مقعداً). وهذه الخسارة هي في الجوهر استمرار لما عُرف بـ "ثورة الجمهوريين" في انتخابات ١٩٩٤، والتي سيطر فيها الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ وغالبية حكام الولايات والمجالس التشريعية للولايات للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. لكن ظاهرة الانزياح يميناً في السياسة والاقتصاد والأيديولوجيا في المجتمع الأميركي ليست مقتصرة حقيقة على هيمنة الحزب الجمهوري انتخابياً فقط. فمنذ عهد الجمهوري ريغان، حاول الديمقراطيون أيضاً المنافسة بالتحول نحو الوسط، عبر ما عُرف حينها بـ "الطريق الثالث" أو "الديمقراطيين الجدد"، الذين قادهم كلينتون لاحقاً نحو اليمين ليضمن فوزه في انتخابات ١٩٩٦ بعد "المجزرة" الانتخابية التي عاناها حزبه في الانتخابات النصفية في عام ١٩٩٤.
* (15) G. M. Fredrickson, “White Supremacy: A Comparative Study in American and South African History”. (Oxford: Oxford University Press, 1981), p. 3 - 4
* (16) Theodore Allen. 1997. “The Invention of the White Race: The Origin of Racial Oppression in Anglo America”.” V2. NY: Verso.
* (17) https://foreignpolicy.com/2009/11/11/the-eagle-has-crash-landed/
:::::
"الأخبار"
أحمد حسن
«لم تولد العبودية من العنصرية. على العكس، العبودية هي التي استولدت العنصرية»
إريك ويليامز «الرأسمالية والعبودية»
جرياً على عادة أسلافه من الأباطرة، اتخذ «رومولوس أوغسطس»، الإمبراطور الأخير للإمبراطورية الرومانية الغربية (حكم من 460-476)، لنفسه لقب «أوغسطس». لكن الناس، والتاريخ، سيطلقون عليه استهزاء «موميلوس (العار أو الفضيحة) أوغسطولوس (الصغير)». كانت هذه إشارة، وحتى حكماً على دور ومسؤولية رومولوس أوغسطس عن سقوط الإمبراطورية. لكن «الإمبراطورية هي التي صنعت الأباطرة، وليس العكس»، تخبرنا المؤرّخة ماري بيرد في دراستها «مجلس الشيوخ والشعب الروماني: تاريخ روما القديم»* (1).
وفي الولايات المتحدة المشتعلة الآن بالاحتجاجات، ليست القضية، ولم تكن أبداً، في عنصرية ترامب، أو أي رئيس قبله أو بعده، برغم وقاحته، وحتى فاشيته، إن أردتم* (2). فيمكن للأقليات، وبحق، أن يلوموه على الكثير (حتى على الطقس السيّئ)، لكنه لم يخترع العنصرية، وليس سبب مأسستها وقوننتها، ولم يخترع همجية الشرطة ولا قتل الأقليات. هو ورثها فقط، ويستغلها انتخابياً متى ظن أن ذلك ممكن. فالعنف المستمر ضد الأقليات هو حاجة دائمة ومستمرة وبنيوية للنظام القائم على إخضاعهم، ولا يمكنه إخضاعهم والاستمرار بالعمل والربح من دون العنف. ومن يعرف كيف تمّت كتابة الدستور الأميركي، ومن كتبه، وظروف كتابته، وحتى المساومات الموثقة التي جرت بخصوص «تجارة العبيد» تحديداً، سيعرف أن جذور القضية ضاربة في التاريخ الأميركي وبنية مؤسساته وقوانينه، حتى قبل حتى تأسيس الجمهورية بقرون* (3). ومن قرأ ما كتبه الرئيس الأسود الأوّل* (4)، أوباما، وسمع ما قاله لاحقاً* (5) في الأيام الأولى للانتفاضة، سيعرف حقاً حدود وإمكانية مسار الحراك الراهن (وهو برأيي يمثّل قاعدة مهمة من الطبقة الوسطى السوداء التي ستدافع عن النظام حتى اللحظة الأخيرة، ولها مصلحة في النظام القائم، وحتى في العنصرية ضد أبناء جلدتها). وأوباما سيدخل التاريخ، كالرئيس الذي أضرّ بالأقليات أكثر من غيره، سواء عبر الأوهام التي انتشرت في أعقاب انتخابه عن دخول أميركا مرحلة «ما بعد الأعراق» والعنصرية، أو سياساته بخصوص العلاقات العرقية وعنف الشرطة، حتى لا نتحدث عن القتل بالطائرات بدون طيار في دول الجنوب – كان الحل الذي اجترحه أوباما، مثلاً، أثناء رئاسته، لاعتداء شرطي أبيض على أستاذ أسود معروف من جامعة هارفرد هو دعوة الاثنين لشرب كأس من البيرة معه في البيت الأبيض (عُرفت لاحقاً بـ«قمّة البيرة»).
يبدو من الأكيد أن ما يجري الآن من احتجاجات لن يقود إلى «إعادة بناء الجمهورية»، التي فشلت حتى بعد حرب أهلية طاحنة (انتصر فيها سياسياً من هُزِم عسكرياً)، أو أنها ربما لن تغيّر كثيراً حتى في موازين القوى في الانتخابات بعد أشهر. فالإمبراطورية عاجزة بنيوياً عن حل المشكلة العنصرية، وفي الحقيقة هي لن تكون أميركا، ولا حتى إمبراطورية، إن فعلت ذلك (إلا إذا كنا نظن أن تمويل طريقة حياة الغرب تتم فعلاً من عائدات السياحة والتجارة والدبلوماسية، ولا دور للعنصرية في ذلك). فالعنصرية، والتمييز ضد المرأة أيضاً، مربحان تماماً لرأس المال وهما بعض آليات تراكمه. فمعدل القيمة الفائضة يرتفع بالضرورة مع ارتفاع نسبة الاضطهاد، لما له من أثر على تخفيض الأجور وزيادة القوة الشرائية للشرائح المتوسطة والغنية، تماماً كما يرتفع أيضاً معدّل القيمة الفائضة مع العولمة النيوليبرالية في حالة دول المركز الرأسمالي (ما يسمّيه إيمانويل والرشتين «التوتر الأيديولوجي للرأسمالية»)* (6). رغم كل ذلك، فإن ما يجري على الأرض الآن لن يكون بلا تبعات، ويمكن اعتبار ما يجري الآن أحد المخاضات المتزايدة لمسار الأفول الذي دخلته الإمبراطورية منذ سنين* (7)، ومؤشراته البنيوية (اقتصادياً، سياسياً، حال البنية التحتية، إلخ) تحظى بإجماع الخبراء منذ سنين. ربما يكون هذا هو المهم في كل ما يجري الآن بسبب تبعاته البعيدة المدى خارج أميركا أيضاً.
لهذا، ففي الوقت الذي يمكن أن ترتفع فيه الآمال بتخفيف العنصرية لدى البعض نتيجة ما يحدث، فإن النتيجة قد تكون العكس تماماً، طالما لم تهتز مكانة الإمبراطورية وصورتها وأدواتها الناعمة كثيراً، وهو ما ليس بمقدور الحراك بشكله الحالي فعله. ففي غياب البديل الأيديولوجي مطلقاً، وفي ظل الهيمنة الأيديولوجية للرأسمالية المتوحّشة، حتى في صفوف غالبية المحتجين الذين ينظر بعضهم إلى القضية فقط من زاويتها الأخلاقية (بلا تغييرات بنيوية)، وفي ظل توفر قدرة هائلة لدى «أجهزة الدولة القمعية»، كما يسميها لوي التوسير، لقمع الانتفاضة وتدمير الأيديولوجية المناهضة للعنصرية، وسحق طرق تنظيم المعارضة، ربما سيجد رأس المال فرصة أخرى لإعادة إنتاج العنصرية وستكون النتيجة في المدى البعيد (بمعنى الزمن الاجتماعي وليس الوقتي) عكس ما يريد المحتجّون تماماً. هذا متوقّع أساساً بسبب القوة الأيديولوجية الهائلة للمنظومة الليبرالية القائمة – أوباما، مثلاً، في أقل من جملتين في كلمته أعاد إنتاج شخصيتي مالكولم إكس، الذي تبنى نظرية الاستعمار الداخلي وحتى طالب بالانفصال في البداية، ومارتن لوثر كنغ، الذي أدرك في آخر أيامه على الأقل علاقة الرأسمالية بالعنصرية، ليظهرا كأنهما كانا مؤمنين بالمنظومة العنصرية ولا يريدان سوى إصلاحها فقط* (
أدوات الإمبراطورية الأيديولوجية
حين تقرأ عبارة عالم الاجتماع الفرنسي آلان تورين: «إن جوهر علم الاجتماع هو مقاومة كل أشكال السلطة»* (9)، أو عبارة عالم الاجتماع الأميركي هوارد بيكر الشهيرة: «في صَفِّ مَنْ تَقِفْ؟»، التي توحي بأن الاختصاصيين في هذا الحقل المعرفي يقفون دوماً وأبداً مع المضطهدين* (10)، وغيرها الكثير، فربما ستنطلي عليك فعلاً أسطورة الدور والوظيفة التحرّرية لعلم الاجتماع الغربي، ووعده المزور باسم «ملاك التاريخ لإنقاذ وعد التقدّم»، كما ادعى رئيس جمعية علم الاجتماع الأميركي مايكل برواي، في اجتماع الجمعية العامة في 2004* (11). هذه العبارات الطنانة تُخفي من السجل التاريخي لعلم الاجتماع الغربي نظريّات مُؤَسِسة لهذا الحقل المعرفي سادت لفترة طويلة، مثل «الداروينية الاجتماعية» و«التطورية الثقافية»، وحتى «علم تحسين النسل»، وتخفي الدور الأساسي لعلماء اجتماع أميركيين مؤسسين للحقل في صياغتها وتسويقها من وليام سومنر وليستر وارد إلى إدوارد روس، كما تخفي من هذا السجل الاستثناء المنهجي والمتعمّد لـ«زنادقة» علم الاجتماع، أو ما أصبح يسمى بـ«علم الاجتماع الأسود»، فقط لتجرّئهم على التفكير بطريقة مختلفة جوهرها التنظير للعلاقة العضوية بين الرأسمالية والعنصرية، مثل ويليام دوبويس وأوليفر كوكس. هذه النظريات، المحسوبة على التيار العام لم تؤسس حقاً لأي فهم تحرري أو علمي في أي من قضايا العرق والإثنية والقومية والجندر. بل، على العكس. فلقد ساهمت لاحقاً في إنتاج المزيد من طبقات التشويش المعرفي التي ساعدت، ولا تزال، على تعزيز وحتى تبرير الممارسات التمييزية العنصرية المستمرة ضد الأميركيين من أصل أفريقي، وكل ما يقع تحت ما يسمّى فئة «الأجناس الأدنى».
وهذا ليس خللاً معرفياً، أو حتى خطأ أو جهلاً مرحلياً تم تجاوزه لاحقاً. فعلم الاجتماع الغربي، كـ«حقل معرفي»، كما يعرف من يعرف جيّداً، هو في الحقيقة أحد حرّاس القلعة وإحدى أدوات صناعة الأيديولوجيا، كغيره من العلوم الاجتماعية والإنسانية التي حوّلت الجامعات ودورها الأيديولوجي إلى جيش تفوق أهميته أحياناً وفعلاً الجيوش التقليدية. وليست القضية فقط هنا أننا نادراً ما نرى إضاءة، ولو بالحد الأدنى، على أهمية ودور العنصرية في صنع وتشكيل الحداثة الرأسمالية الغربية فقط وتشكيل النظام الرأسمالي العالمي – في الحقيقة لا توفّر الأدوات التحليلية ولا المفردات اللغوية التقليدية لعلم الاجتماع الأميركي السائد إمكانية كبيرة لكشف العلاقة التاريخية والعضوية بين الرأسمالية والصراعات الطبقية والعنصرية، وخصوصاً أن الحُكم الرأسمالي، كما سنرى، تَعَزَّزَ جداً من خلال عملية «التفاضل العرقي» والترتيب الهرمي للبروليتاريا في العالم، أو ما يسميه إيمانويل والرشتين «عرقنة العمل»، التي أسس لها أصلاً بعض علماء الاجتماع وعلم الإنسان. فمن استعمار فرجينيا في القرن السابع عشر إلى بريطانيا الفيكتورية وما بعدها، كانت العنصرية سلاحاً مهمّاً وأساسياً ولا غنى عنه في ترسانة نُخَب الدول الرأسمالية والاستعمارية، واستخدمت بفعّالية كبيرة لاحتواء الصراعات الطبقية وتشتيت الطبقة العاملة بهدف جعل النظام أكثر أمناً وحتى أكثر فعّالية لتراكم رأس المال.
قصّة الرأسمالية السائدة في الغرب عموماً، وفي الولايات المتحدة تحديداً، مزوّرة لحد كبير باستثنائها الدور البنيوي للعنصرية. هذا التزوير، طبعاً لم ينته، ويستمر إلى الآن في حقول معرفية عديدة، حتى بعض تلك الحديثة منها، والتي يعتقد البعض أيضاً أن لها دوراً تحررياً أيضاً، كنظريات «ما بعد الاستعمار»، مثلاً، التي تميل إلى التنظير عن المواجهة الحضارية بين الغرب (كلّه) ومستعمراته السابقة (كلّها) فتساهم في إخفاء تعددية العنصرية، بما في ذلك عرقنة واضطهاد أجزاء من البروليتاريا الأوروبية (الجنوب في الشمال، أو الشرق في الغرب، إن أردتم). هذا الفهم مهم في هذه الحالة، فرؤية وإدراك الدور البنيوي للعنصرية والطرق المتباينة والمختلفة التي تم بها دمج البروليتاريا في علاقات الهيمنة الرأسمالية ستكون لهما آثار مهمة وحاسمة على أي سياسة تحررية. فتجاهل الدور الكبير للعنصرية ماضياً وحاضراً (مثل الدعاية الليبرالية الخبيثة عن «سياسة عرقية عمياء») سيُبقي الظلم الناتج عن العنصرية التاريخية والمعاصرة، وسيعيد إنتاج وظيفته في تراكم رأس المال. حتى الآن، لم نسمع عن أي نهج (أو حتى شعار) بديل للأسف يشدد وبوضوح لا لبس فيه على ترابط مطالب العدالة الاقتصادية بمكافحة العنصرية. هكذا فقط يتم إزالة أي غموض عن الاختلافات المتأصّلة في الجسم الجماعي للبروليتاريا والفقراء والأقليات من قبل الرأسمالية.
لكن مشكلة الأقليات (والحراك) في الولايات المتحدة ليست علم الاجتماع فقط، وليست حتى أجهزة الشرطة ولا عنصريتها (سواء كانت مؤسسة أم أفراداً) أيضاً – في الحقيقة ربما تكون أجهزة الدولة القمعية، من الشرطة إلى الحرس الوطني، وحتى المنظمات اليمينية المسلحة، هي الأقل خطورة في المواجهة الدائرة الآن، كون دورها القمعي وانحيازاتها مكشوفة وواضحة. فالأقليات، والسود منهم تحديداً، يواجهون كل المنظومة الليبرالية الهائلة، وكل أدواتها الناعمة وعدتها من الديمقراطية الليبرالية إلى هوليوود، ومن فلاسفة اللاعنف إلى وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث والجامعات، التي هيمنت على رواية الانتفاضة منذ البداية (وخدمها أوباما وأمثاله من طواويس الأقليات وأبناء النظام أكثر من غيرهم ربما)، وبدأت بإعادة توجيهها بطريقة سيحسدها عليها جداً جماعة «المجتمع المدني» في بلادنا (رغم أن نجاحهم للحق، نسبة إلى حجم الدعم الخارجي ورخص ثمنهم، كان لافتاً). فكل تلك البنية التحتية المؤسسية الهائلة لإنتاج الأيديولوجيا كانت في المعركة حتى قبل أن تبدأ، وترى أنه بإلقاء اللوم على ترامب وسياساته وأسلوبه فقط ليس وسيلة لتبرئة نفسها وغسل دورها التاريخي الفاعل جداً في الاضطهاد، بل فرصة (ليس لإنقاذ النظام، فلا خطر عليه حقاً) لاستخدام الحراك في الصراع بين النخب، وإعادة إنتاج ذات النظام العنصري بشكل أكثر كفاءة، وربما (ربما) أيضاً التخلّص من ترامب. أحد آخر استطلاعات الرأي الذي أجرته «أي بي سي» و«واشنطن بوست» يظهر تفوّق بايدن على ترامب (53٪ - 43٪) بين المنتخبين المسجلين، وهو ما يضع بايدن (في هذا الوقت قبل الانتخابات، وبهذه النسبة الآن) في أفضل موقع لمرشح رئاسي يواجه الرئيس منذ عام 1930، حسب «سي أن أن»* (12). لكن، هل يملك بايدن الإجابة على أسئلة ومطالب المحتجين؟ أحد خطابات بايدن (ذي التاريخ العنصري الموثّق) في مجلس الشيوخ من عام 1993 يؤكد أنه يمكن أن يكون أكثر فظاظة حتى من ترامب* (13)، وهذا كان في الوقت نفسه الذي أطلقت فيه هيلاري كلينتون وصفها الشهير «المفترسين الفائقين» على الأطفال السود في سعيها لتمرير «قانون الجريمة» الذي تبنته إدارة زوجها وكانت الأقليات ضحاياه الأولى. لكنهم لا يرون أي وقاحة في طلبهم الصوت الأسود في الانتخابات دائماً بتحذير الأقليات أن البديل هو أمثال ترامب وباري غولدووتر* (14).
هكذا اخترعت بريطانيا العِرق الأبيض
في أيّار عام 1607، «كانت ثلاثُ سفنٍ صغيرة تُبْحر عبر خليج تشيسابيك، بين ميريلاند وفيرجينيا، باتجاه نهر جايمس، بحثاً عن مكانٍ لإقامة المستوطِنة الإنكليزيّة الأولى الدائمة في أميركا الشماليّة». لم يكن خيارُ شبهِ الجزيرة تلك، المعروفةِ اليوم باسم جايمس تاون، مثالياً على الإطلاق، لكونها منخفضةً ومليئةً بالمستنقعات. لكنّ هذا السبب بالضبط (أيْ لكونها شبهَ جزيرة) هو الذي جعلها الخيارَ الأفضلَ للمستوطنين من الناحية الدفاعيّة في مواجهة أيّ «اعتداءاتٍ» محتملةٍ من السكّان الأصليين* (15). وفي هذا الخيار، كان المستوطنون الإنكليز يؤكّدون حقيقتين مهمّتين: الأولى، أنّ هذه البلاد ليست خاليةً من السكّان، وهو ما يفسِّر إعطاءهم الهمَّ الأمنيَّ أولويّةً قصوى في تحديد المكان. والثانية، أنّ جايمس تاون ليست مجرّدَ جسرٍ بحريّ آخر أقامته القوى الاستعماريّةُ في مناطق مختلفة من العالم ليكونَ قاعدةً متقدّمةً للحراسة، أو لحمايةِ الطرق التجاريّة، بل هي مشروعٌ استعماريّ من نوعٍ جديد، سيؤدّي إلى تأسيس الإمبراطوريّة الأميركيّة. فخلال أقل من ثلاثين عاماً على تلك الحادثة، تم تأسيس أربع مستوطنات إنكليزية أخرى: جزر سومرز (برمودا) عام 1612، مستعمرة بليموث (في ولاية ماساتشوستس) عام 1620، باربادوس (شرق الكاريبي) عام 1627، وميريلاند في عام 1634.
لكن واجه المستعمِرون الأوروبيون، بلا استثناء، معضلة مزدوجة، يقول ثيودور ألين، في المجلد الثاني من «اختراع العرق الأبيض»* (16)، هدّدت إمكانية نجاح المشروع الاستعماري برمّته: «كيفية تأمين إمدادات كافية من العمالة»، وأيضاً، وربما حتى أكثر أهمية في حالة إنكلترا تحديداً، «كيفية تأسيس واستدامة درجة معيّنة من السيطرة الاجتماعية اللازمة لضمان التوسع السريع والمستمر لرأس المال من خلال استكشاف هذا العمل». لكن في كل من هذه القضايا، اختلفت الحالة الإنكليزية بطرق كان لها تأثير حاسم على أصل وشكل «مؤسسة العبودية» أوّلاً، والقمع العنصري الأبيض لاحقاً، تحديداً في القارة الأميركية الشمالية.
ففيما واجهت كل الدول الاستعمارية معضلة توفير «العمالة الكافية» في المستعمرات حينها، لأسباب سياسية، اقتصادية، ديموغرافية (انتشار الطاعون 1596-1602 الذي قضى على أكثر من 10% من سكان إسبانيا،) وعسكرية (جزء مهم من الجيش الإسباني كان من المرتزقة، وكان عليهم بالإضافة إلى المشروع الاستعماري محاربة الدولة العثمانية ومنافسة الدول الأوروبية الأخرى، فيما اضطرت البرتغال بـ 1,4 مليون مواطن فقط للتنازل مؤقتاً عن البرازيل إلى هولندا لانشغالها في صراعات متعددة)، كانت بريطانيا وحدها تشهد فائضاً سكانياً كبيراً نتيجة ثلاثة عوامل على الأقل: تطور اقتصاد صناعة الملابس والصوف (وبالتالي تطور صناعة الرعي وتربية الماشية) المربح حينها، على حساب الزراعة ما دفع الكثير من الفلاحين إلى الفقر والبطالة، وزيادة عدد السكان بسبب بُعد الجزيرة عن الأمراض التي ضربت الدول الأخرى، وعودة عشرات آلاف الجنود من الخارج في عام 1546 في فترة هنري الثامن. وعدا عن كون الهجرة طريقة للتخلّص من الفائض السكاني وحل مشكلة البطالة، كانت بريطانيا الدولة الوحيدة القادرة على إرسال يد عاملة بيضاء إلى المستعمرات، لدرجة أن البحث عن الفلاحين العاطلين عن العمل والفقراء والمجرمين وإغراءهم للهجرة ثم نقلهم إلى المستعمرات أصبحت صناعة مربحة مسؤولة حينها عن نمو مدن كليفربول ومانشستر التي كانت مراكز للهجرة. لكن اليد العاملة البريطانية لم تكن تكفي حتى للعمل في المستعمرات البريطانية لوحدها، فيما كان السكان الأصليون الذين تم استعبادهم وإجبارهم على العمل يتعرّضون للإبادة بسبب ظروف العمل والأمراض (تراجع عدد سكان المكسيك إلى ما يقارب الـ 14 مليوناً عام 1492، عام وصول كولومبوس، إلى مليون ومئة ألف فقط عام 1605، فيما تمّت إبادة سكان هايتي كلياً). كان الحل الذي اقترحه القسيس (والمؤرخ) برتولومي دي لا كاسس، ووافق عليه ملك إسبانيا في عام 1517 هو استقدام يد عاملة من أفريقيا. وفي عام 1517، أصدر الملك الإذن بتصدير 15 ألف مستعبد أفريقي إلى سان دومينغو. وهكذا «أطلق الكاهن والملك على العالم العبودية وتجارة العبيد الأميركية»، كما كتب سي. ل. ر. جايمس في «اليعاقبة السود».
لكن صناعة «تجارة العبيد» المربحة جداً حينها، بالإضافة إلى الفائض الهائل للقيمة الذي أنتجته اليد العاملة الأفريقية المستعبدة في المستعمرات، لم يؤسسا للنظام الرأسمالي العالمي الذي نعيش فيه فقط ولم يجعلا من العنصرية عاملاً بنيوياً ومؤسساً للرأسمالية، بل وجعل من بريطانيا اللاعب الأهم فيه. فبريطانيا لم تكتف بتجارة العبيد واستخدامهم في زراعة وحصاد محاصيل السكر، التبغ، القطن، وغيرها في المستعمرات، بل وحتى كانت توفّر وتبيع المستعبدين لمنافسيها الأوروبيين لاحقاً. لكن الدور البريطاني ربما الأهم، كان في الدور الكبير المتمثل بسياسات ومؤسسات الإخضاع والسيطرة الاجتماعية التي كانت تمتلك من الخبرة فيها بسبب تاريخ طويل من قمع تمردات العمال والفلاحين والفقراء أكثر من أي دولة استعمارية أخرى.
العامل الحاسم الذي ميّز بريطانيا عن غيرها من الدول الاستعمارية، وجود طبقة عاملة بيضاء من أصل إنكليزي في المستعمرة البريطانية في أميركا يمكن لها أن تتمرّد مع حليفها الأفريقي المستعبد والحر، كما حصل في ثورة ناثانيال بيكون في عام 1675 (رغم أنها كانت موجهة في البداية ضد السكان الأصليين، إلا أنها تطورت لاحقاً ضد الحاكم البريطاني، وانتهت بإحراق جايمس تاون). الرد الإنكليزي نتيجة للرعب الذي أصاب كبار الملاك البيض من احتمال تحالف العامل الأفريقي والأوروبي والثورة على النظام، كان بسلسلة من القوانين أصدرها مجلس ولاية فرجينيا على مدى أكثر من نصف قرن جعلت من سواد البشرة تدريجياً دلالة على الدونية (من خلال مراقبة السود المستعبدين والأحرار على حد سواء وقمعهم واستعبادهم جميعاً لاحقاً) وفي الوقت نفسه جعلت بياض البشرة مقياساً للتفوّق من خلال سلسلة من الامتيازات لم يكن أقلها قانون تحرير كل عمّال السخرة البيض. هكذا صُمّمت فكرة العرق الأبيض لخلق طبقة عازلة من العمّال البيض، بين كبار الملاك والمستعبدين وعمّال السخرة، وتحوّلت تدريجياً مع مأسستها إلى الأيديولوجيا السائدة وحتى الرسمية.
خاتمة: باكس أمريكانا؟
لكن مأسسة العنصرية وقوننتها تصاعدتا أكثر منذ كتابة الدستور الأميركي الذي بنيت على أساسه كل القوانين والمؤسسات اللاحقة (القسم التاسع من المادة الأولى، مثلاً، لم يُشَرِّعْ تجارة العبيد فقط، بل وحتى حظرّت على الحكومة الفيدرالية إلغاءها قبل عام 1808 وفقط بتفويض من الكونغرس، فيما المادة الرابعة، القسم الرابع، يفرض على الحكومة الفيدرالية المساهمة مع الولايات في قمع أي انتفاضات محتملة للمستعبدين). وحتى حين تمّت تجربة عكس بعض قرارات المحكمة العليا بعد سنين مثلاً، يكون ما تم التأسيس له بعد سنين واقعاً يصعب، وأحياناً يستحيل، تجاوزه، وهو ما يفسّر لماذا يتزايد الفصل العرقي في السكن في بعض المناطق الآن أكثر من السابق (كما حصل في قرار براون ضد مجلس التعليم في عام 1954 الذي عكس قرار بليسي ضد فيرغسون الذي شرع الفصل العنصري في عام 1896).
مشكلة الحراك الأميركي الأساسية أن الهيمنة الأيديولوجية للمنظومة الليبرالية تنجح تدريجياً في وضع الناس أمام خيار ترامب أو بايدن. ومن يعرف قليلاً من تاريخ بايدن في مجلس الشيوخ، ودوره في تمرير قوانين عنصرية تمسّ بحياة الأقليات يومياً، سيتأكد من دقة حكم الصحافي كريس هيدجيز أن «ترامب ورث النظام، أما بايدن فقد بناه».
لكن يبقى أن الحراك مؤشر ضعف بنيوي للإمبراطورية وسيعجّل من الأفول، وخصوصاً بسبب العجر البنيوي للنظام عن حل مشكلة العنصرية، بغضّ النظر عن نتائجه المباشرة والقصيرة المدى. ما يجري اليوم في الولايات المتحدة وتعاطي أجهزة الدولة معه يكشفان لنا، ولو جزئياً، جواب السؤال الذي طرحه مرة إيمانويل والرشتين: «انتهى باكس أمريكانا. كشفت التحديات من فييتنام والبلقان إلى الشرق الأوسط و11 سبتمبر عن حدود التفوّق الأميركي. هل ستتعلّم الولايات المتحدة كيف تتأقلم مع الأفول بهدوء، أم أن المحافظين الأميركيين سيقاومون ذلك، وبالتالي سيحوّلون التدهور التدريجي إلى سقوط سريع وخطير؟»* (17).
هوامش:
* (1) Mary Beard. 2015. “SPQR: A History of Ancient Rome”. NY: Liveright. P: 257
* (2) انظر: أميركا والقابلية للفاشية: تشريح مختصر للترامبية
https://www.almayadeen.net/butterfly-effect/679803
* (3) http://www.al-safsaf.com
* (4) https://medium.com/@BarackObama/how-to-make-this-moment-the-turning-point-for-real-change-9fa209806067
* (5) https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/live-george-floyd-protests-today.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage#link-2f9c7b40
* (6) Immanuel Wallerstein. 1996. The Ideological Tensions of Capitalism: Universalism Versus Racism and Sexism. In Balibar, Etiene and Immanuel Wallerstein. Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. Pp 29-36.
* (7) Immanuel Wallerstein. “The Eagle has Crash Landed”. Foreign Policy. November 11, 2009.
https://foreignpolicy.com/2009/11/11/the-eagle-has-crash-landed/
* (
* (9) A. Touraine. (2007). "Public sociology and the end of society". In Public sociology (pp. 67–78).
Berkeley: University of California Press.
* (10) Becker, H. (1967). Whose side are we on? Social Problems, 14, 239–247
* (11) Michael Burawoy, M. (2005). For public sociology. British Journal of Sociology, 56, 259–294.
* (12) https://www.cnn.com/2020/05/31/politics/biden-maintains-strong-position/index.html
* (13) https://www.cnn.com/videos/politics/2019/03/05/joe-biden-tough-on-crime-speech.cnn
* (14) نتائج الانتخابات في نوفمبر ٢٠١٦ تؤكد مسار التحول نحو اليمين الذي بدأ منذ عقود. فكما تشير البيانات المتوفرة، حدث الانزياح يميناً في ٤٢ ولاية من أصل خمسين، وليس في الولايات المتأرجحة السبع فقط. هذا عدا عن أن هذا الميول إلى الانزياح يميناً ليس وليد عام ٢٠١٦ فقط. فمنذ عام ٢٠١٠، مثلاً، خسر الحزب الديمقراطي (الليبرالي) تدريجياً أكثر من ٩٠٠ مقعد في المجالس التشريعية المحلية للولايات (من أصل حوالى ٧٣٠٠) لصالح الجمهوريين (الجمهوريون يسيطرون على ٤١٦٤ فيما الديمقراطيون يسيطرون على ٣١٨٠ مقعداً). وهذه الخسارة هي في الجوهر استمرار لما عُرف بـ "ثورة الجمهوريين" في انتخابات ١٩٩٤، والتي سيطر فيها الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ وغالبية حكام الولايات والمجالس التشريعية للولايات للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. لكن ظاهرة الانزياح يميناً في السياسة والاقتصاد والأيديولوجيا في المجتمع الأميركي ليست مقتصرة حقيقة على هيمنة الحزب الجمهوري انتخابياً فقط. فمنذ عهد الجمهوري ريغان، حاول الديمقراطيون أيضاً المنافسة بالتحول نحو الوسط، عبر ما عُرف حينها بـ "الطريق الثالث" أو "الديمقراطيين الجدد"، الذين قادهم كلينتون لاحقاً نحو اليمين ليضمن فوزه في انتخابات ١٩٩٦ بعد "المجزرة" الانتخابية التي عاناها حزبه في الانتخابات النصفية في عام ١٩٩٤.
* (15) G. M. Fredrickson, “White Supremacy: A Comparative Study in American and South African History”. (Oxford: Oxford University Press, 1981), p. 3 - 4
* (16) Theodore Allen. 1997. “The Invention of the White Race: The Origin of Racial Oppression in Anglo America”.” V2. NY: Verso.
* (17) https://foreignpolicy.com/2009/11/11/the-eagle-has-crash-landed/
:::::
"الأخبار"
 Hitskin.com
Hitskin.com