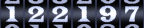هل أضحى الجيش المشتَرَك الوحيد بين اللبنانيين؟
عصام نعمان*
عندما يتنازع اللبنانيون ــ وكثيراً ما يفعلون ــ لا يبقى أحد أو شيء، لبنانياً إلاّ الجيش والعملة. إذ يعود كل واحدٍ إلى طائفته ومذهبه وعشيرته، فالجيش يضمّ مجنّدين من كل المناطق والطوائف والطبقات والمدن والبلدات والقرى والأحياء. والعملة أداة معتمدة للبيع والشراء والإقراض والادخار، يتداولها أفراد وهيئات من كل الأماكن والجماعات سالفة الذكر.
حتى العملة لم تبقَ هذه الايام مشتَرَكاً لبنانياً. ذلك أن الدولار الأمريكي ينافسها بقوة، كأداة مداولة للقيمة بين الناس.. لماذا؟ لأن قلّة من اللبنانيين تحظى بمقادير وازنة من كِلا العملتين. هكذا يبقى الجيش المشتَرَك الوحيد الصامد.
ما حملني على كشف هذه الخواطر ما شاهدته، بألم وحسرة، من منازعات وصدامات بين فريقين، أو أكثر من المشاركين في التظاهرات التي اجتاحت وسط بيروت بعد ظهر يوم السبت الماضي.
الدعوة إلى التظاهر جاءت من جانب أحزاب ومجموعات يغلب على معظمها طابع المعارضة للحكم والحكومة، فيما يغلب، في المقابل، على معارضي هؤلاء طابع دعم الحكومة وبرنامجها، ولاسيما أحزاب التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله. تسربت معلومات بأن حزب الكتائب و»حزب سبعة» وغيرهما من المجموعات المعارضة للحكومة وداعميها، تنوي التظاهر ورفع شعارات مناهضة لسلاح المقاومة، أي لحزب الله، المتهم، بمبالغة لافتة، بأنه أضحى صاحب القرار السياسي في البلاد. سارع مسؤولو حزب الكتائب وغيره من مشاركيه في الدعوة إلى التظاهرة، لنفي تهمة مناهضة سلاح المقاومة، والتأكيد على أن مطالبهم الرئيسة هي المعيشة بكرامة، وإسقاط الحكومة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة حتى لو اقتضى الأمر بقانون الانتخابات الحالي.
عندما يتنازع اللبنانيون ــ وكثيراً ما يفعلون ــ لا يبقى أحد أو شيء، لبنانياً إلاّ الجيش والعملة
يبدو أن أنصار سلاح المقاومة وحلفاءهم لم يصدقوا ما أدلى به الجانب الآخر، فاحتشدوا في مكان مقابل لساحة الشهداء، حيث احتشد معارضوهم. ثمة مقولة رائجة أن لا حزب الله ولا حركة أمل ولا داعمي حكومة حسان دياب هم من شجعوا جماعة الشبان بالاحتشاد مقابل متظاهري ساحة الشهداء، بل هي جهة ثالثة لها مصلحة في تصادم الفريقين وإضعافهما معاً. أيّاً ما كان الدافع إلى النزاعات والصدامات والجهة المستفيدة منها، فإن حصيلة اليوم الحزين يمكن تلخيصها بحقائق ثلاث:
*أولاها، أن كِلا الفريقين المتنازعين خسرا سياسياً في تلك المواجهة البائسة.
*ثانيتها، إن الطائفية ما زالت الوسيلة السحرية للإيقاع بين اللبنانيين.
*ثالثتها، إن الجيش اللبناني هو المرجع المشتَرَك الوحيد المقبول من الأفرقاء المتنازعين والمتصادمين، وإنه وحده قادر على الفصل بينهم، أو منعهم من التمادي في التنازع والتصادم.
إلى أين من هنا؟ ليس للجيش مواقف متمايزة حيال القضايا والتحديات التي تواجه لبنان، حكومة وشعباً، في هذه الآونة. فهو، بحكم الدستور وتركيبة النظام السياسي، جزء من الدولة الخاضعة بدورها لأحكام الدستور، والمفترض أن ترعاها وتديرها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لكن الجيش اللبناني يجد نفسه في هذه الآونة عرضةً للتجاذب بين عدّة قوى سياسية متواجدة، أو متداخلة، بالسلطات الدستورية سالفة الذكر، كما عرضة للتصادم أو التواؤم مع بعض الأطراف الشعبية، التي يزخر بها مجتمع لبنان التعددي.
إلى ذلك، تواجه البلاد تحدّيات عدّة، لعل أكثرها خطراً وحدّة اثنان: مناهضة الولايات المتحدة (ومن ورائها «إسرائيل») لسلاح المقاومة (أي لحزب الله وحلفائه) من جهة، ومن جهة أخرى اعتزام إدارة ترامب تنفيذ «قانون قيصر» القاضي بمحاصرة سوريا، ومعاقبة كل من يدعمها ويتعاون معها سياسياً واقتصادياً، مباشرةً أو مداورةً. التكتلات السياسية اللبنانية مختلفة في مواقفها من هذين التحديين، كما هي مختلفة ومتنازعة حيال قضايا أخرى داخلية، كالفساد ومحاكمة الفاسدين، واستعادة الأموال المنهوبة، والاستعاضة عن الاقتصاد الريعي باقتصاد منتج، وقضايا أخرى ساخنة. ربما تستطيع قيادة الجيش أن تنأى بنفسها عن هذه التحديات والقضايا بدعوى أنها معنية، بالدرجة الاولى، بالدفاع عن أمن الدولة وسلامة أراضيها، ولكن هل تستطيع أن تبقى حيادية، أو هل تتيح لها القوى الإقليمية والدولية التمسك بهذا الموقف، عندما تصل البلاد إلى استحقاقين مفتاحيين: الانتخابات النيابية في شهر أيار/ مايو 2022، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.
هل سيتمكّن القادة السياسيون من التوصل إلى حدٍّ ادنى من التوافق يتيح لهم مواجهة هذين الاستحقاقين بفعالية ونجاح وسلام؟ أم أنهم سيثابرون على التصارع، بفعل دوافع ومصالح شخصية وسياسية، أو بفعل تدخلات إقليمية ودولية؟ وهل سيتمكّنون، في حال استدامة الصراع، من أن يتفادوا «خياراً» مألوفاً في تاريخ صراعات لبنان المعاصر هو تنصيب قائد الجيش رئيساً للجمهورية؟
ألم يجر القبول باللواء فؤاد شهاب رئيساً في أعقاب اضطرابات عام 1958؟ والعماد إميل لحود في أعقاب أزمة عام 1998؟ والعماد ميشال سليمان في الدوحة (قطر) نتيجة أزمة 2006-2007؟ أم هل تراها تتمكّن القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية، من تكوين ميزان قوى جديد، يرفع إلى سدة الرئاسة قامةً وطنيةً قادرة بتفكيرها وتدبيرها، على أن تشكّل مشتَرَكاً وطنياً جامعاً بين اللبنانيين؟
سواء تكرر تنصيب قائد الجيش للمرة الرابعة رئيساً، أم لم يتكرر، فإن الجيش كان وما زال حتى إشعارٍ آخر المشتَرَك العام الوحيد الأفعل بين اللبنانيين.
* نائب سابق في البرلمان اللبناني، وزير الاتصالات السابق، محام وكاتب
عصام نعمان*
عندما يتنازع اللبنانيون ــ وكثيراً ما يفعلون ــ لا يبقى أحد أو شيء، لبنانياً إلاّ الجيش والعملة. إذ يعود كل واحدٍ إلى طائفته ومذهبه وعشيرته، فالجيش يضمّ مجنّدين من كل المناطق والطوائف والطبقات والمدن والبلدات والقرى والأحياء. والعملة أداة معتمدة للبيع والشراء والإقراض والادخار، يتداولها أفراد وهيئات من كل الأماكن والجماعات سالفة الذكر.
حتى العملة لم تبقَ هذه الايام مشتَرَكاً لبنانياً. ذلك أن الدولار الأمريكي ينافسها بقوة، كأداة مداولة للقيمة بين الناس.. لماذا؟ لأن قلّة من اللبنانيين تحظى بمقادير وازنة من كِلا العملتين. هكذا يبقى الجيش المشتَرَك الوحيد الصامد.
ما حملني على كشف هذه الخواطر ما شاهدته، بألم وحسرة، من منازعات وصدامات بين فريقين، أو أكثر من المشاركين في التظاهرات التي اجتاحت وسط بيروت بعد ظهر يوم السبت الماضي.
الدعوة إلى التظاهر جاءت من جانب أحزاب ومجموعات يغلب على معظمها طابع المعارضة للحكم والحكومة، فيما يغلب، في المقابل، على معارضي هؤلاء طابع دعم الحكومة وبرنامجها، ولاسيما أحزاب التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله. تسربت معلومات بأن حزب الكتائب و»حزب سبعة» وغيرهما من المجموعات المعارضة للحكومة وداعميها، تنوي التظاهر ورفع شعارات مناهضة لسلاح المقاومة، أي لحزب الله، المتهم، بمبالغة لافتة، بأنه أضحى صاحب القرار السياسي في البلاد. سارع مسؤولو حزب الكتائب وغيره من مشاركيه في الدعوة إلى التظاهرة، لنفي تهمة مناهضة سلاح المقاومة، والتأكيد على أن مطالبهم الرئيسة هي المعيشة بكرامة، وإسقاط الحكومة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة حتى لو اقتضى الأمر بقانون الانتخابات الحالي.
عندما يتنازع اللبنانيون ــ وكثيراً ما يفعلون ــ لا يبقى أحد أو شيء، لبنانياً إلاّ الجيش والعملة
يبدو أن أنصار سلاح المقاومة وحلفاءهم لم يصدقوا ما أدلى به الجانب الآخر، فاحتشدوا في مكان مقابل لساحة الشهداء، حيث احتشد معارضوهم. ثمة مقولة رائجة أن لا حزب الله ولا حركة أمل ولا داعمي حكومة حسان دياب هم من شجعوا جماعة الشبان بالاحتشاد مقابل متظاهري ساحة الشهداء، بل هي جهة ثالثة لها مصلحة في تصادم الفريقين وإضعافهما معاً. أيّاً ما كان الدافع إلى النزاعات والصدامات والجهة المستفيدة منها، فإن حصيلة اليوم الحزين يمكن تلخيصها بحقائق ثلاث:
*أولاها، أن كِلا الفريقين المتنازعين خسرا سياسياً في تلك المواجهة البائسة.
*ثانيتها، إن الطائفية ما زالت الوسيلة السحرية للإيقاع بين اللبنانيين.
*ثالثتها، إن الجيش اللبناني هو المرجع المشتَرَك الوحيد المقبول من الأفرقاء المتنازعين والمتصادمين، وإنه وحده قادر على الفصل بينهم، أو منعهم من التمادي في التنازع والتصادم.
إلى أين من هنا؟ ليس للجيش مواقف متمايزة حيال القضايا والتحديات التي تواجه لبنان، حكومة وشعباً، في هذه الآونة. فهو، بحكم الدستور وتركيبة النظام السياسي، جزء من الدولة الخاضعة بدورها لأحكام الدستور، والمفترض أن ترعاها وتديرها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لكن الجيش اللبناني يجد نفسه في هذه الآونة عرضةً للتجاذب بين عدّة قوى سياسية متواجدة، أو متداخلة، بالسلطات الدستورية سالفة الذكر، كما عرضة للتصادم أو التواؤم مع بعض الأطراف الشعبية، التي يزخر بها مجتمع لبنان التعددي.
إلى ذلك، تواجه البلاد تحدّيات عدّة، لعل أكثرها خطراً وحدّة اثنان: مناهضة الولايات المتحدة (ومن ورائها «إسرائيل») لسلاح المقاومة (أي لحزب الله وحلفائه) من جهة، ومن جهة أخرى اعتزام إدارة ترامب تنفيذ «قانون قيصر» القاضي بمحاصرة سوريا، ومعاقبة كل من يدعمها ويتعاون معها سياسياً واقتصادياً، مباشرةً أو مداورةً. التكتلات السياسية اللبنانية مختلفة في مواقفها من هذين التحديين، كما هي مختلفة ومتنازعة حيال قضايا أخرى داخلية، كالفساد ومحاكمة الفاسدين، واستعادة الأموال المنهوبة، والاستعاضة عن الاقتصاد الريعي باقتصاد منتج، وقضايا أخرى ساخنة. ربما تستطيع قيادة الجيش أن تنأى بنفسها عن هذه التحديات والقضايا بدعوى أنها معنية، بالدرجة الاولى، بالدفاع عن أمن الدولة وسلامة أراضيها، ولكن هل تستطيع أن تبقى حيادية، أو هل تتيح لها القوى الإقليمية والدولية التمسك بهذا الموقف، عندما تصل البلاد إلى استحقاقين مفتاحيين: الانتخابات النيابية في شهر أيار/ مايو 2022، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.
هل سيتمكّن القادة السياسيون من التوصل إلى حدٍّ ادنى من التوافق يتيح لهم مواجهة هذين الاستحقاقين بفعالية ونجاح وسلام؟ أم أنهم سيثابرون على التصارع، بفعل دوافع ومصالح شخصية وسياسية، أو بفعل تدخلات إقليمية ودولية؟ وهل سيتمكّنون، في حال استدامة الصراع، من أن يتفادوا «خياراً» مألوفاً في تاريخ صراعات لبنان المعاصر هو تنصيب قائد الجيش رئيساً للجمهورية؟
ألم يجر القبول باللواء فؤاد شهاب رئيساً في أعقاب اضطرابات عام 1958؟ والعماد إميل لحود في أعقاب أزمة عام 1998؟ والعماد ميشال سليمان في الدوحة (قطر) نتيجة أزمة 2006-2007؟ أم هل تراها تتمكّن القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية، من تكوين ميزان قوى جديد، يرفع إلى سدة الرئاسة قامةً وطنيةً قادرة بتفكيرها وتدبيرها، على أن تشكّل مشتَرَكاً وطنياً جامعاً بين اللبنانيين؟
سواء تكرر تنصيب قائد الجيش للمرة الرابعة رئيساً، أم لم يتكرر، فإن الجيش كان وما زال حتى إشعارٍ آخر المشتَرَك العام الوحيد الأفعل بين اللبنانيين.
* نائب سابق في البرلمان اللبناني، وزير الاتصالات السابق، محام وكاتب
 Hitskin.com
Hitskin.com