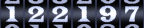تبني الأعيان والأحزاب والدولة للأحكام الشرعية:
هنالك أحكام تتعلق بتبني الأعيان "أي الأفراد" للأحكام الشرعية، بصفتهم الفردية،
تختلف عن الأحكام المتعلقة بتبنيهم للأحكام الشرعية إن تعلقت بالعمل الجماعي الحزبي،
وتختلف عن تبنيهم للأحكام الشرعية إن تعلقت بعلاقتهم ووجودهم في ظل دولة إسلامية يتبنى الخليفة أو القاضي فيها أحكاما شرعية
في قضايا خلافية أناط به (بالخليفة) الشارع مسؤولية تبني الأحكام التي ستنفذ قوانين في الدولة يتم بحسبها القضاء والعمل بها ظاهرا وباطنا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله.
وقد ثار خلاف طويل عريض قديما حول الأحكام المتعلقة بالتقليد، وترك الرأي الذي يراه المسلم سواء أكان واقعه واقع المقلد أم واقع المجتهد أو القاضي لرأي آخر رآه مجتهد آخر أو قاض آخر.
فالحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
يصل إليه المجتهد وآلته في ذلك الاجتهاد، أي استنباط الحكم من الأدلة التفصيلية، بـاستفراغ الوسعِ فـي طلبِ الظنّ بشيءٍ من الأحكامِ الشرعيَّةِ علـى وجهٍ يُحس من النفسِ العجز عن الـمزيد فـيهِ.
فيغلب على ظنه أن حكم الله في المسألة التي يجتهد فيها هو كذا.
وحكم الله تعالى في المسألة الواحدة واحد، لا يتعدد،
وقد بين الشارع ذلك الحكم بنوعين من الأدلة الموصلة إليه:
إما بأدلة قطعية، فهذه لا محل للاجتهاد فيها، فحكم الربا الحرمة، ولا اجتهاد فيه، ومثله فرض الصلاة ..
وإما بأمارات ظنية،
فالأمارة (هي ما يمكن أن يُتَوصل بصحيح النظر فيها إلى مطلوب خبري) وهي الأدلة على الأحكام الشرعية العملية،
قال الأستاذ فتحي سليم نقلا عن المستصفى، ثم معقباً:
(والأمارات الظنية ليست أدلة بأعيانها فقط بل يختلف ذلك بالإضافات، فرب دليل يفيد الظن لزيد وهو بعينه لا يفيد الظن لعمرو، مع إحاطته به، أو ربما يفيد الظن لشخص واحد في حال دون حال، بل قد يقوم في حق شخص واحد في حال واحدة في مسألة واحدة دليلان متعارضان كان كل واحد منهما لو انفرد لأفاد الظن، ولا يتصور في الأدلة القطعية تعارض، وبيانه:
إن أبا بكر رضي الله عنه، رأى التسوية في العطاء إذ قال: الدنيا بلاغ، فكيف وإنما عملوا لله عز وجل وأجورهم على الله، حيث قال عمر: كيف تساوي بين الفاضل والمفضول، ورأى عمر التفاوت ليكون ذلك ترغيباً في طلب الفضائل ولأن أصل الإسلام وإن كان لله فيوجب الاستحقاق،
والمعنى الذي ذكره أبو بكر فهمه عمر رضي الله عنهما، ولم يفده غلبة الظن ولا مال قلبه إليه وذلك لاختلاف أحوالهما،
فمن خلق خلقة عمر على حاله وسجيته في الالتفات إلى السياسة ورعاية مصالح الخلق وضبطهم وتحريك دواعيهم للخير فلا بد أن تميل نفسه إلى ما مال إليه عمر، مع إحاطة كل واحد منهما بدليل صاحبه،
ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسات [والسجايا] يوجب اختلاف الظنون، فمن مارس علم الكلام ناسب طبعه أنواعاً من الأدلة يتحرك بها ظنه لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه، ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى كل ما فيه شهامة وانتقام، ومن لان طبعه ورق قلبه نفر عن ذلك ومال إلى ما فيه الرفق والمساهلة،
فالأمارات كحجر المغناطيس تحرك طبعاً يناسبها كما يحرك المغناطيس الحديد دون النحاس،
بخلاف دليل العقل فإنه موجب لذاته فإن تسليم المقدمتين يوجب التصديق ضرورة بالنتيجة، فإذن لا دليل في الظنيات على التحقيق وما يسمى دليلا فهو على سبيل التجوز بالإضافة إلى ما مالت إليه نفسه حسب فهمه،
فإذن أصل الخطأ في هذه المسألة إقامة الفقهاء للأدلة الظنية وزناً حتى ظنوا أنها أدلة في أنفسها لا بالإضافة وهو خطأ محض.) انتهى
يعني أن الأمارة الواحدة بعينها، لا توصل إلى الاجتهاد في المسألة، بل بما يحتف حولها من القرائن والأحوال، والأمارات الأخرى، والقواعد ... الخ.
قال ابن أمير الحجاج في التقرير والتحبير: ( ثُمَّ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ )، وَهُوَ كَوْنُ الْفِقْهِ الظَّنَّ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْأَعْمَالِ الْمَذْكُورَةِ وَكَذَا عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ الْفِقْهِ هُوَ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْمَظْنُونَةَ لِلْأَعْمَالِ الْمَذْكُورَةِ
( يَخْرُجُ مَا عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ الدِّينِيَّةِ) أَيْ يَخْرُجُ مِنْ الْفِقْهِ مَا صَارَ مِنْ الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ الْمَعْرُوفِ انْتِسَابُهَا إلَى دِينِ الْإِسْلَامِ بِحَيْثُ صَارَ التَّصْدِيقُ بِهِ كَالتَّصْدِيقِ الْبَدِيهِيِّ فِي الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ
حَتَّى اشْتَرَكَ فِي مَعْرِفَةِ كَوْنِهِ مِنْ الدِّينِ الْعَوَامُّ الْقَاصِرُونَ كَوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ،
وَوَجْهُ الْخُرُوجِ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْعِنَادَ بَيْنَ الظَّنِّ وَالْعِلْمِ مَفْهُومًا قَائِمٌ وَكَذَا يَخْرُجُ هَذَا مِنْ الْفِقْهِ عِنْدَ مَنْ جَعَلَهُ عَلَمًا، وَاشْتَرَطَ فِي كَوْنِهِ مُتَعَلَّقًا بِالْأَحْكَامِ وَالْأَعْمَالِ الْمُشَارِ إلَيْهِمَا أَنْ يَكُونَ عَنْ اسْتِدْلَالٍ قِيلَ:
وَالنُّكْتَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْفِقْهَ لَمَّا كَانَ لُغَةً: إدْرَاكُ الْأَشْيَاءِ الْخَفِيَّةِ حَتَّى يُقَالُ فَقِهْت كَلَامَك وَلَا يُقَالُ فَقِهْت السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ. انتهى
فعمل المجتهد: أن يبذل وسعه لتحصيل غلبة الظن بأن حكم الله في هذه المسألة هو كذا،
وما سيصل إليه هو غلبة ظن،
ومع ذلك فحكم الله في المسألة واحد، قد يكون أصابه باستنباطه، أو لم يصبه، وهو في الحالين مأجور،
إلا أن السؤال:
هل يجوز له أن يترك هذا الاجتهاد الذي غلب على ظنه أنه هو حكم الله في المسألة لصالح اجتهاد آخر رأى غيره حكما لله في المسألة؟
كأن يصل مجتهد إلى أن حكم الله في مصافحة الرجال للنساء الحرمة، ويصل آخر إلى أنها مباحة، فهل لأحدهما ترك اجتهاده لصالح اجتهاد الآخر؟
وهل سيكون ترك ما غلب على ظنه أنه هو حكم الله في المسألة لصالح ما غلب على ظنه أنه ليس بحكم الله فيها؟
وهل الأعلمية مرجح يضاف إلى آلة المجتهد في استنباطه؟
كأن يرى الشافعي مثلا أن زيدا رضي الله عنه أعلم منه بالفرائض، فكل اجتهاد لزيد رضي الله عنه في الفرائض يقلده الشافعي أو يترك الاجتهاد فيه مع امتلاكه آلته، لصالح اجتهاد زيد لأن الأعلمية مرجح؟
 Hitskin.com
Hitskin.com