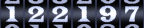السياسة الغائبة في مصر
عبد الحليم قنديل
Dec 24, 2016
لا يليق بمصر أن تظل على هذا الفصام النكد بين سياسات الخارج واختيارات الداخل، فالسياسة الخارجية والعربية لمصر جرى عليها تطور إيجابي ملحوظ وصارت أكثر استقلالا وندية، بينما اختيارات الداخل في فوضى شاملة، وتولد أزمات تتفاقم كل يوم، بما قد يضعف مقدرة الدولة على مواصلة سياسة خارجية جديدة.
فالقاعدة العامة، عندنا وعند غيرنا، أن السياسة الخارجية انعكاس مباشر للسياسة الداخلية، وفي مصر سياسة خارجية أفضل الآن، نقطة الضعف فيها هي سوء وتخبط اختيارات الداخل، ما قد يعود ويهدد السلامة النسبية للسياسات الخارجية. ولكل بلد ميزته النسبية، التي تختلف من لحظة إلى لحظة، وميزة مصر الحاسمة الآن هي جيشها القوي، فلا شيء ينافس عالميا في مصر الآن سوى الجيش، وهو أقوى عاشر جيش في الدنيا الآن، ثم أنه قاعدة الارتكاز الأساسية للحكم الراهن، وبالذات مع تعطيل السياسة واعتلال الاقتصاد، ورغم قسوة الظروف، نجح الحكم استنادا إلى الجيش في صناعة إنجازات لا تنكر، خاصة في المشروعات القومية الكبرى، في توسيع قناة السويس، وفي شبكة الطرق، وفي شبكة الأنفاق، وفي محطات الكهرباء العملاقة، وفي شبكة المدن الجديدة، وفي استصلاح أراض زراعية جديدة ضمن مشروع المليون والنصف مليون فدان، وفي الاقتحام غير المسبوق للصحراء، وقد أدارت هيئات من الجيش هذه المشروعات وغيرها، وكان دور الجيش إشرافيا، وبطريقة انضباطية صارمة معروفة عن تقاليد الجيش المصري، وهو ما صنع مزيج الكفاءة والسرعة والإتقان، وقيادة ورشة عمل هائلة، شاركت فيها المئات ـ ربما الآلاف ـ من شركات المقاولات المدنية الكبرى والصغرى، وعمل ويعمل فيها ما يزيد عن المليوني مهندس وفني وعامل مدني.
وربما يكون هذا التطور هو الأبرز في الداخل، وقد توافرت له موارد تريليونية من خارج موازنة الحكومة المنهكة، فقد جرى ويجري إنفاق ما قد يقارب التريليوني جنيه مصري على المشروعات الجديدة، وأغلبها أقرب إلى معنى خلق بنية أساسية متطورة، لا تظهر عوائدها إلا في المدى المتوسط والطويل، بينما لم يجر الالتفات بما يكفي، وهذه نقطة النقص الكبرى، إلى استخدام هذه الطاقة الجبارة في خلق اقتصاد إنتاجي تحتاجه مصر بشدة، وبعد أن جرى تجريف طاقتها الإنتاجية على مدى الأربعين سنة الأخيرة، وتصفية القطاع الصناعي العام، وخصخصة و»مصمصة» الأصول والمصانع، وتبوير الأراضي الزراعية مع انهيار سلطة القانون، وقد كان يمكن، ولا يزال ممكنا فيما نعتقد، أن يجري التوازن في قوة الإنجاز الجديدة، استنادا لإشراف الجيش، وأن يجري صرف نصف الجهد الممتاز لإنشاء مصانع جديدة، وتجديد المتهالك في المصانع القديمة، وخلق قطاع صناعي باستثمارات عامة، يقود اقتصادا إنتاجيا عصريا من نوع مختلف، ولم يحدث ذلك للأسف إلا قليلا إلى الآن، وعلى طريقة بناء مصنع «الإيثيلين» و»البولى إيثيلين» في مجمع بتروكيماويات العامرية، وتطوير مصنع «الكلور» في الفيوم، والبدء في إنشاء أضخم مجمع بتروكيماويات في «العين السخنة»، وكلها مشروعات متصلة بهيئات الجيش، وقد تتداخل مع قطاع الصناعات البترولية المدنية، وهو ما يبدو مفهوما، خاصة مع اكتشافات البترول والغاز الطبيعي المثيرة للأمل في مصر، لكن قطاعات الصناعة الأخرى تبدو في أزمة معقدة، وفي حالة موت سريري، كما جرى ويجري في صناعات النسيج والدواء والحديد والصلب والسيارات، مع تحسن طفيف جدا في قطاع الصناعات الغذائية العامة.
صحيح أنه جرى تطور ملموس في صناعات الإنتاج الحربي، وفي نشاط الهيئة العربية للتصنيع، ولا يبدو من حل مرئي في الأفق المصري الراهن، سوى بربط الصناعات المدنية مع الصناعات العسكرية، وبناء مجمع صناعي عسكري جديد، يكون قاعدة لاقتصاد المستقبل في مصر، مع تطوير اقتصاد المعرفة وصناعة الإلكترونيات الدقيقة، فلا حل لاقتصاد مصر المنهك، سوى بالتصنيع الشامل، وقد صارت الزراعة نفسها صناعة، فمشكلة مصر الكبرى هي في افتقاد الإنتاجية، وفي فقر المقدرة على صناعة سلع، تحل محل الواردات، وتزيد الصادرات، فلا حل في مصر سوى بمضاعفة الإنتاج ومضاعفة الصادرات مرات، وهو ما يحتاج إلى إرادة خلق مختلفة، تنهي الاعتماد المرضي على «اقتصاد الريع»، واقتصاد الخدمات، فليس بالسياحة تبنى الأمم، ولا بجعل مصر سوقا مفتوحة لسلع العالم ونفاياته، بل بالزراعة والصناعة واقتصاد المعرفة، وهذه الاختيارات هي التي تعيد بناء نظامنا التعليمي، وليس بأفكار هائمة تسبح في فراغ لانهائي، ولا بإنهاك الموارد المتاحة في بناء يخوت ومراسي ومدن سياحية، ينصرف إليها جهد عام، يحسن أن يركز على بناء اقتصاد الإنتاج، اعتمادا على الذات والاستثمارات العامة في الأساس، فتصنيع مصر مهمة لن تنجزها «رأسمالية المحاسيب» المسيطرة لا تزال على الموارد والاقتصاد والإعلام، وقد تكون «رأسمالية الجيش» هي الأقدر في ظروف مصر المحددة الآن، وبوسعها أن تتحول إلى رأسمالية دولة جديدة، تعبئ الموارد، وتمتص ملايين العاطلين في فرص عمل منتج.
نعم، التصنيع الشامل هو ما يليق بمصر الآن، وليس العودة إلى تجريب المجرب المخرب، وعلى طريقة تنفيذ روشتات «صندوق النقد الدولي» المجربة مرارا في مصر، والتي هي واحدة من علامات وشواهد انحطاط مصر على مدى أربعين سنة خلت، وقد حذرنا ونحذر مما سموه «إصلاحا اقتصاديا»، وهو في الحقيقة خراب بالجملة، فهو يوهم الناس أن المشكلة في أسعار الصرف، وفي أعباء الدعم على الموازنة العامة المنهكة، بينما أصل المشكلة في اقتصاد النهب والسرقات العامة، وفي «رأسمالية الشيبسي» والمنتجعات، وفي انتظار استثمار أجنبي يتحول إلى استعمار و»استحمار»، وفي الافتقار إلى الصناعة والزراعة والعلم والأساس الإنتاجي، وقد انتظروا استثمارات أجنبية لم تأت، وانتظروا معونات توقفت، فلا أحد يساعد أحدا لا يساعد نفسه، ولا يعتمد على تطوير قدراته الذاتية، ويلجأ إلى «اقتصاد التسول»، وعلى طريقة طلب قروض تزيد وطأة الديون، وقد قيل للناس إن «روشتة الصندوق» هي الحل، وجرى تنفيذ الشروط على نحو فجائي وصاعق، وكانت النتيجة إلى الآن كما توقعنا للأسف، فلا خفض جرى للديون، ولا خفض للعجز في الموازنة العامة، بل مضاعفة فورية في الديون وعجز الموازنة، وخفض قيمة الأصول والموجودات المصرية إلى النصف مع الاعتراف الرسمي بهلاك الجنيه مع قرار التعويم، فقد زاد السعر الرسمي للدولار عن سعره في السوق السوداء عشية التعويم، وهو ما ترتب عليه مضاعفة خدمة الديون الخارجية المقومة بالدولار، بل مضاعفة قيمة ما تبقى من دعم الدولة للغذاء والطاقة، أضف إلى ذلك عبء القروض الجديدة، التي قد تصل قريبا إلى 75 مليار دولار، أي بما يقارب ألفا وخمسمئة مليار جنيه بأسعار الصرف الرسمية الحالية، التي قد تتدهور أكثر في الشهور المقبلة، وبما أدى ويؤدي إلى كوارث كبرى، فالأسعار تزيد كل يوم بل كل ساعة، والغالبية العظمى من المصريين تنزلق إلى ما تحت خط الفقر، والفقراء والطبقات الوسطى يعجزون أكثر فأكثر عن مواصلة بطولة البقاء على قيد الحياة، وهو ما قد يهدد بانفجارات اجتماعية تلقائية، فقد نفد صبر غالب المصريين أو كاد، خصوصا مع التحيز الفادح لاختيارات السلطة الاقتصادية والاجتماعية، وضغطها المتصل على أعصاب الفقراء والطبقات الوسطى، وهم يشكلون قرابة التسعين بالمئة من المصريين، ولا يحصلون سوى على فتات ربع الثروة العامة، بينما لا ينجو سوى شعب العشرة بالمئة، وفي يدهم ثلاثة أرباع الثروة المصرية، وعلى قمتهم طبقة الواحد بالمئة، التي تحتكر نصف إجمالي الثروة، وهؤلاء لا تمسهم السلطة، ولا تجرؤ على الاقتراب من امتيازاتهم، فلا كنس يجرى لامبراطورية الفساد، ولا فرض لنظام الضرائب التصاعدية، ولا توزيع عادل لأعباء أزمة الاقتصاد، ولا أثر لمعنى العدالة الاجتماعية، وهذه كلها ظروف تكاد تخنق المجتمع المصري، وتزيد منسوب الغضب الاجتماعي تحت حافة الحناجر، خصوصا مع احتقان سياسي ملازم، وخلط بين السياسة والإرهاب، واستمرار احتجاز عشرات الألوف في السجون السياسية، وأغلبهم الساحق من غير المتهمين في قضايا عنف وإرهاب مباشر، وكل هذا مما لا يليق بمصر، ولا يضمن سلامتها الأكيدة، فكل المصريين ضد جماعات الإرهاب، وهزيمة الإرهاب في مصر محتومة، ولا تهديد حقيقيا لبدن الدولة ولا لجغرافيا مصر من جماعات الإرهاب، مهما كانت قوتها، فمصر غير قابلة للفصم ولا للقضم، بينما الخطر الحقيقي على الدولة من مصدر آخر، فالفساد أخطر من الإرهاب، والفساد ينخر كالإيدز في بدن الدولة، ويكاد يحولها إلى جثة متعفنة مرمية في الطريق العام، تزكم روائحها الأنوف، وتحجب عن المصريين نور الشمس، خاصة مع اختيارات الظلم الاجتماعي الحاكم، وما من حل يليق بمصر، سوى برد الاعتبار لاقتصاد التصنيع الشامل، وإقرار العدالة الاجتماعية، وحفظ الكرامة الإنسانية بوقف مظالم السجون وأقسام الشرطة، وإقرار قانون عفو سياسي شامل، يجبر ضرر الضحايا، ويخلي سبيل عشرات الألوف من المحتجزين وراء الأسوار، ولا يستثني سوى المتهمين والمحكومين في قضايا عنف وإرهاب، مع إطلاق سراح السياسة وحقوق الرأي والإبداع والتعبير والمعارضة السلمية، وليس بقاء الحال على صورته المأزومة، ومع سلطة تفتقر إلى الحس السياسي والاجتماعي معا، وتكاد تقوض أثر الإنجازات غير المنكورة، وهي بعيدة بطبع البنية الأساسية فيها، عن حس الناس وحياتهم الحاضرة المختنقة.
وغياب التصنيع والعدالة والسياسة يضعف المجتمع المصري، وقد ينزلق بالوضع كله إلى مهالك لا تليق بمصر، ولا تدعم ما تحقق من استقلالها الوطني، واستقلال قرارها وسياستها الخارجية والعربية، وهو ما تتربص به دوائر دولية وإقليمية معلومة للكافة، لا سبيل لمواجهتها سوى بتعبئة وطنية شعبية، لا تتحقق بغير مراجعة شاملة لسوء اختيارات الداخل في الاقتصاد والسياسة بالذات، ووقف الإنهاك والعدوان المتصل على حقوق غالبية المصريين. .
 Hitskin.com
Hitskin.com