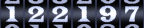ازدهارُ الجاهلية في عصر المعلوماتية!
صبحي غندور*
تعاني بلدان المنطقة العربية الآن من هبوط خطير في مستوى العلم والتعليم والمعرفة.
فالأمر لم يعد يرتبط فقط بنسبة الأميّة المرتفعة في عدّة بلدان، بل أيضاً بانحدار
مستوى التعليم نفسه، وبهيمنة فتاوى ومفاهيم دينية تُعبّر عن "جاهلية" جديدة
تُخالف حقيقة الدين ومقاصده.
فمشكلة البلاد العربية، والعالم الإسلامي عموماً، ليست في مواجهة الجهل بمعناه
العلمي فقط، بل أيضاً في حال "الجاهلية" التي عادت للعرب والمسلمين بأشكال مختلفة،
بعد قرونٍ من الزمن توقّف فيها الاجتهاد وسادت فيها قيودٌ فكرية وتقاليد وعادات
ومفاهيم هي من رواسب عصر "الجاهلية".
هنا تصبح مسؤولية الحكومات ومؤسّسات المجتمع المدني، لا في تحسين مستويات التعليم
ومراكز البحث العلمي فقط، بل بالمساهمة أيضاً في وضع لبنات لنهضة عربية جديدة،
ترفع الأمّة من حال الانحطاط والانقسام والتخلّف إلى عصرٍ ينتهج المنهج العلمي في
أموره الحياتية ويعتمد العقل والمعرفة السليمة في فهم الماضي والحاضر، وفي بناء
المستقبل، وفي التعامل الصحيح مع ما يُنشر من فتاوى باطلة ومسائل ترتبط بالعقائد
الدينية.
وقد يرى البعض أنّ هذا الانحطاط في حال الأمّة العربية هو من مسؤولية الخارج أو
الأجنبي فقط، وقد يرى البعض الآخر أنّ تردّي أوضاع الأمّة هو نتاج محلي فقط.. لكن
مهما كانت الأسباب، فإنّ النتيجة واحدة، وهي تحتّم تغيير حال الأمّة واستنهاضها من
جديد على أسسٍ تحفظ لها وحدة أوطانها، وتُحقق التكامل بينها، وتضمن العدل
والحرّيات لشعوبها، لكن تحقّق أيضاً تقدّمها وتطوّرها المنشود المبني على ثقافة
عربية ذات مضمون حضاري قائم على مزيجٍ من العلم والمعلوماتية والمعرفة والحكمة
معاً.
فهناك من يعتقد بوجود "تنوّع ثقافي" في المجتمعات العربية، بينما الصحيح هو وجود
ثقافة عربية واحدة تقوم على أصول ثقافية متعدّدة في المجتمعات العربية، إذ أنّ
الثقافة العربية منذ بدء الدعوة الإسلامية على الأرض العربية، وباللغة العربية،
ومن خلال روّاد عرب، أصبحت ثقافةً مميّزة نوعياً عن الثقافات الأخرى في البلاد
الإسلامية، وفي العالم ككل. فالثقافة العربية ارتبطت بالدعوة الإسلامية وبالمضمون
الحضاري الإنساني العام الذي جاء به الإسلام وحرّرها من اشتراط العرق أو الأصل
القبلي أو الإثني، وجعلها ثقافةً حاضنة واستيعابية لثقافاتٍ محلّية ولشعوبٍ تنتمي
إلى أعراق وأديان مختلفة.
الصحيح هو أنّ هناك "تنوّعاً ثقافياً" في العالم الإسلامي لكن ليس في المجتمع
العربي، فهناك "تنوّع ثقافي" دائماً تحت مظلّة أيّة حضارة. إذ أنّ الحضارات تقوم
على مجموعة من الثقافات المتنوعة، ويكون فيها ثقافةٌ رائدة كما هو حال الثقافة
الأميركية الآن في الحضارة الغربية، وكما كان حال الثقافة العربية في مرحلة نشر
الحضارة الإسلامية.
فالأمّة الأميركية هي الآن مجتمع مركّب من الأعراق والأديان والأصول الإثنية، لكن
في ظلّ ثقافة أميركية واحدة جامعة تُعبّر عن هويّة أميركية يعتزّ بها الأميركيون
بمختلف أصولهم. بينما البلاد العربية، والتي تملك أصلاً كل مقوّمات الأمّة
الواحدة: (اللغة المشتركة – التاريخ المشترك – الأرض المشتركة- المصالح المشتركة
والمصير الواحد)، فإنّها تعاني من حال الانقسامات والصراعات الداخلية التي تُهدّد
وحدتها الوطنية، فكيف بهويّتها العربية المشتركة التي يخجل بعض العرب حتّى من
الاعتراف بها! وهذا ما يُضعف الآن قضية الانتماء إلى ثقافة عربية واحدة مشتركة،
وهذا ما يتطلّب أيضاً الانتباه إلى التلازم الذي يحصل دائماً بين ضعف "الهويّة
العربية" وبين حال الانحطاط في أوضاع البلاد العربية .
وهناك عاملٌ آخر يزيد الآن من مأساة "الجهل والجاهلية" في المنطقة العربية، وهو
"نزيف الأدمغة العربية"، حيث ترتفع سنوياً نسبة هجرة الشباب العربي إلى الخارج
واستقرار عددٍ كبير من الكفاءات العلمية العربية في دول الغرب. لكن المشكلة أيضاً
ليست في "المكان" وأين هي الآن "الأدمغة العربية"، بل في دور هذه الكفاءات العربية
وفي كيفيّة رؤيتها نفسها ولهويّتها، وفيما تفعله أينما كانت لخدمة أوطانها. فقد
كان لوجود عقول عربية وإسلامية في أوروبا وأميركا في مطلع القرن العشرين الأثر
الإيجابي على البلاد العربية وعلى العالم الإسلامي، كما حصل في تجربة الشيخ محمد
عبده وصحيفة "العروة الوثقى" في باريس، أو في تجربة "الرابطة القلمية" في نيويورك.
فالسفر والمهجر ليسا مانعاً من التواصل مع المنطقة العربية والأوطان الأصلية أو مع
قضايا الأمّة عموماً، خاصّةً في عصر "العولمة" و"المعلوماتية" الذي نعيشه، بل على
العكس، فإنّ الحياة في الخارج قد تتيح فرصاً أكبر للتأثير والفعالية في "المكانين"
معاً.
في المقابل، هناك بعض "العقول العربية" مقيمة في المنطقة العربية لكنّها تخدم غير
العرب، بينما نجد عدداً لا بأس به من "العقول العربية" مقيمة في الخارج لكنّها في
ذروة عطائها للحقوق والقضايا العربية. فالمشكلة هنا ليست في "المكان" بل في
"الدور" وفي "الفكر" وفي كيفية تعريف النفس وتحديد الهُويّة، تماماً أيضاً في أنّ
المشكلة ليست في عدم حصول الجيل الجديد على شهادات علمية عالية، بل بغياب المعرفة
التي تدفع أصحابها إلى الالتزام بخدمة قضايا أوطانهم وأمّتهم. فكم من أمّيٍّ (غير
متعلم) يُحقق لنفسه المعرفة ويخدم التزاماتها، وكم من متعلّمٍ حائزٍ على شهادات
عالية لكنه أسير عمله الفئوي فقط، ولا يُدرك ما يحدث حوله ولا يُساهم في بناء
وتطوير معرفته وآفاقه الفكرية، ويكتفي بأن يتّبع "صاحب طريقة" أو "كتاب تفسير" فيه
الكثير مما لا يقبله العقل ولا الدين نفسه. فهذا هو الفرق بين "العلم" و"المعرفة"،
كما هو الفرق بين "الجهل" و"الجاهلية"!.
إنّ الإنسان العربي المعاصر هو إنسانٌ تائه، رغم ما حصل من تقدّم في العلوم
والمعرفة و"المعلوماتية". فلا هو يعرف إلى أين يسير مستقبله، ولا حتّى مصير وطنه
وأرضه ومجتمعه. هو شعور بالتّيه يسود معظم شعوب المنطقة العربية، فالحاضر مذموم
والغد مجهول. لا الوطن هو الوطن المنشود، ولا الغربة هي الوطن البديل!.
أيضاً، الإنسان العربي يعاصر اليوم عالماً فيه هيمنة كاملة للإعلام ولمصادر
"المعلوماتية" و"وسائل التواصل الاجتماعي"على عقول الناس ومشاعرهم ومواقفهم.
فالناس في زمننا الحالي، وبمختلف المجتمعات، نادراً ما يتعمّقون في معرفة الأمور
ويكتفون بالمعلومات السريعة عنها، بل أصبحت عقول معظمهم تعتمد الآن على البرامج
الإلكترونية، حتّى في العمليات الحسابية البسيطة، وأصبحت آليات هذه البرامج هي
صلات التواصل بين البشر بدلاً من التفاعل الشخصي المباشر، وكذلك ربّما في المنزل
نفسه أو بمكان العمل المشترك!.
هو الآن، في عموم العالم، عصر التضليل السياسي والإعلامي. فالتقدّم التقني، في
وسائل الاتصالات والشبكات العنكبوتية وإعلام الفضائيات، اخترق كلّ الحواجز بين دول
العالم وشعوبها. وأصبح ممكناً إطلاقُ صورةٍ كاذبة أو خبرٍ مختلَق، ونشره عبر هذه
الوسائل، لكي يُصبح عند ملايين من الناس حقيقة. فما يصنع "رأي" الناس في هذا العصر
هو "المعلومات" وليس "العلم" و"المعرفة"، وهذا ما أدركه الذين يصلون للحكم أو
يسعون إليه، كما أدركته أيضاً القوى التي تريد الهيمنة على شعوبٍ أخرى أو التحكّم
في مسار أحداثها.
هنا أهمّية "المعرفة" التي يضعف دروها يوماً بعد يوم، وهنا أيضاً أهمّية "الحكمة"
المغيَّبة إلى حدٍّ كبير. فبوجود "المعرفة" و"الحكمة" تخضع "المعلومات" لمصفاة
العقل المدرِك لغايات "المعلومات" ولأهداف أصحابها ولكيفيّة التعامل معها.
ف"المعلومات" قد تجعل الظالم مظلوماً والعكس صحيح، وقد تُحوّل الصديق عدواً والعكس
صحيح أيضاً. لكن "المعرفة" و"الحكمة" لا تسمحان بذلك.
17 نيسان/أبريل 2018
*مدير "مركز الحوار" في واشنطن
صبحي غندور*
تعاني بلدان المنطقة العربية الآن من هبوط خطير في مستوى العلم والتعليم والمعرفة.
فالأمر لم يعد يرتبط فقط بنسبة الأميّة المرتفعة في عدّة بلدان، بل أيضاً بانحدار
مستوى التعليم نفسه، وبهيمنة فتاوى ومفاهيم دينية تُعبّر عن "جاهلية" جديدة
تُخالف حقيقة الدين ومقاصده.
فمشكلة البلاد العربية، والعالم الإسلامي عموماً، ليست في مواجهة الجهل بمعناه
العلمي فقط، بل أيضاً في حال "الجاهلية" التي عادت للعرب والمسلمين بأشكال مختلفة،
بعد قرونٍ من الزمن توقّف فيها الاجتهاد وسادت فيها قيودٌ فكرية وتقاليد وعادات
ومفاهيم هي من رواسب عصر "الجاهلية".
هنا تصبح مسؤولية الحكومات ومؤسّسات المجتمع المدني، لا في تحسين مستويات التعليم
ومراكز البحث العلمي فقط، بل بالمساهمة أيضاً في وضع لبنات لنهضة عربية جديدة،
ترفع الأمّة من حال الانحطاط والانقسام والتخلّف إلى عصرٍ ينتهج المنهج العلمي في
أموره الحياتية ويعتمد العقل والمعرفة السليمة في فهم الماضي والحاضر، وفي بناء
المستقبل، وفي التعامل الصحيح مع ما يُنشر من فتاوى باطلة ومسائل ترتبط بالعقائد
الدينية.
وقد يرى البعض أنّ هذا الانحطاط في حال الأمّة العربية هو من مسؤولية الخارج أو
الأجنبي فقط، وقد يرى البعض الآخر أنّ تردّي أوضاع الأمّة هو نتاج محلي فقط.. لكن
مهما كانت الأسباب، فإنّ النتيجة واحدة، وهي تحتّم تغيير حال الأمّة واستنهاضها من
جديد على أسسٍ تحفظ لها وحدة أوطانها، وتُحقق التكامل بينها، وتضمن العدل
والحرّيات لشعوبها، لكن تحقّق أيضاً تقدّمها وتطوّرها المنشود المبني على ثقافة
عربية ذات مضمون حضاري قائم على مزيجٍ من العلم والمعلوماتية والمعرفة والحكمة
معاً.
فهناك من يعتقد بوجود "تنوّع ثقافي" في المجتمعات العربية، بينما الصحيح هو وجود
ثقافة عربية واحدة تقوم على أصول ثقافية متعدّدة في المجتمعات العربية، إذ أنّ
الثقافة العربية منذ بدء الدعوة الإسلامية على الأرض العربية، وباللغة العربية،
ومن خلال روّاد عرب، أصبحت ثقافةً مميّزة نوعياً عن الثقافات الأخرى في البلاد
الإسلامية، وفي العالم ككل. فالثقافة العربية ارتبطت بالدعوة الإسلامية وبالمضمون
الحضاري الإنساني العام الذي جاء به الإسلام وحرّرها من اشتراط العرق أو الأصل
القبلي أو الإثني، وجعلها ثقافةً حاضنة واستيعابية لثقافاتٍ محلّية ولشعوبٍ تنتمي
إلى أعراق وأديان مختلفة.
الصحيح هو أنّ هناك "تنوّعاً ثقافياً" في العالم الإسلامي لكن ليس في المجتمع
العربي، فهناك "تنوّع ثقافي" دائماً تحت مظلّة أيّة حضارة. إذ أنّ الحضارات تقوم
على مجموعة من الثقافات المتنوعة، ويكون فيها ثقافةٌ رائدة كما هو حال الثقافة
الأميركية الآن في الحضارة الغربية، وكما كان حال الثقافة العربية في مرحلة نشر
الحضارة الإسلامية.
فالأمّة الأميركية هي الآن مجتمع مركّب من الأعراق والأديان والأصول الإثنية، لكن
في ظلّ ثقافة أميركية واحدة جامعة تُعبّر عن هويّة أميركية يعتزّ بها الأميركيون
بمختلف أصولهم. بينما البلاد العربية، والتي تملك أصلاً كل مقوّمات الأمّة
الواحدة: (اللغة المشتركة – التاريخ المشترك – الأرض المشتركة- المصالح المشتركة
والمصير الواحد)، فإنّها تعاني من حال الانقسامات والصراعات الداخلية التي تُهدّد
وحدتها الوطنية، فكيف بهويّتها العربية المشتركة التي يخجل بعض العرب حتّى من
الاعتراف بها! وهذا ما يُضعف الآن قضية الانتماء إلى ثقافة عربية واحدة مشتركة،
وهذا ما يتطلّب أيضاً الانتباه إلى التلازم الذي يحصل دائماً بين ضعف "الهويّة
العربية" وبين حال الانحطاط في أوضاع البلاد العربية .
وهناك عاملٌ آخر يزيد الآن من مأساة "الجهل والجاهلية" في المنطقة العربية، وهو
"نزيف الأدمغة العربية"، حيث ترتفع سنوياً نسبة هجرة الشباب العربي إلى الخارج
واستقرار عددٍ كبير من الكفاءات العلمية العربية في دول الغرب. لكن المشكلة أيضاً
ليست في "المكان" وأين هي الآن "الأدمغة العربية"، بل في دور هذه الكفاءات العربية
وفي كيفيّة رؤيتها نفسها ولهويّتها، وفيما تفعله أينما كانت لخدمة أوطانها. فقد
كان لوجود عقول عربية وإسلامية في أوروبا وأميركا في مطلع القرن العشرين الأثر
الإيجابي على البلاد العربية وعلى العالم الإسلامي، كما حصل في تجربة الشيخ محمد
عبده وصحيفة "العروة الوثقى" في باريس، أو في تجربة "الرابطة القلمية" في نيويورك.
فالسفر والمهجر ليسا مانعاً من التواصل مع المنطقة العربية والأوطان الأصلية أو مع
قضايا الأمّة عموماً، خاصّةً في عصر "العولمة" و"المعلوماتية" الذي نعيشه، بل على
العكس، فإنّ الحياة في الخارج قد تتيح فرصاً أكبر للتأثير والفعالية في "المكانين"
معاً.
في المقابل، هناك بعض "العقول العربية" مقيمة في المنطقة العربية لكنّها تخدم غير
العرب، بينما نجد عدداً لا بأس به من "العقول العربية" مقيمة في الخارج لكنّها في
ذروة عطائها للحقوق والقضايا العربية. فالمشكلة هنا ليست في "المكان" بل في
"الدور" وفي "الفكر" وفي كيفية تعريف النفس وتحديد الهُويّة، تماماً أيضاً في أنّ
المشكلة ليست في عدم حصول الجيل الجديد على شهادات علمية عالية، بل بغياب المعرفة
التي تدفع أصحابها إلى الالتزام بخدمة قضايا أوطانهم وأمّتهم. فكم من أمّيٍّ (غير
متعلم) يُحقق لنفسه المعرفة ويخدم التزاماتها، وكم من متعلّمٍ حائزٍ على شهادات
عالية لكنه أسير عمله الفئوي فقط، ولا يُدرك ما يحدث حوله ولا يُساهم في بناء
وتطوير معرفته وآفاقه الفكرية، ويكتفي بأن يتّبع "صاحب طريقة" أو "كتاب تفسير" فيه
الكثير مما لا يقبله العقل ولا الدين نفسه. فهذا هو الفرق بين "العلم" و"المعرفة"،
كما هو الفرق بين "الجهل" و"الجاهلية"!.
إنّ الإنسان العربي المعاصر هو إنسانٌ تائه، رغم ما حصل من تقدّم في العلوم
والمعرفة و"المعلوماتية". فلا هو يعرف إلى أين يسير مستقبله، ولا حتّى مصير وطنه
وأرضه ومجتمعه. هو شعور بالتّيه يسود معظم شعوب المنطقة العربية، فالحاضر مذموم
والغد مجهول. لا الوطن هو الوطن المنشود، ولا الغربة هي الوطن البديل!.
أيضاً، الإنسان العربي يعاصر اليوم عالماً فيه هيمنة كاملة للإعلام ولمصادر
"المعلوماتية" و"وسائل التواصل الاجتماعي"على عقول الناس ومشاعرهم ومواقفهم.
فالناس في زمننا الحالي، وبمختلف المجتمعات، نادراً ما يتعمّقون في معرفة الأمور
ويكتفون بالمعلومات السريعة عنها، بل أصبحت عقول معظمهم تعتمد الآن على البرامج
الإلكترونية، حتّى في العمليات الحسابية البسيطة، وأصبحت آليات هذه البرامج هي
صلات التواصل بين البشر بدلاً من التفاعل الشخصي المباشر، وكذلك ربّما في المنزل
نفسه أو بمكان العمل المشترك!.
هو الآن، في عموم العالم، عصر التضليل السياسي والإعلامي. فالتقدّم التقني، في
وسائل الاتصالات والشبكات العنكبوتية وإعلام الفضائيات، اخترق كلّ الحواجز بين دول
العالم وشعوبها. وأصبح ممكناً إطلاقُ صورةٍ كاذبة أو خبرٍ مختلَق، ونشره عبر هذه
الوسائل، لكي يُصبح عند ملايين من الناس حقيقة. فما يصنع "رأي" الناس في هذا العصر
هو "المعلومات" وليس "العلم" و"المعرفة"، وهذا ما أدركه الذين يصلون للحكم أو
يسعون إليه، كما أدركته أيضاً القوى التي تريد الهيمنة على شعوبٍ أخرى أو التحكّم
في مسار أحداثها.
هنا أهمّية "المعرفة" التي يضعف دروها يوماً بعد يوم، وهنا أيضاً أهمّية "الحكمة"
المغيَّبة إلى حدٍّ كبير. فبوجود "المعرفة" و"الحكمة" تخضع "المعلومات" لمصفاة
العقل المدرِك لغايات "المعلومات" ولأهداف أصحابها ولكيفيّة التعامل معها.
ف"المعلومات" قد تجعل الظالم مظلوماً والعكس صحيح، وقد تُحوّل الصديق عدواً والعكس
صحيح أيضاً. لكن "المعرفة" و"الحكمة" لا تسمحان بذلك.
17 نيسان/أبريل 2018
*مدير "مركز الحوار" في واشنطن
 Hitskin.com
Hitskin.com