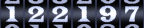السياسات المناهِضة للرأسمالية في زمن الكوفيد-19
ديفيد هارفي
ترجمة علاء بريك هنيدي
في حال لم تستطع الصين تكرار دورها في أزمة 2007-2008، عندئذ سينتقل عبء الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة إلى الولايات المتحدة وهنا قمة المفارقة: إذْ أنَّ السياسات الوحيدة الناجعة، على المستويين الاقتصادي والسياسي، أكثر اشتراكية من أي شيء يمكن لبيرني ساندرز أنْ يقترحه، وسوف يكون إطلاق برامج الإنقاذ هذه برعاية دونالد ترامب، خلف قناع إعادة أميركا عظيمة من جديد
أميلُ، عند محاولتي تفسير سيل الأخبار اليومي وفهمه وتحليله، إلى وضع ما يجري على خلفية نموذجَيْن متمايزَيْن لكنهما متقاطعان لكيفيّة عمل الرأسمالية. يقوم النموذج الأول على رسم خريطة للتناقضات الداخلية لتداول رأس المال وتراكمه بوصفه تدفقات للقيمة النقدية تسعى وراء الربح خلال “اللحظات” (كما يسميها ماركس) المختلفة للإنتاج والتحقيق (الاستهلاك) والتوزيع وإعادة الاستثمار. هذا نموذجٌ للاقتصاد الرأسمالي باعتباره توسعًا ونموًا لَولَبييّن متصاعدين لانهائيين. وهو نموذج يصبح غايةً في التعقيد إذ يُحْكَم مزيداً من الإحكام عبر التنافسات الجيوسياسية والتطور الجغرافي اللامتكافئ، والمؤسسات المالية، وسياسة الدولة، والانقلابات التكنولوجية، والشبكة المتغيرة أبدًا لتقسيم العمل والعلاقات الاجتماعية، على سبيل المثال لا الحصر.
غير أنّي أرى إلى هذا النموذج على أنّه جزءٌ من سياقٍ أكبر من إعادة الإنتاج الاجتماعي (في الأُسر والجماعات)، ومن علاقةٍ مستمرة ومتطورة مع الطبيعة (بما فيها “الطبيعة الثانية” للتمدُّن “urbanization” والبيئة المَبنيّة) وكافة صنوف التشكيلات الثقافية والعلمية (المعرفية) والدينية والطارئة التي يخلقها الاجتماع البشري عبر المكان والزمان. وتدمج هذه “اللحظاتُ” الأخيرة التعبيرَ الفاعل عن المطالب والحاجات والرغبات البشرية وشهوة المعرفة والمعنى والسعي النامي وراء التحقق والإنجاز على خلفية متغيرة من الترتيبات المؤسسية والمنازعات السياسية والمواجهات الأيديولوجية والخسارات والهزائم والإحباطات وصنوف الاغتراب، تجري جميعًا في عالمٍ موسوم بالتنوع الجغرافي والثقافي والاجتماعي والسياسي. وهذا هو النموذج الثاني الذي يشكّل، إذا جاز التعبير، فهميَ العملي للرأسمالية العالمية بوصفها تشكيلةً اجتماعية متمايزة، في حين يتعلق النموذج الأول بالتناقضات ضمن المحرّك الاقتصادي الذي يحرِّك هذه التشكيلة الاجتماعية على مساراتٍ محددة لتطورها التاريخي والجغرافي.
التصاعد اللولبي
حين قرأت في 26 كانون الثاني/يناير 2020 لأول مرة عن فيروس كورونا، الآخذ في الانتشار في الصين، فكرتُ على الفور في انعكاسات ذلك على الديناميكيات العالمية لتراكم رأس المال. إذْ أعلمُ من دراستي للنموذج الاقتصادي بأنَّ الانسدادات والانقاطاعات في استمرارية تدفق رأس المال ستؤدي إلى انخفاضٍ في القيمة “Devaluation”، وإذا ما عمَّ انخفاض القيمة وتعمَّق، فإنَّ ذلك يؤشر على بداية أزمة. وكنت أدرك كذلك بأنَّ الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأنَّها أنقذت الرأسمالية العالمية عقب أحداث 2007-2008، ولذلك فإنّ أيّ ضربة للاقتصاد الصيني ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي الذي يمر أصلًا بوضعٍ خطر. وبدا لي أنَّ النموذج الحالي لتراكم رأس المال يواجه مشكلات جمّة أصلاً. وثمة احتجاجات شعبية في كل مكان تقريبًا (من سانتياغو إلى بيروت) يتركَّز كثير منها على أنَّ النموذج الاقتصادي السائد لا يخدم جمهرة الشعب. إذْ يتكئ هذا النموذج النيوليبرالي بصورة متزايدة على رأس مال وهمي وعلى توسّع مهول في المعروض النقدي وخلق الديون. وهو يواجه أصلاً مشكلة عدم كفاية الطلب الفعال كي يُحقِّق القيم التي يمكن لرأس المال إنتاجها. وعليه، كيف يمكن لهذا النموذج الاقتصادي السائد، بشرعيته الهابطة وصحته المُعتَلّة، أنْ يستوعب الآثار المحتَّمة لما قد يتحوَّل إلى وباء وينجو منه؟ يتوقف الجواب على طول الانقطاع ومدى انتشاره، فانخفاض القيمة، كما أشار ماركس، لا يقع بسبب عدم القدرة على بيع السلع بل بسبب عدم بيعها في الوقت المناسب.
لطالما رفضتُ فكرة “الطبيعة” بوصفها خارج الثقافة والاقتصاد والحياة اليومية ومفصولةً عنها. وأنا أتبنى رؤية أكثر ديالكتيكية وعلائقية للعلاقة الأيضية مع الطبيعة. صحيحٌ أنَّ رأس المال يعدّل ظروف إعادة إنتاجه البيئية، لكنه يفعل ذلك في سياقٍ من النتائج غير المقصودة (كالتغيُّر المناخي)، وعلى خلفية قوىً تطورية مستقلة وحرة لا تني تُعيد تشكيل الظروف البيئية. ومن هذا المنطلق، ليس ثمَّة ما ندعوه بكارثة طبيعية بالمعنى الخالص للكلمة. لا شكّ أنَّ الفيروسات تخضع لطفرات طوال الوقت، لكن الظروف التي تغدو فيها طفرة من الطفرات مهددة للحياة تتوقف على أفعال البشر.
الآثار الاقتصادية والسكانية لانتشار الفيروس تتوقف على ما يوجد سلفًا من صدوع ونقاط ضعف في النموذج الاقتصادي المهيمن
ثمَّة جانبان مترابطان لهذا الأمر. أولهما، هو أنَّ الظروف البيئية المواتية تزيد من احتمال الطفرات الشديدة. فمن المعقول أن نتوقع، مثلاً، أن تكون لمنظومات الإمداد الغذائي المكثَّفة والمنفلتة في المناطق شبه الاستوائية الرطبة مساهمتها في مثل هذه الطفرات. توجد مثل هذه المنظومات في أماكن عدة، من بينها الصين جنوب يانغتسي وجنوب شرق آسيا. وثانيهما، هو أنَّ الظروف التي تحفِّز الانتقال السريع عبر الأجسام المُضيفة تتباين أشدّ التباين. ويبدو أنَّ التجمعات السكانية المكتظة هي هدف مضيف سهل. ومن المعروف مثلاً أنَّ جائحات الحصبة تنتشر في المراكز السكانية الكبيرة في حين تهمد بسرعة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. ولكيفية تفاعل الناس مع بعضهم بعضاً وانتقالهم وانضباطهم أو نسيانهم غسل أيديهم تأثيرٌ على كيفية انتقال الأمراض. وفي الآونة الأخيرة، يبدو أنَّ “السارس” وإنفلونزا الطيور والخنازير قد أتتنا من الصين وجنوب شرق آسيا. وقد عانت الصين كثيرًا من حمى الخنازير في العام الفائت، ما استلزم ذبح عدد كبير من الخنازير وارتفاعًا في أسعار لحمها. لا أقول هذا لأُدينَ الصين. إذْ ثمَّة أماكن كثيرة أخرى تعلو فيها المخاطر البيئية للطفرات الفيروسية وانتشارها. وربما تكون “الإنفلونزا الإسبانية” عام 1918 قد أتت من كانساس، وربما احتضنت أفريقيا فيروس “الإيدز”، وانطلق منها “فيروس غرب النيل” و”الإيبولا”، في حين يبدو أنَّ “حمى الضنك” قد انتشرت من أميركا اللاتينية. لكن الآثار الاقتصادية والسكانية لانتشار الفيروس تتوقف على ما يوجد سلفًا من صدوع ونقاط ضعف في النموذج الاقتصادي المهيمن.
لم يُفاجئني أنَّ “الكوفيد-19” وُجِدَ بدايةً في ووهان (على الرغم من عدم معرفتنا إنْ كان قد نشأ هناك). ومن الواضح أنَّ التأثيرات المحلية ستكون كبيرة. وبالنظر إلى أنَّ ووهان مركز إنتاجي مهم فمن المرجح أنْ تكون ثمَّة انعكاسات اقتصادية عالمية (وإن لم تكن لدي أيّ فكرة عن حجم هذه الانعكاسات). كان السؤال الكبير كيف يمكن أنْ تقع العدوى وتنتشر وكم ستدوم (إلى حين إيجاد لقاحٍ ما). أظهرت الخبرة السابقة أنَّ إحدى المآخذ على العولمة المتزايدة هي مدى استحالة إيقاف الانتشار العالمي السريع لأمراضٍ جديدة. إذْ نعيش في عالمٍ شديد الترابط حيث تسافر أغلبيتنا الساحقة. والشبكات البشرية لانتشار الفيروس المحتمَل هي شبكات شاسعة ومفتوحة. ويتمثّل الخطر (الاقتصادي والسكاني) في أنَّ هذا الانقطاع قد يدوم سنة أو أكثر.
في حين كان هناك تراجع فوري في أسواق الأسهم العالمية عند اندلاع الأخبار الأولى، إلَّا أنَّه أعقبها شهرٌ أو أكثر ضربت فيه الأسواق، بشكلٍ مفاجئ، مستوياتٍ قياسية جديدة. وبدا أنَّ الأخبار تؤشِّر إلى أنَّ الأعمال التجارية تجري كالمعتاد في كل مكان باستثناء الصين. وساد الاعتقاد بأنَّنا على أعتاب موجةٍ جديدة من “السارس” الذي تبيّن أنَّ من الممكن احتواءه بسرعة وليس له ذلك التأثير العالمي الكبير على الرغم من ارتفاع معدل وفياته وخلقهِ حالةً غير ضرورية (عند التفكير في ذلك الآن) من الهلع في الأسواق المالية. حين ظهر “الكوفيد-19″، كانت ردة الفعل السائدة تصويره كعودة لـ”السارس”، ما جعل حالة الهلع غير ضرورية وزائدة. كما أدّت حقيقة حلول الوباء في الصين التي تحركت بسرعة وبلا هوادة لاحتواء تأثيراته، إلى تعامل بقية العالم مع المشكلة على نحوٍ خاطئ بوصفها شيئًا يجري هناك “بعيداً” عن الأنظار والبال (وترافق ذلك مع بعض علائم مُقلِقَة على رهاب أجانب “xenophobia” معادٍ للصين في مناطق معينة من العالم). بل إنَّ دوائر معينة في إدارة ترامب احتفت بالخنجر الذي يغرسه الفيروس في القصة المُظفَّرة للنمو الصيني.
بدا تخفيض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة لمواجهة الفيروس أمرًا لافتاً، حتى حين أُقِرَّ بأنَّ هذه الحركة هدفت إلى التخفيف من التأثير على السوق وليس الوقوف في وجه تقدم الفيروس
لكنَّ قصص الانقطاع في سلاسل الإنتاج العالمية التي تعبر ووهان بدأت تنتشر. وجرى إلى حد بعيد تجاهل هذه القصص أو معالجتها على أنَّها مشاكل مرتبطة بخطوط إنتاج أو شركات بعينها (مثل “آبل”). كانت انخفاضات القيمة محلية ومحددة ولم تكن شاملة. كما جرى التقليل من شأن المؤشرات على انخفاض الطلب الاستهلاكي، على الرغم من اضطرار شركات ذات أعمال كبرى في السوق المحلي الصيني، مثل “مكدونالدز” و”ستاربكس”، إلى إغلاق أبوابها هناك لفترة من الوقت. لقد أخفى تداخل رأس السنة الصينية وتفشي الفيروس تلك التأثيرات طيلة يناير/كانون الثاني. وكان التساهل في الردّ غير موفقٍ وفي غير محله.
كانت الأخبار الأولى عن الانتشار العالمي للفيروس عرضية ومتفرقة مع تفشٍ خطير في كوريا الجنوبية وبعض البؤر الأخرى مثل إيران. وكان تفشيه في إيطاليا ما أثار أول ردة فعلٍ قوية. وتذبذب انهيار أسواق الأسهم الذي بدأ في منتصف شباط/فبراير بعض التذبذب لكنه أدّى بحلول منتصف آذار/مارس إلى انخفاضٍ صافٍ في القيمة يناهز الـ30% في أسواق الأسهم حول العالم.
أثار انتشار العدوى بمتوالية هندسية طيفاً من ردود الفعل غير المُتسِقة والمتسمة بالهلع في بعض الأحيان. قلَّد الرئيس ترامب الملك كَنيوت[1] في مواجهة مدّ الإصابات والوفيات المحتمل. وكانت بعض ردود الفعل شديدة الغرابة. وبدا تخفيض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة لمواجهة الفيروس أمرًا لافتاً، حتى حين أُقِرَّ بأنَّ هذه الحركة هدفت إلى التخفيف من التأثير على السوق وليس الوقوف في وجه تقدم الفيروس.
تبيّن أنَّ السلطات العامة ومنظومات الرعاية الصحية في كل مكان تقريبًا تعاني من نقصٍ في الأيدي العاملة. لقد عمل أربعون عامًا من النيوليبرالية في الأمريكيتين وأوروبا على ترك البشر مكشوفين تماماً وغير مهيئين لمواجهة أزمة صحية كهذه، مع أنَّ المخاوف السابقة من “السارس” و”الإيبولا” كانت قد أطلقت تحذيرات كثيرة ودروساً مُفحِمة حول ما يجب القيام به. وفي بقاعٍ عديدة من العالم الذي يُفترَض أنّه “متحضر”، كانت الحكومات المحلية وسلطات الدول والسلطات الإقليمية التي تشكل على الدوام خط الدفاع الأول في مجال الصحة العامة وحالات الطوارئ من هذا النوع، محرومة من التمويل بفعل سياسة التقشف الهادفة لخفض الاقتطاعات الضريبية وتقديم الإعانات للشركات والأغنياء.
ليس لدى شركات الدواء الكبرى بيغ فارما “Big Pharma” سوى القليل من الاهتمام بالبحث غير المجزي حول الأمراض المعدية (كتلك التي تسببها فئة كاملة من فيروسات الكورونا المعروفة منذ ستينيات القرن العشرين)، هذا إن كان لديها أيُّ اهتمامٍ بذلك. وقلما تستثمر هذه الشركة في أمور الوقاية. وليس لديها سوى اهتمام ضئيل بالاستثمار في مجال الاستعداد لمواجهة أزمة صحية عامة. وهي مغرمة بتقديم العلاجات. وكلما مرضنا أكثر، كسبت أكثر. أمّا الوقاية فلا تسهم في زيادة قيمة الأسهم. لقد تخلَّص نموذج البزنس المُطبَّق على الصحة العامة من قدرات المواجهة الفائضة التي تكون مطلوبة في أوقات الطوارئ. ولم تشكل الوقاية حتى ذلك المجال الجذاب بما يكفي لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد قلَّص الرئيس ترامب ميزانية مركز مكافحة الأمراض (Center for Disease Control) وحلَّ فريق العمل المعني بالأوبئة في مجلس الأمن القومي بنفس الروح التي أوقف بها كل تمويل للبحث العلمي، بما في ذلك البحث المتعلّق بالتغير المناخي. ولو أردتُ أنْ أكون من المشبّهة في ما يتصل بهذا الأمر أو أستخدم الاستعارة حياله لقلت إنَّ كوفيد-19 هو انتقام الطبيعة إزاء أكثر من 40 سنة من سوء معاملتها الجسيمة والمتعسفة من قِبَل نزعة استخراجية[2] نيوليبرالية متوحشة ومنفلتة من كل عقال.
ما كان مميزًا في الصين هو حصر الوباء في مقاطعة هوبي ومركزها ووهان، فلم ينتقل الوباء إلى بكين أو إلى الغرب أو حتى نحو الجنوب
لعلّه ذا مغزى أنَّ الدول الأقلّ نيوليبرالية، كالصين وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، واجهت الوباء بشكلٍ أفضل حتى الآن مقارنة بإيطاليا، على الرغم من أنَّ إيران تُشكِّل طعنًا في هذه الحجة بوصفها مبدأً عامًا. وفي حين كان ثمَّة كثير من الأدلة على أنَّ الصين تعاملت مع “السارس” على نحوٍ بالغ السوء وبقدر كبير من الإخفاء والإنكار في أول الأمر، إلَّا أنَّ الرئيس شي [جين بينغ] تحرك بسرعة هذه المرة لتبني الشفافية في الإخبار والاختبار على السواء، كما فعلت كوريا الجنوبية. ومع ذلك، فقد ضاع بعض الوقت الثمين في الصين (إذْ تُحدِثُ بضع أيام فحسب فارقًا كبيرًا). لكنّ ما كان مميزًا في الصين هو حصر الوباء في مقاطعة هوبي ومركزها ووهان. فلم ينتقل الوباء إلى بكين أو إلى الغرب أو حتى نحو الجنوب. وكانت الإجراءات المتخذة لحصر الفيروس جغرافيًا شديدة القسوة. وسوف يكون من المتعذر تكرارها في أماكن أخرى لأسبابٍ سياسية واقتصادية وثقافية. وتشير التقارير القادمة من الصين إلى أنَّ العلاجات والسياسات لم تكن لتمتّ إلى الرعاية بصلة. بل إنَّ الصين وسنغافورة استخدمتا قدرتيهما على الرقابة الشخصية بدرجات عدوانية وسلطوية. ولكن يبدو أنَّها كانت فعالة في المجمل، على الرغم من أنَّه لو بُدِءَ بالإجراءات المضادة قبل أيام قليلة فحسب لأمكن تفادي كثير من الوفيات. هذه معلومة مهمة: في أيّ نمو بمتوالية هندسية، ثمَّة نقطة انعطاف يخرج بعدها التزايد عن السيطرة كلّ الخروج (لاحظوا هنا، مرةً أخرى، أهمية مقدار التزايد بالنسبة إلى المعدل). وربما يُثبت تبديد ترامب أسابيع عديدة أنه باهظ الكلفة في ما يزهقه من أرواح بشرية.
تتصاعد الآثار الاقتصادية الآن خارجةً عن السيطرة داخل الصين وخارجها على السواء. وباتت الانقطاعات في سلاسل القيمة في الشركات وفي قطاعات بعينها أشمل وأفدح مما اعتُقد في البداية. وقد يتمثّل الأثر طويل الأجل بتقصير سلاسل العرض أو تنويعها مع الانتقال صوب أشكال من الإنتاج أقل كثافة من ناحية العمل (مع تداعياتٍ هائلة على العمالة) واعتماد أكبر على منظومات الذكاء الصناعي الإنتاجية. ويستتبع انقطاع سلاسل الإنتاج تسريح العمال أو إعطائهم إجازات كيفما اتفق، ما يقلل الطلب النهائي، في حين يقلل الطلبُ على المواد الأولية الاستهلاكَ الإنتاجي. وبدورها فإنَّ هذه الآثار على الطلب لا بد أن تؤدي إلى ركودٍ متوسط على الأقلّ.
لقد تعطل ميدان التراكم هذا بالكامل: شركات الطيران على شفا الإفلاس والفنادق خاوية
لكن أكبر نقاط الضعف هي في مكانٍ آخر. لقد انهارت أنماط الاستهلاك التي انفجرت عقب أزمة 2007-2008 مخلفةً عواقب مدمرة. وتستند هذه الأنماط إلى اختزال دورة الاستهلاك أو زمن تجدده إلى الصفر ما أمكن. ويرتبط تدفق الاستثمارات إلى هذه الأشكال من الاستهلاك كلّ الارتباط بالامتصاص الأقصى لمقادير من رأس المال متزايدة بمتوالية هندسية في أشكال الاستهلاك التي تتسم بأقصر دورة ممكنة. ومن الأمثلة على ذلك السياحة الدولية. إذْ ازدادت الزيارات الدولية من 800 مليون إلى 1.4 مليار بين عامَيْ 2010 و2018. ويتطلب مثل هذا الشكل من الاستهلاك الآني استثماراتٍ ضخمة في البنية التحتية للمطارات وخطوط الطيران والفنادق والمطاعم والمنتزهات والأنشطة الثقافية، إلخ. لقد تعطل ميدان التراكم هذا بالكامل: شركات الطيران على شفا الإفلاس، والفنادق خاوية، والبطالة الجماعية في صناعات الضيافة والسياحة مهولة. ولم يَعُد تناول الطعام في الخارج فكرةً حسنة، وأقفلت المطاعم والبارات في عدة أماكن. حتى طلب الوجبات الجاهزة يبدو خطرًا. ويجري تسريحُ الجيش الضخم من عمال الاقتصاد التعاقدي الحرّ أو في حقولٍ أخرى من الأعمال غير الثابتة، بلا أي وسائل دعم منظورة. وألغيت الأنشطة والمناسبات، كالمهرجانات الثقافية وبطولات كرة القدم والسلة والحفلات الموسيقية والمؤتمرات التجارية والمهنية بل وحتى التجمعات السياسية الخاصة بالانتخابات. لقد أُوقفت هذه الأشكال “المناسباتية” من الاستهلاك التجريبي[3]. وتراجعت عوائد الحكومات المحلية. وأغلِقَت المدارس والجامعات.
لقد تعطل مقدار كبير من نموذج الاستهلاك الرأسمالي المعاصر والعصري في ظل الظروف الحالية. وضعُف ما يصفه أندريه غورز بـ”الاستهلاك التعويضي” (حيث يُفترَض أنْ يستعيد العمال المستَلبون معنوياتهم من خلال إجازةٍ على شاطئ استوائي).
لكن الاستهلاك يدفع 70% أو حتى 80% من الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة. وغدت ثقة المستهلك وعاطفته مفتاح تعبئة الطلب الفعال خلال العقود الأربعة الماضية، وصار رأس المال مدفوعًا بالطلب والحاجات على نحو متزايد. ولم يتعرض هذا المصدر من مصادر الطاقة الاقتصادية لتقلباتٍ كبيرة (مع استثناءات قليلة، كتوقف الرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي لأسبوعين جراء ثوران البركان [إيافيالايوكل] الآيسلندي). إلّا أنَّ “كوفيد-19” لم يُثِر تقلباتٍ كبيرة بل انهيارًا جسيمًا في صلب الاستهلاك السائد في البلدان الأكثر ثراءً. وينهار شكل التراكم الرأسمالي اللولبي المتصاعد اللامتناهي في بقعة تلو أخرى من العالم. والشيء الوحيد الذي يمكنه إنقاذه هو استهلاك جماهيري مموَّل ومُلهَم حكومياً مُستَمَد من العدم. وهذا يتطلب تأميم الاقتصاد الأميركي كلّه، على سبيل المثال، من دون تسمية ذلك بالاشتراكية.
الخطوط الأمامية
ثمَّة أسطورة مُقنِعة تقول إنَّ الأمراض المُعدية لا تعترف بالحواجز والحدود الطبقية أو سواها من الحواجز والحدود الاجتماعية. وكما في كثير من مثل هذه الأقوال، ثمَّة بعض الحقيقة في هذا القول. فخلال وباء الكوليرا في القرن التاسع عشر، كان تخطي الحواجز الطبقية من الشدّة إلى درجة دفعت إلى ولادة حركة الصرف الصحي والصحة العامة التي غدت ذات طابع مهني واستمرت حتى يومنا هذا. وليس واضحًا على الدوام ما إذا كانت هذه الحركة قد استهدفَت حماية الجميع أم الاقتصار على الطبقات العليا. أمّا اليوم فتخبرنا التأثيرات والآثار الطبقية والاجتماعية المتباينة قصةً مختلفة. ذلك أنَّ التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية ترشح عبر ضروب من التمييز “المعتاد” واضحة في كلّ مكان. بادئ ذي بدء، فإنَّ القوة العاملة المنوط بها رعاية الأعداد المتزايدة من المرضى عادةً ما تكون ذات طابع جندري، وعرقي، وإثني، في أغلب بقاع العالم. وتناظر هذه القوة تلك القوة القائمة على أساس طبقي العاملة في المطارات أو غيرها من القطاعات اللوجستية، على سبيل المثال.
تقف هذه “الطبقة العاملة الجديدة” في المقدمة وتحمل عبء أن تكون قوة العمل الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس بحكم عملها، أو تُسرَّح من دون أي موارد بسبب الانكماش الاقتصادي الذي يفرضه الفيروس. ثمَّة تساؤل، مثلاً، عمَّن يمكنه العمل من المنزل ومَن لا يمكنه. وهذا يزيد من حِدّة الانقسام المجتمعي مثلما يزيد التساؤل عمَّن يسعه أن يتحمّل العزل أو الحَجْر (بأجر أو من دونه) في حال التماس أو الإصابة. ومثلما تعلمتُ أنْ أُسميَ زلازل نيكاراغوا (1973) ومكسيكو سيتي (1995) “زلازل طبقية”، كذلك يبدي مسار الكوفيد-19 جميع خصائص الوباء الجندري والطبقيّ والعرقي. وفي حين تُغطى جهود الكبح ببلاغة مفادها أنّنا “جميعًا في المركب ذاته”، تشير الممارسات، لا سيما من طرف الحكومات الوطنية، تشيرُ إلى دوافع أكثر خبثًا. إذْ تواجه الطبقة العاملة في الولايات المتحدة (المكونة في الغالب من أميركيين من أصل أفريقي ولاتيني ونساء عاملات بأجر) خيارَيْن أحلاهما مُرّ، فإما العدوى باسم الرعاية وإبقاء مهن رئيسة (كمحلات البقالة) مفتوحةً، أو البطالة من دون أي استحقاقات (كالرعاية الصحية اللائقة). ويعمل الموظفون بمرتبات (مثلي) من البيت ويحصلون على مرتباتهم كما في السابق، في حين يحلّق المدراء التنفيذيون في الطائرات الخاصة وطائرات الهيليكوبتر.
لطالما جرى تكييف القوى العاملة في معظم أنحاء العالم كي تسلك كذوات نيوليبرالية صالحة (ما يعني إلقاء اللوم على النفس أو الله إذا ما وقع خطبٌ من دون الجرأة على التفكير ولو للحظة بأنَّ الرأسمالية ربما تكون هي الخطب والمشكلة). لكن حتى الذوات النيوليبرالية الصالحة يمكن أن ترى أنَّ ثمَّة خطباً ومشكلة في طريقة الردّ على هذا الوباء.
بقدر ما يُحَدّ من الميل إلى الاستهلاك المفرط الأرعن وغير المنطقي، تكون ثمة بعض الفوائد طويلة الأجل
السؤال الكبير هو: إلى متى سيستمر هذا؟ قد يستغرق هذا أكثر من سنة. وكلما طالت المدة، زاد انخفاض القيمة، بما في ذلك قيمة قوة العمل. وسوف ترتفع مستويات البطالة لتناهز تلك التي سجلتها ثلاثينيات القرن المنصرم بغياب تدخلاتٍ ضخمة من قِبل الدولة لا بدّ أن تتعارض مع روح النيوليبرالية. وتتعدد العواقب المباشرة على الاقتصاد والحياة اليومية، لكنها ليست جميعها سيئة. فبقدر ما يغدو الاستهلاك مفرطاً فإنه يقترب مما وصفه ماركس بـ”الاستهلاك المفرط والاستهلاك المجنون الذي يشير بدوره إلى ما هو وحشي وشاذ، وإلى سقوط النظام ككل”. وتقوم رعونة هذا الاستهلاك المفرط بدور رئيس في التدهور البيئي، في حين تترتب على إلغاء الرحلات الجوية والقيود الجذرية المفروضة على التنقل والحركة عواقب حميدة في ما يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة. وقد غدت نوعية الهواء في ووهان أعلى، وكذلك الأمر في عدة مدن أميركية. وتجد مواقع السياحة البيئية وقتًا لتتعافى من دوس الأقدام. وعاد البجع أيضًا إلى أقنية البندقية. وبقدر ما يُحَدّ من الميل إلى الاستهلاك المفرط الأرعن وغير المنطقي، تكون ثمة بعض الفوائد طويلة الأجل. وانخفاض وفيات من يتسلقون جبل إيفرست هو أمر حسن. وقد ينتهي التحيّز الديمغرافي الذي يبديه الفيروس بالتأثير على الهرم العمري مع تأثيراتٍ طويلة الأجل تطال أعباء الضمان الاجتماعي ومستقبل “صناعة الرعاية”، مع أنَّ أحداً لا يصرّح بهذا. وسوف تتباطأ الحياة اليومية، الأمر الذي سيجد فيه بعضهم نعمة وبركة. وقد تؤدي قواعد التباعد الاجتماعي المقترحة، إذا ما استمرت حالة الطوارئ لفترة كافية، إلى تحولاتٍ ثقافية. والشكل الوحيد من الاستهلاك الذي يكاد يكون مؤكداً أنَّه سوف يفيد من كل هذا هو ما أسميه اقتصاد “النيتفليكس” الذي يلبي احتياجات “المشاهدين المتعطشين” أيًا تكن.
أتت الردود على الصعيد الاقتصادي متأثرة بطريقة الخروج من انهيار 2007-2008. واستلزم هذا في الصين سياسةً نقدية فائقة التيسير مقرونةً بإنقاذ البنوك، وملحقة بزيادة دراماتيكية في الاستهلاك الإنتاجي عبر توسع هائل للاستثمار في البنية التحتية. ولا يمكن تكرار هذا الاستثمار مرةً أخرى بالحجم المطلوب. لقد ركزت حزمة الإنقاذ في عام 2008 على البنوك، لكنها استلزمت أيضًا تأميماً فعلياً لشركة جنرال موتورز. ولعله ذا دلالة أنَّ شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت قد أقفلت[4]، أقلَّهُ لفترةٍ مؤقتة، على خلفية استياء العمال وانهيار طلب السوق.
في حال لم تستطع الصين تكرار دورها في أزمة 2007-2008، عندئذ سينتقل عبء الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة إلى الولايات المتحدة وهنا قمة المفارقة: إذْ أنَّ السياسات الوحيدة الناجعة، على المستويين الاقتصادي والسياسي، أكثر اشتراكية من أي شيء يمكن لبيرني ساندرز أنْ يقترحه، وسوف يكون إطلاق برامج الإنقاذ هذه برعاية دونالد ترامب، خلف قناع إعادة أميركا عظيمة من جديد.
سوف يكون على كلّ أولئك الجمهوريين الذين عارضوا أشد المعارضة إنقاذ عام 2008 أن يقرّوا بهزيمتهم أو يتحدوا دونالد ترامب. وهذا الأخير، إنْ كان حكيمًا، سوف يلغي الانتخابات بدعوى وجود حالة طارئة، ويعلن بداية رئاسة فوق دستورية لإنقاذ رأس المال والعالم من “الشغب والثورة”.
هوامش:
[1] الملك كنيوت هو ملك إنكلترا والدنمارك والنروج، حكم خلال القرن الحادي عشر. وهو بطل قصة شعبية بعنوان “كنيوت العظيم والمدّ” وفيها أنَّه لا حول ولا قوة للإرادة البشرية في مواجهة القدر، ويشبه هذا ما شاع من ترهات إبانّ الظاهرة الحالية تحت مسمى “انتهت حلول الأرض، وبات الأمر متروكاً لحلول السماء” (م).
[2] النزعة الاستخراجية (Extractivism): نمط من أنماط التراكم القائم على استخراج الموارد الطبيعية بنهمٍ من الأرض بهدف تصديرها وبيعها في الأسواق العالمية، وهي تشمل استخراج الذهب والماس والنفط، ولا تقتصر على باطن الأرض بل تشمل كذلك المواد الزراعية والأسماك والأخشاب وغيرها، ويترافق ذلك مع آثار سلبية على المجتمعات المحلية التي يقع أغلبها في الجنوب، وتحقيق أرباحٍ مهولة لشركات الاستخراج وهي بغالبها شركات أجنبية شمالية (م).
[3] الاستهلاك التجريبي (Experiential consumerism): حين يصبح الأفراد أغنى في الدول المتقدمة فإنَّهم يصرفون مبالغ أقل على المنتوجات المادية التي تلبّي احتياجاتهم المادية ويتجهون أكثر للإنفاق على السياحة والترفيه والتعليم، أو على ما يقدم لهم تجربةً جيدة للحياة حيث يستهدف هذا النوع من الاستهلاك المشاعر والجانب المعنوي من الفرد (م).
[4] الثلاثة الكبار في عالم صناعة السيارات في أميركاهم جنرال موتورز وفورد وكرايسلر ومقرهم جميعًا مدينة ديترويت (م).
:::::
موقع "أوان"، نُشِر هذا المقال في مجلة “جاكوبين” بتاريخ 20 آذار/مارس 2020
ديفيد هارفي
ترجمة علاء بريك هنيدي
في حال لم تستطع الصين تكرار دورها في أزمة 2007-2008، عندئذ سينتقل عبء الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة إلى الولايات المتحدة وهنا قمة المفارقة: إذْ أنَّ السياسات الوحيدة الناجعة، على المستويين الاقتصادي والسياسي، أكثر اشتراكية من أي شيء يمكن لبيرني ساندرز أنْ يقترحه، وسوف يكون إطلاق برامج الإنقاذ هذه برعاية دونالد ترامب، خلف قناع إعادة أميركا عظيمة من جديد
أميلُ، عند محاولتي تفسير سيل الأخبار اليومي وفهمه وتحليله، إلى وضع ما يجري على خلفية نموذجَيْن متمايزَيْن لكنهما متقاطعان لكيفيّة عمل الرأسمالية. يقوم النموذج الأول على رسم خريطة للتناقضات الداخلية لتداول رأس المال وتراكمه بوصفه تدفقات للقيمة النقدية تسعى وراء الربح خلال “اللحظات” (كما يسميها ماركس) المختلفة للإنتاج والتحقيق (الاستهلاك) والتوزيع وإعادة الاستثمار. هذا نموذجٌ للاقتصاد الرأسمالي باعتباره توسعًا ونموًا لَولَبييّن متصاعدين لانهائيين. وهو نموذج يصبح غايةً في التعقيد إذ يُحْكَم مزيداً من الإحكام عبر التنافسات الجيوسياسية والتطور الجغرافي اللامتكافئ، والمؤسسات المالية، وسياسة الدولة، والانقلابات التكنولوجية، والشبكة المتغيرة أبدًا لتقسيم العمل والعلاقات الاجتماعية، على سبيل المثال لا الحصر.
غير أنّي أرى إلى هذا النموذج على أنّه جزءٌ من سياقٍ أكبر من إعادة الإنتاج الاجتماعي (في الأُسر والجماعات)، ومن علاقةٍ مستمرة ومتطورة مع الطبيعة (بما فيها “الطبيعة الثانية” للتمدُّن “urbanization” والبيئة المَبنيّة) وكافة صنوف التشكيلات الثقافية والعلمية (المعرفية) والدينية والطارئة التي يخلقها الاجتماع البشري عبر المكان والزمان. وتدمج هذه “اللحظاتُ” الأخيرة التعبيرَ الفاعل عن المطالب والحاجات والرغبات البشرية وشهوة المعرفة والمعنى والسعي النامي وراء التحقق والإنجاز على خلفية متغيرة من الترتيبات المؤسسية والمنازعات السياسية والمواجهات الأيديولوجية والخسارات والهزائم والإحباطات وصنوف الاغتراب، تجري جميعًا في عالمٍ موسوم بالتنوع الجغرافي والثقافي والاجتماعي والسياسي. وهذا هو النموذج الثاني الذي يشكّل، إذا جاز التعبير، فهميَ العملي للرأسمالية العالمية بوصفها تشكيلةً اجتماعية متمايزة، في حين يتعلق النموذج الأول بالتناقضات ضمن المحرّك الاقتصادي الذي يحرِّك هذه التشكيلة الاجتماعية على مساراتٍ محددة لتطورها التاريخي والجغرافي.
التصاعد اللولبي
حين قرأت في 26 كانون الثاني/يناير 2020 لأول مرة عن فيروس كورونا، الآخذ في الانتشار في الصين، فكرتُ على الفور في انعكاسات ذلك على الديناميكيات العالمية لتراكم رأس المال. إذْ أعلمُ من دراستي للنموذج الاقتصادي بأنَّ الانسدادات والانقاطاعات في استمرارية تدفق رأس المال ستؤدي إلى انخفاضٍ في القيمة “Devaluation”، وإذا ما عمَّ انخفاض القيمة وتعمَّق، فإنَّ ذلك يؤشر على بداية أزمة. وكنت أدرك كذلك بأنَّ الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأنَّها أنقذت الرأسمالية العالمية عقب أحداث 2007-2008، ولذلك فإنّ أيّ ضربة للاقتصاد الصيني ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي الذي يمر أصلًا بوضعٍ خطر. وبدا لي أنَّ النموذج الحالي لتراكم رأس المال يواجه مشكلات جمّة أصلاً. وثمة احتجاجات شعبية في كل مكان تقريبًا (من سانتياغو إلى بيروت) يتركَّز كثير منها على أنَّ النموذج الاقتصادي السائد لا يخدم جمهرة الشعب. إذْ يتكئ هذا النموذج النيوليبرالي بصورة متزايدة على رأس مال وهمي وعلى توسّع مهول في المعروض النقدي وخلق الديون. وهو يواجه أصلاً مشكلة عدم كفاية الطلب الفعال كي يُحقِّق القيم التي يمكن لرأس المال إنتاجها. وعليه، كيف يمكن لهذا النموذج الاقتصادي السائد، بشرعيته الهابطة وصحته المُعتَلّة، أنْ يستوعب الآثار المحتَّمة لما قد يتحوَّل إلى وباء وينجو منه؟ يتوقف الجواب على طول الانقطاع ومدى انتشاره، فانخفاض القيمة، كما أشار ماركس، لا يقع بسبب عدم القدرة على بيع السلع بل بسبب عدم بيعها في الوقت المناسب.
لطالما رفضتُ فكرة “الطبيعة” بوصفها خارج الثقافة والاقتصاد والحياة اليومية ومفصولةً عنها. وأنا أتبنى رؤية أكثر ديالكتيكية وعلائقية للعلاقة الأيضية مع الطبيعة. صحيحٌ أنَّ رأس المال يعدّل ظروف إعادة إنتاجه البيئية، لكنه يفعل ذلك في سياقٍ من النتائج غير المقصودة (كالتغيُّر المناخي)، وعلى خلفية قوىً تطورية مستقلة وحرة لا تني تُعيد تشكيل الظروف البيئية. ومن هذا المنطلق، ليس ثمَّة ما ندعوه بكارثة طبيعية بالمعنى الخالص للكلمة. لا شكّ أنَّ الفيروسات تخضع لطفرات طوال الوقت، لكن الظروف التي تغدو فيها طفرة من الطفرات مهددة للحياة تتوقف على أفعال البشر.
الآثار الاقتصادية والسكانية لانتشار الفيروس تتوقف على ما يوجد سلفًا من صدوع ونقاط ضعف في النموذج الاقتصادي المهيمن
ثمَّة جانبان مترابطان لهذا الأمر. أولهما، هو أنَّ الظروف البيئية المواتية تزيد من احتمال الطفرات الشديدة. فمن المعقول أن نتوقع، مثلاً، أن تكون لمنظومات الإمداد الغذائي المكثَّفة والمنفلتة في المناطق شبه الاستوائية الرطبة مساهمتها في مثل هذه الطفرات. توجد مثل هذه المنظومات في أماكن عدة، من بينها الصين جنوب يانغتسي وجنوب شرق آسيا. وثانيهما، هو أنَّ الظروف التي تحفِّز الانتقال السريع عبر الأجسام المُضيفة تتباين أشدّ التباين. ويبدو أنَّ التجمعات السكانية المكتظة هي هدف مضيف سهل. ومن المعروف مثلاً أنَّ جائحات الحصبة تنتشر في المراكز السكانية الكبيرة في حين تهمد بسرعة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. ولكيفية تفاعل الناس مع بعضهم بعضاً وانتقالهم وانضباطهم أو نسيانهم غسل أيديهم تأثيرٌ على كيفية انتقال الأمراض. وفي الآونة الأخيرة، يبدو أنَّ “السارس” وإنفلونزا الطيور والخنازير قد أتتنا من الصين وجنوب شرق آسيا. وقد عانت الصين كثيرًا من حمى الخنازير في العام الفائت، ما استلزم ذبح عدد كبير من الخنازير وارتفاعًا في أسعار لحمها. لا أقول هذا لأُدينَ الصين. إذْ ثمَّة أماكن كثيرة أخرى تعلو فيها المخاطر البيئية للطفرات الفيروسية وانتشارها. وربما تكون “الإنفلونزا الإسبانية” عام 1918 قد أتت من كانساس، وربما احتضنت أفريقيا فيروس “الإيدز”، وانطلق منها “فيروس غرب النيل” و”الإيبولا”، في حين يبدو أنَّ “حمى الضنك” قد انتشرت من أميركا اللاتينية. لكن الآثار الاقتصادية والسكانية لانتشار الفيروس تتوقف على ما يوجد سلفًا من صدوع ونقاط ضعف في النموذج الاقتصادي المهيمن.
لم يُفاجئني أنَّ “الكوفيد-19” وُجِدَ بدايةً في ووهان (على الرغم من عدم معرفتنا إنْ كان قد نشأ هناك). ومن الواضح أنَّ التأثيرات المحلية ستكون كبيرة. وبالنظر إلى أنَّ ووهان مركز إنتاجي مهم فمن المرجح أنْ تكون ثمَّة انعكاسات اقتصادية عالمية (وإن لم تكن لدي أيّ فكرة عن حجم هذه الانعكاسات). كان السؤال الكبير كيف يمكن أنْ تقع العدوى وتنتشر وكم ستدوم (إلى حين إيجاد لقاحٍ ما). أظهرت الخبرة السابقة أنَّ إحدى المآخذ على العولمة المتزايدة هي مدى استحالة إيقاف الانتشار العالمي السريع لأمراضٍ جديدة. إذْ نعيش في عالمٍ شديد الترابط حيث تسافر أغلبيتنا الساحقة. والشبكات البشرية لانتشار الفيروس المحتمَل هي شبكات شاسعة ومفتوحة. ويتمثّل الخطر (الاقتصادي والسكاني) في أنَّ هذا الانقطاع قد يدوم سنة أو أكثر.
في حين كان هناك تراجع فوري في أسواق الأسهم العالمية عند اندلاع الأخبار الأولى، إلَّا أنَّه أعقبها شهرٌ أو أكثر ضربت فيه الأسواق، بشكلٍ مفاجئ، مستوياتٍ قياسية جديدة. وبدا أنَّ الأخبار تؤشِّر إلى أنَّ الأعمال التجارية تجري كالمعتاد في كل مكان باستثناء الصين. وساد الاعتقاد بأنَّنا على أعتاب موجةٍ جديدة من “السارس” الذي تبيّن أنَّ من الممكن احتواءه بسرعة وليس له ذلك التأثير العالمي الكبير على الرغم من ارتفاع معدل وفياته وخلقهِ حالةً غير ضرورية (عند التفكير في ذلك الآن) من الهلع في الأسواق المالية. حين ظهر “الكوفيد-19″، كانت ردة الفعل السائدة تصويره كعودة لـ”السارس”، ما جعل حالة الهلع غير ضرورية وزائدة. كما أدّت حقيقة حلول الوباء في الصين التي تحركت بسرعة وبلا هوادة لاحتواء تأثيراته، إلى تعامل بقية العالم مع المشكلة على نحوٍ خاطئ بوصفها شيئًا يجري هناك “بعيداً” عن الأنظار والبال (وترافق ذلك مع بعض علائم مُقلِقَة على رهاب أجانب “xenophobia” معادٍ للصين في مناطق معينة من العالم). بل إنَّ دوائر معينة في إدارة ترامب احتفت بالخنجر الذي يغرسه الفيروس في القصة المُظفَّرة للنمو الصيني.
بدا تخفيض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة لمواجهة الفيروس أمرًا لافتاً، حتى حين أُقِرَّ بأنَّ هذه الحركة هدفت إلى التخفيف من التأثير على السوق وليس الوقوف في وجه تقدم الفيروس
لكنَّ قصص الانقطاع في سلاسل الإنتاج العالمية التي تعبر ووهان بدأت تنتشر. وجرى إلى حد بعيد تجاهل هذه القصص أو معالجتها على أنَّها مشاكل مرتبطة بخطوط إنتاج أو شركات بعينها (مثل “آبل”). كانت انخفاضات القيمة محلية ومحددة ولم تكن شاملة. كما جرى التقليل من شأن المؤشرات على انخفاض الطلب الاستهلاكي، على الرغم من اضطرار شركات ذات أعمال كبرى في السوق المحلي الصيني، مثل “مكدونالدز” و”ستاربكس”، إلى إغلاق أبوابها هناك لفترة من الوقت. لقد أخفى تداخل رأس السنة الصينية وتفشي الفيروس تلك التأثيرات طيلة يناير/كانون الثاني. وكان التساهل في الردّ غير موفقٍ وفي غير محله.
كانت الأخبار الأولى عن الانتشار العالمي للفيروس عرضية ومتفرقة مع تفشٍ خطير في كوريا الجنوبية وبعض البؤر الأخرى مثل إيران. وكان تفشيه في إيطاليا ما أثار أول ردة فعلٍ قوية. وتذبذب انهيار أسواق الأسهم الذي بدأ في منتصف شباط/فبراير بعض التذبذب لكنه أدّى بحلول منتصف آذار/مارس إلى انخفاضٍ صافٍ في القيمة يناهز الـ30% في أسواق الأسهم حول العالم.
أثار انتشار العدوى بمتوالية هندسية طيفاً من ردود الفعل غير المُتسِقة والمتسمة بالهلع في بعض الأحيان. قلَّد الرئيس ترامب الملك كَنيوت[1] في مواجهة مدّ الإصابات والوفيات المحتمل. وكانت بعض ردود الفعل شديدة الغرابة. وبدا تخفيض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة لمواجهة الفيروس أمرًا لافتاً، حتى حين أُقِرَّ بأنَّ هذه الحركة هدفت إلى التخفيف من التأثير على السوق وليس الوقوف في وجه تقدم الفيروس.
تبيّن أنَّ السلطات العامة ومنظومات الرعاية الصحية في كل مكان تقريبًا تعاني من نقصٍ في الأيدي العاملة. لقد عمل أربعون عامًا من النيوليبرالية في الأمريكيتين وأوروبا على ترك البشر مكشوفين تماماً وغير مهيئين لمواجهة أزمة صحية كهذه، مع أنَّ المخاوف السابقة من “السارس” و”الإيبولا” كانت قد أطلقت تحذيرات كثيرة ودروساً مُفحِمة حول ما يجب القيام به. وفي بقاعٍ عديدة من العالم الذي يُفترَض أنّه “متحضر”، كانت الحكومات المحلية وسلطات الدول والسلطات الإقليمية التي تشكل على الدوام خط الدفاع الأول في مجال الصحة العامة وحالات الطوارئ من هذا النوع، محرومة من التمويل بفعل سياسة التقشف الهادفة لخفض الاقتطاعات الضريبية وتقديم الإعانات للشركات والأغنياء.
ليس لدى شركات الدواء الكبرى بيغ فارما “Big Pharma” سوى القليل من الاهتمام بالبحث غير المجزي حول الأمراض المعدية (كتلك التي تسببها فئة كاملة من فيروسات الكورونا المعروفة منذ ستينيات القرن العشرين)، هذا إن كان لديها أيُّ اهتمامٍ بذلك. وقلما تستثمر هذه الشركة في أمور الوقاية. وليس لديها سوى اهتمام ضئيل بالاستثمار في مجال الاستعداد لمواجهة أزمة صحية عامة. وهي مغرمة بتقديم العلاجات. وكلما مرضنا أكثر، كسبت أكثر. أمّا الوقاية فلا تسهم في زيادة قيمة الأسهم. لقد تخلَّص نموذج البزنس المُطبَّق على الصحة العامة من قدرات المواجهة الفائضة التي تكون مطلوبة في أوقات الطوارئ. ولم تشكل الوقاية حتى ذلك المجال الجذاب بما يكفي لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد قلَّص الرئيس ترامب ميزانية مركز مكافحة الأمراض (Center for Disease Control) وحلَّ فريق العمل المعني بالأوبئة في مجلس الأمن القومي بنفس الروح التي أوقف بها كل تمويل للبحث العلمي، بما في ذلك البحث المتعلّق بالتغير المناخي. ولو أردتُ أنْ أكون من المشبّهة في ما يتصل بهذا الأمر أو أستخدم الاستعارة حياله لقلت إنَّ كوفيد-19 هو انتقام الطبيعة إزاء أكثر من 40 سنة من سوء معاملتها الجسيمة والمتعسفة من قِبَل نزعة استخراجية[2] نيوليبرالية متوحشة ومنفلتة من كل عقال.
ما كان مميزًا في الصين هو حصر الوباء في مقاطعة هوبي ومركزها ووهان، فلم ينتقل الوباء إلى بكين أو إلى الغرب أو حتى نحو الجنوب
لعلّه ذا مغزى أنَّ الدول الأقلّ نيوليبرالية، كالصين وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، واجهت الوباء بشكلٍ أفضل حتى الآن مقارنة بإيطاليا، على الرغم من أنَّ إيران تُشكِّل طعنًا في هذه الحجة بوصفها مبدأً عامًا. وفي حين كان ثمَّة كثير من الأدلة على أنَّ الصين تعاملت مع “السارس” على نحوٍ بالغ السوء وبقدر كبير من الإخفاء والإنكار في أول الأمر، إلَّا أنَّ الرئيس شي [جين بينغ] تحرك بسرعة هذه المرة لتبني الشفافية في الإخبار والاختبار على السواء، كما فعلت كوريا الجنوبية. ومع ذلك، فقد ضاع بعض الوقت الثمين في الصين (إذْ تُحدِثُ بضع أيام فحسب فارقًا كبيرًا). لكنّ ما كان مميزًا في الصين هو حصر الوباء في مقاطعة هوبي ومركزها ووهان. فلم ينتقل الوباء إلى بكين أو إلى الغرب أو حتى نحو الجنوب. وكانت الإجراءات المتخذة لحصر الفيروس جغرافيًا شديدة القسوة. وسوف يكون من المتعذر تكرارها في أماكن أخرى لأسبابٍ سياسية واقتصادية وثقافية. وتشير التقارير القادمة من الصين إلى أنَّ العلاجات والسياسات لم تكن لتمتّ إلى الرعاية بصلة. بل إنَّ الصين وسنغافورة استخدمتا قدرتيهما على الرقابة الشخصية بدرجات عدوانية وسلطوية. ولكن يبدو أنَّها كانت فعالة في المجمل، على الرغم من أنَّه لو بُدِءَ بالإجراءات المضادة قبل أيام قليلة فحسب لأمكن تفادي كثير من الوفيات. هذه معلومة مهمة: في أيّ نمو بمتوالية هندسية، ثمَّة نقطة انعطاف يخرج بعدها التزايد عن السيطرة كلّ الخروج (لاحظوا هنا، مرةً أخرى، أهمية مقدار التزايد بالنسبة إلى المعدل). وربما يُثبت تبديد ترامب أسابيع عديدة أنه باهظ الكلفة في ما يزهقه من أرواح بشرية.
تتصاعد الآثار الاقتصادية الآن خارجةً عن السيطرة داخل الصين وخارجها على السواء. وباتت الانقطاعات في سلاسل القيمة في الشركات وفي قطاعات بعينها أشمل وأفدح مما اعتُقد في البداية. وقد يتمثّل الأثر طويل الأجل بتقصير سلاسل العرض أو تنويعها مع الانتقال صوب أشكال من الإنتاج أقل كثافة من ناحية العمل (مع تداعياتٍ هائلة على العمالة) واعتماد أكبر على منظومات الذكاء الصناعي الإنتاجية. ويستتبع انقطاع سلاسل الإنتاج تسريح العمال أو إعطائهم إجازات كيفما اتفق، ما يقلل الطلب النهائي، في حين يقلل الطلبُ على المواد الأولية الاستهلاكَ الإنتاجي. وبدورها فإنَّ هذه الآثار على الطلب لا بد أن تؤدي إلى ركودٍ متوسط على الأقلّ.
لقد تعطل ميدان التراكم هذا بالكامل: شركات الطيران على شفا الإفلاس والفنادق خاوية
لكن أكبر نقاط الضعف هي في مكانٍ آخر. لقد انهارت أنماط الاستهلاك التي انفجرت عقب أزمة 2007-2008 مخلفةً عواقب مدمرة. وتستند هذه الأنماط إلى اختزال دورة الاستهلاك أو زمن تجدده إلى الصفر ما أمكن. ويرتبط تدفق الاستثمارات إلى هذه الأشكال من الاستهلاك كلّ الارتباط بالامتصاص الأقصى لمقادير من رأس المال متزايدة بمتوالية هندسية في أشكال الاستهلاك التي تتسم بأقصر دورة ممكنة. ومن الأمثلة على ذلك السياحة الدولية. إذْ ازدادت الزيارات الدولية من 800 مليون إلى 1.4 مليار بين عامَيْ 2010 و2018. ويتطلب مثل هذا الشكل من الاستهلاك الآني استثماراتٍ ضخمة في البنية التحتية للمطارات وخطوط الطيران والفنادق والمطاعم والمنتزهات والأنشطة الثقافية، إلخ. لقد تعطل ميدان التراكم هذا بالكامل: شركات الطيران على شفا الإفلاس، والفنادق خاوية، والبطالة الجماعية في صناعات الضيافة والسياحة مهولة. ولم يَعُد تناول الطعام في الخارج فكرةً حسنة، وأقفلت المطاعم والبارات في عدة أماكن. حتى طلب الوجبات الجاهزة يبدو خطرًا. ويجري تسريحُ الجيش الضخم من عمال الاقتصاد التعاقدي الحرّ أو في حقولٍ أخرى من الأعمال غير الثابتة، بلا أي وسائل دعم منظورة. وألغيت الأنشطة والمناسبات، كالمهرجانات الثقافية وبطولات كرة القدم والسلة والحفلات الموسيقية والمؤتمرات التجارية والمهنية بل وحتى التجمعات السياسية الخاصة بالانتخابات. لقد أُوقفت هذه الأشكال “المناسباتية” من الاستهلاك التجريبي[3]. وتراجعت عوائد الحكومات المحلية. وأغلِقَت المدارس والجامعات.
لقد تعطل مقدار كبير من نموذج الاستهلاك الرأسمالي المعاصر والعصري في ظل الظروف الحالية. وضعُف ما يصفه أندريه غورز بـ”الاستهلاك التعويضي” (حيث يُفترَض أنْ يستعيد العمال المستَلبون معنوياتهم من خلال إجازةٍ على شاطئ استوائي).
لكن الاستهلاك يدفع 70% أو حتى 80% من الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة. وغدت ثقة المستهلك وعاطفته مفتاح تعبئة الطلب الفعال خلال العقود الأربعة الماضية، وصار رأس المال مدفوعًا بالطلب والحاجات على نحو متزايد. ولم يتعرض هذا المصدر من مصادر الطاقة الاقتصادية لتقلباتٍ كبيرة (مع استثناءات قليلة، كتوقف الرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي لأسبوعين جراء ثوران البركان [إيافيالايوكل] الآيسلندي). إلّا أنَّ “كوفيد-19” لم يُثِر تقلباتٍ كبيرة بل انهيارًا جسيمًا في صلب الاستهلاك السائد في البلدان الأكثر ثراءً. وينهار شكل التراكم الرأسمالي اللولبي المتصاعد اللامتناهي في بقعة تلو أخرى من العالم. والشيء الوحيد الذي يمكنه إنقاذه هو استهلاك جماهيري مموَّل ومُلهَم حكومياً مُستَمَد من العدم. وهذا يتطلب تأميم الاقتصاد الأميركي كلّه، على سبيل المثال، من دون تسمية ذلك بالاشتراكية.
الخطوط الأمامية
ثمَّة أسطورة مُقنِعة تقول إنَّ الأمراض المُعدية لا تعترف بالحواجز والحدود الطبقية أو سواها من الحواجز والحدود الاجتماعية. وكما في كثير من مثل هذه الأقوال، ثمَّة بعض الحقيقة في هذا القول. فخلال وباء الكوليرا في القرن التاسع عشر، كان تخطي الحواجز الطبقية من الشدّة إلى درجة دفعت إلى ولادة حركة الصرف الصحي والصحة العامة التي غدت ذات طابع مهني واستمرت حتى يومنا هذا. وليس واضحًا على الدوام ما إذا كانت هذه الحركة قد استهدفَت حماية الجميع أم الاقتصار على الطبقات العليا. أمّا اليوم فتخبرنا التأثيرات والآثار الطبقية والاجتماعية المتباينة قصةً مختلفة. ذلك أنَّ التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية ترشح عبر ضروب من التمييز “المعتاد” واضحة في كلّ مكان. بادئ ذي بدء، فإنَّ القوة العاملة المنوط بها رعاية الأعداد المتزايدة من المرضى عادةً ما تكون ذات طابع جندري، وعرقي، وإثني، في أغلب بقاع العالم. وتناظر هذه القوة تلك القوة القائمة على أساس طبقي العاملة في المطارات أو غيرها من القطاعات اللوجستية، على سبيل المثال.
تقف هذه “الطبقة العاملة الجديدة” في المقدمة وتحمل عبء أن تكون قوة العمل الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس بحكم عملها، أو تُسرَّح من دون أي موارد بسبب الانكماش الاقتصادي الذي يفرضه الفيروس. ثمَّة تساؤل، مثلاً، عمَّن يمكنه العمل من المنزل ومَن لا يمكنه. وهذا يزيد من حِدّة الانقسام المجتمعي مثلما يزيد التساؤل عمَّن يسعه أن يتحمّل العزل أو الحَجْر (بأجر أو من دونه) في حال التماس أو الإصابة. ومثلما تعلمتُ أنْ أُسميَ زلازل نيكاراغوا (1973) ومكسيكو سيتي (1995) “زلازل طبقية”، كذلك يبدي مسار الكوفيد-19 جميع خصائص الوباء الجندري والطبقيّ والعرقي. وفي حين تُغطى جهود الكبح ببلاغة مفادها أنّنا “جميعًا في المركب ذاته”، تشير الممارسات، لا سيما من طرف الحكومات الوطنية، تشيرُ إلى دوافع أكثر خبثًا. إذْ تواجه الطبقة العاملة في الولايات المتحدة (المكونة في الغالب من أميركيين من أصل أفريقي ولاتيني ونساء عاملات بأجر) خيارَيْن أحلاهما مُرّ، فإما العدوى باسم الرعاية وإبقاء مهن رئيسة (كمحلات البقالة) مفتوحةً، أو البطالة من دون أي استحقاقات (كالرعاية الصحية اللائقة). ويعمل الموظفون بمرتبات (مثلي) من البيت ويحصلون على مرتباتهم كما في السابق، في حين يحلّق المدراء التنفيذيون في الطائرات الخاصة وطائرات الهيليكوبتر.
لطالما جرى تكييف القوى العاملة في معظم أنحاء العالم كي تسلك كذوات نيوليبرالية صالحة (ما يعني إلقاء اللوم على النفس أو الله إذا ما وقع خطبٌ من دون الجرأة على التفكير ولو للحظة بأنَّ الرأسمالية ربما تكون هي الخطب والمشكلة). لكن حتى الذوات النيوليبرالية الصالحة يمكن أن ترى أنَّ ثمَّة خطباً ومشكلة في طريقة الردّ على هذا الوباء.
بقدر ما يُحَدّ من الميل إلى الاستهلاك المفرط الأرعن وغير المنطقي، تكون ثمة بعض الفوائد طويلة الأجل
السؤال الكبير هو: إلى متى سيستمر هذا؟ قد يستغرق هذا أكثر من سنة. وكلما طالت المدة، زاد انخفاض القيمة، بما في ذلك قيمة قوة العمل. وسوف ترتفع مستويات البطالة لتناهز تلك التي سجلتها ثلاثينيات القرن المنصرم بغياب تدخلاتٍ ضخمة من قِبل الدولة لا بدّ أن تتعارض مع روح النيوليبرالية. وتتعدد العواقب المباشرة على الاقتصاد والحياة اليومية، لكنها ليست جميعها سيئة. فبقدر ما يغدو الاستهلاك مفرطاً فإنه يقترب مما وصفه ماركس بـ”الاستهلاك المفرط والاستهلاك المجنون الذي يشير بدوره إلى ما هو وحشي وشاذ، وإلى سقوط النظام ككل”. وتقوم رعونة هذا الاستهلاك المفرط بدور رئيس في التدهور البيئي، في حين تترتب على إلغاء الرحلات الجوية والقيود الجذرية المفروضة على التنقل والحركة عواقب حميدة في ما يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة. وقد غدت نوعية الهواء في ووهان أعلى، وكذلك الأمر في عدة مدن أميركية. وتجد مواقع السياحة البيئية وقتًا لتتعافى من دوس الأقدام. وعاد البجع أيضًا إلى أقنية البندقية. وبقدر ما يُحَدّ من الميل إلى الاستهلاك المفرط الأرعن وغير المنطقي، تكون ثمة بعض الفوائد طويلة الأجل. وانخفاض وفيات من يتسلقون جبل إيفرست هو أمر حسن. وقد ينتهي التحيّز الديمغرافي الذي يبديه الفيروس بالتأثير على الهرم العمري مع تأثيراتٍ طويلة الأجل تطال أعباء الضمان الاجتماعي ومستقبل “صناعة الرعاية”، مع أنَّ أحداً لا يصرّح بهذا. وسوف تتباطأ الحياة اليومية، الأمر الذي سيجد فيه بعضهم نعمة وبركة. وقد تؤدي قواعد التباعد الاجتماعي المقترحة، إذا ما استمرت حالة الطوارئ لفترة كافية، إلى تحولاتٍ ثقافية. والشكل الوحيد من الاستهلاك الذي يكاد يكون مؤكداً أنَّه سوف يفيد من كل هذا هو ما أسميه اقتصاد “النيتفليكس” الذي يلبي احتياجات “المشاهدين المتعطشين” أيًا تكن.
أتت الردود على الصعيد الاقتصادي متأثرة بطريقة الخروج من انهيار 2007-2008. واستلزم هذا في الصين سياسةً نقدية فائقة التيسير مقرونةً بإنقاذ البنوك، وملحقة بزيادة دراماتيكية في الاستهلاك الإنتاجي عبر توسع هائل للاستثمار في البنية التحتية. ولا يمكن تكرار هذا الاستثمار مرةً أخرى بالحجم المطلوب. لقد ركزت حزمة الإنقاذ في عام 2008 على البنوك، لكنها استلزمت أيضًا تأميماً فعلياً لشركة جنرال موتورز. ولعله ذا دلالة أنَّ شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت قد أقفلت[4]، أقلَّهُ لفترةٍ مؤقتة، على خلفية استياء العمال وانهيار طلب السوق.
في حال لم تستطع الصين تكرار دورها في أزمة 2007-2008، عندئذ سينتقل عبء الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة إلى الولايات المتحدة وهنا قمة المفارقة: إذْ أنَّ السياسات الوحيدة الناجعة، على المستويين الاقتصادي والسياسي، أكثر اشتراكية من أي شيء يمكن لبيرني ساندرز أنْ يقترحه، وسوف يكون إطلاق برامج الإنقاذ هذه برعاية دونالد ترامب، خلف قناع إعادة أميركا عظيمة من جديد.
سوف يكون على كلّ أولئك الجمهوريين الذين عارضوا أشد المعارضة إنقاذ عام 2008 أن يقرّوا بهزيمتهم أو يتحدوا دونالد ترامب. وهذا الأخير، إنْ كان حكيمًا، سوف يلغي الانتخابات بدعوى وجود حالة طارئة، ويعلن بداية رئاسة فوق دستورية لإنقاذ رأس المال والعالم من “الشغب والثورة”.
هوامش:
[1] الملك كنيوت هو ملك إنكلترا والدنمارك والنروج، حكم خلال القرن الحادي عشر. وهو بطل قصة شعبية بعنوان “كنيوت العظيم والمدّ” وفيها أنَّه لا حول ولا قوة للإرادة البشرية في مواجهة القدر، ويشبه هذا ما شاع من ترهات إبانّ الظاهرة الحالية تحت مسمى “انتهت حلول الأرض، وبات الأمر متروكاً لحلول السماء” (م).
[2] النزعة الاستخراجية (Extractivism): نمط من أنماط التراكم القائم على استخراج الموارد الطبيعية بنهمٍ من الأرض بهدف تصديرها وبيعها في الأسواق العالمية، وهي تشمل استخراج الذهب والماس والنفط، ولا تقتصر على باطن الأرض بل تشمل كذلك المواد الزراعية والأسماك والأخشاب وغيرها، ويترافق ذلك مع آثار سلبية على المجتمعات المحلية التي يقع أغلبها في الجنوب، وتحقيق أرباحٍ مهولة لشركات الاستخراج وهي بغالبها شركات أجنبية شمالية (م).
[3] الاستهلاك التجريبي (Experiential consumerism): حين يصبح الأفراد أغنى في الدول المتقدمة فإنَّهم يصرفون مبالغ أقل على المنتوجات المادية التي تلبّي احتياجاتهم المادية ويتجهون أكثر للإنفاق على السياحة والترفيه والتعليم، أو على ما يقدم لهم تجربةً جيدة للحياة حيث يستهدف هذا النوع من الاستهلاك المشاعر والجانب المعنوي من الفرد (م).
[4] الثلاثة الكبار في عالم صناعة السيارات في أميركاهم جنرال موتورز وفورد وكرايسلر ومقرهم جميعًا مدينة ديترويت (م).
:::::
موقع "أوان"، نُشِر هذا المقال في مجلة “جاكوبين” بتاريخ 20 آذار/مارس 2020
 Hitskin.com
Hitskin.com