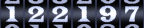شبكات التواصل "الإجتماعي" في الوطن العربي
أدوات الإستعمار الثقافي
الطاهر المعز
قُدِّرَ (بنهاية سنة 2016) عدد مستخدمي الإنترنت في العالم بنحو أربعة مليارات شخص، أو نحو 60% من سكان العالم آنذاك، وفي سنة 2017، قُدِّرَ عدد المُستخدمين "النّشطين" لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحوالي ملياري شخص شهريا (300 ألف مُشاركة في النقاشات، كل دقيقة)، و يقضون حوالي خمسة مليارات دقيقة على موقع "فيسبوك"، ويرسل مستخدمو البريد الإلكتروني نحو ثلاثمائة مليار رسالة بريد إلكتروني، مع تنزيل 35 مليون تطبيق، كل دقيقة، ويُشارك نحو مليار مستخدم في موقع "يوتوب"، كل دقيقة أيضًا، ويتردد على موقع "واتساب" نحو 950 مليونًا، و440 مليونًا على "غوغل"، و430 مليونًا على "إنستغرام"، و420 مليونًا على "لينكدإن"، و325 مليونًا على "تويتر"، و230 مليونًا على "تمبلر"، و110 ملايين على "بينتريست"، وتمر عبر البريد الإلكتروني، نحو 204 مليون رسالة إلكترونية، كل دقيقة...
وتَتَبّعُ الشركات التي تُدير هذه المواقع، حركات وسكنات المستخدمين، ومُحتوى ما يتبادلونه من المواد، خلال اتصالاتهم عبر "سكايب"، وتغريداتهم عبر "تويتر" (حوالي 600 ألف كل دقيقة)، ونَشْر الصّوَر، وغير ذلك من المعلومات المهمة التي تمثل كَنْزًا، وتستخدمها شركات التجارة والإشهار والمخابرات ووسائل الإعلام ومراكز البحوث والدّراسات، بهدف التّسويق، كما التوجيه العقائدي (الإيديولوجي) للرأي العام، حيث لم يقتصر دور وسائل التواصل الاجتماعي على التواصل بين الأصدقاء وأفراد العائلة، والأصدقاء الإفتراضيين، بل أصبحت هذه الوسائل محل دراسات وبحوث علمية، للتأثير في عُقول الناس، وخاصة الشباب الذين وُلِدُوا مع هذه الأدوات، ولم يعرفوا الرسائل البريدية والبطاقات المُرسَلَة خلال العُطَل والمُناسبات، وغيرها، واستغلت السُّلطات السّياسية والأحزاب وأجهزة الإستخبارات هذه الأدوات لتوجيه الرأي العام، ولِبَثِّ الأفكار التي تُريد إيصالها، للفئة التي تختارها من مواطني العالم، وكلما عَلَتْ مكانة الجهة التي تبث الدعاية، تضخّمت ميزانياتها وإمكاناتها، وكان تأثيرها أكبر في عقول النّاس، وفي تشكيل وَعْيِهِم، ما يطرح العديد من التّساؤلات حول أمن واستقرار البُلدان المُسمّاة "نامية"، أو التي تستهدفها دعاية الإستخبارات الإمبريالية، أو الصهيونية، بالنسبة لنا كعرب...
قُدِّرَ عدد مستخدمي وسائل التواصل "الإجتماعي"، بنحو 3,5 مليارات شخص، سنة 2019، من بينهم أكثر من 136 مليون مواطن عربي، لفترة لا تقل عن تسعين دقيقة، لكلّ منهم، يوميًّا، ويرتفع عدد ساعات استخدام هذه الوسائل إلى أكثر من أربع ساعات في السعودية، سنة 2019، بحسب دراسة نشرتها مؤسسة "هوتسويت" (كندا)، وتستغل الشركات العابرة للقارات، من مختلف القطاعات، هذه الفترة الزمنية لتسويق منتجاتها، فيما تستغل أجهزة أخرى، هذا الحيّز الزّمني لبث سُمُوم أخرى، تتعلق ببثّ فكرة سلبية عن حضارتنا وثقافتنا وتاريخنا، وتمجيد "مزايا ومحاسن" الإستعمار والصهيونية، بعنوان "التطور والتّقدّم"، من خلال تسريب ثقافة التطبيع، بدل ثقافة المُقاوَمة، باسم "التّسامح، وقُبُول الآخر"، حتى إذا كان "الآخر" مُستَعْمِرًا، يستوطن البلاد بقوة السلاح، ويُطرد أصحاب الوطن الشرعيين...
قدّرت شركات التواصل "الإجتماعي" عدد مواقع التواصل بنحو 1,7 مليار موقع، وخمسمائة مليون مدونة، وينشُرُ المُستخدمون حوالي سبعين مليون منشور وحوالي سبعة وسبعين مليون تعليق، شهريا، ويشاهد أكثر من 409 ملايين شخص ما يزيد عن عشرين مليار صفحة تدوين شهريا، تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
وسائل تخريب الوعي:
بَرَعت مراكز دراسات وبُحوث الدّول الإمبريالية في ابتداع وسائل وأساليب التأثير في الرأي العام العالمي، وحَجْب الأخبار وتحريف الحقائق والوقائع، وتَشْوِيه رُموز المُقاومة، عبر التضليل الإعلامي وتوظيف تقنيات الإتصال بهدف عَوْلَمة التّضْلِيل، وعولمة استهلاك السّلع والخدمات والأخبار والتحاليل التي تخدم المصالح الإقتصادية والسياسية والثقافية للشركات الكُبرى والإمبريالية، وبث الأوهام ضمن عالم افتراضي، يتشكل من مجموعات افتراضية يتجادل ويتحاوَرُ أفرادُها في فضاء افتراضي، ما يجعلهم، بعد فترة، مُدمنين على هذا الشكل من "النّضال" السياسي والفكري والثقافي، أي على الوَهْم، وينسون الإعتصام في السّاحات والتظاهر في الشوارع والهتاف بشعارات تُعبّر عن شُعورهم (الحقيقي وليس الإفتراضي)، ومجابهة قُوى القمع، أما أجهزة المخابرات فإنها تحشد وتستقطب فِعْلِيًّا وليس افتراضيًّا، لأن مهمتها الأولى تتمثل في غسيل الأدمغة، وتحويل المجرمين الصهاينة إلى "حلفاء"، يتجولون في الأماكن المُقدّسة في مكة والمدينة، بالإضافة إلى القُدْس المُحتلّة...
يبقى العُمّال والمُزارعون والكادحون، الذين ينتجون سِلَعًا حقيقية، وليست "مُفْتَرَضَة"، وعندما يتوقّفون عن العمل، من أجل تحسين الرواتب وظروف العمل، تتوقف أدوات الإنتاج، وتتوقف أو تنخفض معها أرباح الشركات والرأسماليين، وهذا نضال حقيقي، لا يقضي على الإستغلال، ولكنه يُشكّل مدرسة نتعلّم من خلالها افتكاك الحقوق، أو بعضها، ونتعلم مجابهة العدو الطّبقي.
باعت شركة "فيسبوك" عشرات الملايين من البيانات الخاصة بالمُستخدمين لشركات استغلت هذه البيانات من أجل التّأثير في الرأي العام، وتوجيه النّاخبين، في أوروبا وفي أمريكا الشمالية، بحسب طلب الجهة التي تُسَدّدُ ثمن هذه "الخدمة"، المتمثلة عادة في ترويج بعض الأفكار بين أكْبَر نسبة ممكنة أو شريحة من سكان بلدٍ مَا أو من سكان العالم، وتوجيه سُلوكيات وتصرفات أو استهلاك هؤلاء، "لغاية في نفس الرّأسماليِّين"، عبر تكرار نفس المحتوى الدّعائي، بأشكال مختلفة، بينما يتوهّم المواطن أنه حُرٌّ، وأنه "صحافي-مواطن"، يتمتع بحرية التعبير عن الرأي، ويصيغ وينشر "إعلامًا بديلاً"، ويكتب ويناقش ويتصل بغيره افتراضِيًّا، سواء عبر "فيسبوك" أو مُدَوّنة خاصة، أو غيرها من وسائل الإتصال، ونجحت الشركات وأجهزة استخبارات الدول الإمبريالية في توجيه رأي عام دولي، بحسب رغبتها، بشأن بعض القضايا، لأن وسائل التواصل "الإجتماعي" أصبحت مصدَرًا رئيسيًّا للأخبار وللتثقيف السياسي لجيل الشباب، ما أَسْهَمَ في إضْعَاف ثقافة المقاومة، وإضعاف المنظمات التي تهتم بالبحث عن بدائل تخدم العاملين والكادحين والفُقراء، والشُّعُوب المُضْطَهَدَة، والواقعة تحت الإحتلال، وما يسهم في إضْعَاف الهوية الطّبَقية والوطنية، لبعض الفئات من هذه الشعوب والبُلْدان...
يمكن أن تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا إيجابيًّا، لكنها تبقى مِلْكًا لمن أنشأها، ليُديرها ويتحكّم بها، وليُوجّهُها، ويُقرّرُ مُحتواها وأهدافها، وطُرُقَ تسيِيرها، لأنها وسائل الإتصال "المجانية، شركات رأسمالية، استثمر بها أصحاب الأسْهُم، لتكون مصدر أرباح مُرتفعة، عبر الإعلانات والتّرويج للسلع والخدمات (بمقابل)، أو عبر التأثير في الرأي العام، وتغْيِيب الوعي ببعض القضايا الوطنية، خدمة للشركات العابرة للقارات (بمقابل أيضًا)، ولتبرير عدوان جيوش الدول الإمبريالية، أو عبر توجيه النّاخبين للتصويت لفائدة قُوَى سياسية تُمثل مصالح اقتصادية وفكرية وحضارية مُعَيَّنَة، وبذلك يصبح دور وسائل الإتصال "الإجتماعي" مُضلِّلاً ومُخَرِّبًا للوعي، كما استخدمت المنظمات الإرهابية هذه الأدوات الإعلامية (بواسطة حسابات وَهْمِية) لاستقطاب إرهابيين جُدُد، يُساهمون في تخريب وتدمير أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا والمنطقة المُحيطة بالصّحراء الكُبْرى، بدعم مُباشر أو ضمْنِي من الإمبريالية الأمريكية والأوروبية، ومن الكيان الصهيوني، ولعبت دُوَيْلات الخليج دور الوكيل والمُمَوّل لهذه المجموعات الإرهابية، فيما تقمّصت تركيا دَورَ الوكيل المباشر لحلف شمال الأطلسي.
التجسس الإلكتروني على الأفراد والجماعات:
نشر موقع القسم العربي للإذاعة الدولية الألمانية "دوتشه فيلله" (منتصف شهر آذار/مارس 2018) تقريرًا عن استخدام الأنظمة العربية لمواقع التواصل الاجتماعي، وَوَصفت الإذاعة هذه المواقع بمصيدة للمعارضين (في مصر، على سبيل المثال) تراقب الأنظمة من خلالها مُستخدمي هذه المواقع، بذريعة بث وترويج أخبار زائفة، من شأنها بث البلبلة وزعزعة استقرار البلاد، ويبدو أن هذا "الإستقرار"، شديد الهشاشة لتقع زعْزَعَتُهُ بواسطة بعض الفقرات في فيسبوك أو بعض الجُمَل في تويتر، وطَوَعت الحُكومات ( ومنها الحكومة المصرية، على سبيل المثال ) جهازَ القضاء، لمراقبة هذه المواقع التي "تُصدر أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة"، أو "الإساءة إلى الجيش أو الشرطة" بحسب الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي يعتبر ذلك لا ينضوي تحت بند "حُرّية الرأي والتّعبير، بل "خيانة عظمى"، في خطاب ألقاه خلال شهر آذار/مارس 2018، واشترت الحكومة المصرية، لهذا الغرض، برامج مُستَوْرَدة من فرنسا، بالعملة الأجنبية، لمراقبة نشاط المواطنين على الشبكة الإلكترونية ووسائل التواصل، ثم شَرْعَنَ البرلمان هذه الإجراءات القَمعية بإقرار قانون "الجريمة الإلكترونية" (أو قانون جرائم المعلومات الإلكترونية)، بذريعة مكافحة التّطَرُّف والإرهاب، بحسب الصحف المصرية التي فقدت هامش الحرية الضّيّق الذي كانت تتمتع به، إثر تفعيل "قانون الطّوارئ"، الذي يُسهّل، ويُشَدّدُ عملية مراقبة المطبوعات والصحف والمنشورات، وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان...
نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية (الجمعة 30 آذار/مارس 2018) مقالاً يُفنّد ما تُرَوِّجُهُ مختلف المواقع عن أوهام "احترام أو حماية خُصُوصية" المستخدمين، ويؤكد المقال أن جهات عديدة تستغل البيانات الشخصية لمُسْتَخْدِمِي الشبكة الإلكترونية، وذكرت مثال شركة "أندر آرمور" الأمريكية للملابس الرياضية التي أعلنت (خلال الأسبوع الأخير من آذار/مارس 2018) تعرّض تطبيقها "ماي فيتنيس بال"، الخاص بإحصاء السعرات الحرارية، إلى القرصنة، وسرقة البيانات الخاصة، بما فيها أسماء وعناوين البريد الإلكتروني، لنحو مائة وخمسين مليون مُستخدم...
يستغل مُحرك شركة "غوغل"، خاصية تطبيقات تحديد المكان، ليُحصِي حركات وسَكَنات مالكي الهواتف "الذّكية"، كما يُراقب نشاط المُستخدمين على الشبكة، وعلى محركات البحث، وصُوَرَهُم، والوقت الذي يقضونه في كل موقع، لكي يقع تبويب هذه المعلومات، من قِبَلِ خوارزميات شركة "غوغل" التي تبيع هذا الحجم الهائل من البيانات إلى شركات الإشهار...
أصبحت التطبيقات "الذكية" تطلب من المستخدمين السماح لها بالدخول إلى كاميرا التصوير والميكروفون والتخزين الداخلي للهاتف، أو الحاسوب، وباستخدامها (أحيانا بدون طلب أي إذن)، كما تطلب تطبيقات أخرى (فيسبوك) الإجابة على بعض الأسئلة التي تخص خُصوصية المُسْتخدم، والبيانات الشخصية (مثل مكان وتاريخ الولادة ودرجة التعليم، ونوعية الوظيفة، والوضع العائلي، وغير ذلك)، ل"شَرْعَنَةِ" استغلال البيانات والمعلومات الشخصية، لأهداف سياسية أو تجارية، رغم القوانين التي تحمي البيانات الشخصية، منذ 1970، في أوروبا، ومنذ 2004 في بعض البلدان العربية، لكن هذه القوانين تبقى حِبْرًا على ورق، أمام مصالح الشركات الرأسمالية الإحتكارية المُعَوْلَمَة.
نشرت منظمة العفو الدولية (الخميس 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) تقريرا اعتَبر ما تقوم به شركتا غوغل وفيسبوك خطراً على حقوق الإنسان، ويتطلب اتخاذ إجراء يراقب عمل هذه الشركات، ويضمن حقوق المواطنين، لأن شركتي غوغل وفيسبوك تسيطران على أهم القنوات التي يستخدمها مليارات الأشخاص عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الخدمات التي تُعَدُّ جزءًا من شركة "غوغل، ومنها: "واتس آب" و"إنستغرام". و"يوتيوب" ونظام "أندرويد"، وما إلى ذلك، ما يتيح للشركتَيْن مراقبة الأشخاص في كل مكان، لجمع واستخدام بياناتهم الشخصية لأغراض دعائية"، دون علمهم ودون موافقتهم.
شركات في خدمة الإمبريالية والصهيونية:
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" (الإثنين 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) خبر بدء شركة "غوغل" أشغال وضع الأساس لشبكة ألياف بصرية بين الجزيرة العربية (السعودية) وفلسطين المحتلة، في خطوة تطبيعية لم تُعلنها صُحف ووسائل إعلام الخليج، ويتنزل هذه الخط المباشر ضمن مخططات "غوغل" لمشروع ضخم للشبكات "يربط أوروبا بالهند مرورا بالشرق الأوسط (الأردن والسعودية وفلسطين المحتلة وعُمان...)، بهدف زيادة القدرات التمريرية للشبكات القائمة وتطوير مراكز بيانات الشركة"، بقيمة أربعمائة مليون دولار، بحسب موقع الصحيفة الأمريكية، ويهدف المشروع تخفيف ازدحام الطلب على الإنترنت في المنطقة، والتقليل من مخاطر انقطاع الشبكة الإلكترونية التي تمر خطوطها عبر البحر الأحمر، وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى دور الولايات المتحدة التي أشرفت على سلسلة من الصفقات، وضغطت من أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين دول الخليج والكيان الصهيوني، كما أشرفَت الإدارة الأمريكية، بشكل مباشر على إعلان تطبيع العلاقات بين الدول العربية (الإمارات والبحْرَيْن وعُمان والسودان، وقريبًا السعودية...)، والكيان الصهيوني.
لا تختلف دولة آل سعود عن منظمات الإسلام السياسي، بشأن الموقف من الكيان الصهيوني ومن التطبيع، وبشأن خدمة الإمبريالية، فقد نَشَرَ موقع مجلة "ماذر بورد" (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) تحقيقًا أشار إلى شراء الجيش الأمريكي لمعلومات خاصة جمعتها تطبيقات داخل الولايات المتحدة وخارجها، ومنها تطبيقات "إسلامية"، مثل "مسلم برو"، الذي تمّ تحميله حوالي 100 مليون مرة عبر العالم، وهو تطبيق يحتوي على بعض مقاطع من القُرآن، بعدة لُغات، و يُذَكٍّرُ المُؤمنين بمواعيد الصلاة واتجاه القبلة، وكذلك تطبيق "مسلم مينغل" الذي تمّ تحميله 100 ألف مرة في مناطق مختلفة من العالم، وهو تطبيق خاص بالدردشة وإنشاء "علاقات صداقة" بين المسلمين، وقام المُشرفون على هذه التطبيقات بِبَيْع معلومات المستخدمين لشركات أخرى، من بينها الشركة الأمنية "بابل ستريت" التي طوّرت أداة أمنية اسمها "لوكايت إكس"، والتي اشتراها الجيش الأمريكي، واشترت مجموعة من المُؤسّسات والوكالات الأمنية الأمريكية هذه التّطبيقات التي تتيح تحديد المكان وتعقب أصحاب الهواتف والحواسيب واللوحات والأجهزة المحمولة، وتم بيع بيانات المستخدمين "المُسلمين" أيضًا إلى شركات إشهار وإعلانات انكَبّت على تحليل البيانات الخاصة، إلى جانب الجيش الأمريكي، والشركات العسكرية المرتبطة به، بحسب تحقيق "ماذر بورد".
أدّى نشر هذا التحقيق إلى إعلان مستخدمين حذف التطبيق "الإسلامي" من هواتفهم، لكن ذلك لن يُجْدِي، لأن بياناتهم أصبحت بحوزة الجيش الأمريكي والمُؤسسات العسكرية والأمنية المتعاونة معه، في مختلف مناطق العالم، من أفغانستان إلى نيجيريا.
تُشكل موافقة المستخدمين على شروط استخدام مجموعة من التطبيقات والخدمات دون قراءة بنودها، ورْطة حقيقة، إذ تعمد هذه التطبيقات، فور الموافقة، إلى بيع البيانات لطرف ثالث قد يستغلها لأغراض التجسس، ولم تتوقف الشركات العملاقة (مثل غوغل وفيسبوك) عن ابتكار طُرُق جديدة لانتهاك البيانات الخاصة، واستغلالها، مباشرة أو عبر طرف ثالث، لأغراض تجارية وسياسية وعسكرية، وأعمال تجسس، ونشر موقع "نيويورك تايمز" مقالا (23 تشرسن الثاني/نوفمبر 2020) يوضّح أنه "حالما يتم جمع البيانات الخاصة، يصير بإمكان أيّ كان الحصول عليها بمقابل، وإعادة بيعها، ولا توجد منافذ قانونية لطلب تعويضات من قيمة عملية البيع، بل هناك شركات تحاول خلق نظام جديد من "سمسرة البيانات" يعوّض النظام الحالي...
تُعتَبَرُ البيانات ثروةً، في عدة مجالات، وجمعت إحدى شركات التطبيقات الصحية البيانات من شركات تتوفر على السجلات الصحية للمرضى، ثم باعتها إلى باحثين وإلى شركات تجارية، بذريعة أن المرضى سوف يستفيدون من تقدّم البحوث، أو قد يحصلون على نسبة معينة من عمليات البيع، وهو أمر مجافي للواقع. أما مستخدمو تطبيق "مسلم برو" فقد قدم العديد منهم دعاوى قضائية، خاصة في أوروبا، من أجل فتح تحقيق في "انتهاك حقوق الإنسان، بواسطة الملفات أو تطبيقات إلكترونية"، و "خيانة الأمانة"، وتشكيل " خطر على حياة الآخرين "و"التواطؤ في القتل "، بالتعاون مع "القوات الخاصة" لأقوى جيش في العالم، ويتقاسم الجيش الأمريكي هذه البيانات الشخصية مع وكالات "إنفاذ القانون" الأمريكية، مثل الجمارك، وقوات حماية الحدود، وإدارة الهجرة، ووكالات حُكومية أخرى، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب. 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020)، وأورد موقع "سي إن إن" أن الشركة الأمريكية "إكس-مود" تتعقب 25 مليون جهاز داخل الولايات المتحدة كل شهر، و40 مليونا خارج الولايات المتحدة (منها تطبيقات مسلم برود )، في الاتحاد الأوروبي وأميركا الجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
الحرب الإعلامية الصهيونية بمواقع التواصل "الإجتماعي":
ارتبط استخدام شبكة الإنترنت في فلسطين المحتلة بالإحتلال ونتائجه وامتداداته الإعلامية، لأن الإتصالات (مثل أي جانب آخر من حياة الفلسطينِيِّين) تمر عبر سلطات الإحتلال، ولأنه احتلال من نوع خاص، يُزَيِّفُ تاريخ المكان وأهله، ويختلق وُجُودًا وهْمِيًّا لمجموعات بشرية جاءت من أوروبا ومن مناطق أخرى من العالم، مُدّعية أن علاقتها بهذا "المكان" قديمة، ما يستدعي طَرْدَ الشعب الفلسطيني من وطنه، ويُرَوِّجُ الإحتلال هذه الرواية بكافة الوسائل، ومنها وسائل الإتصال "الإجتماعي"، وخصوصًا شبكة "فيسبوك"، حيث يُروّجُ الإحتلال دعايته بشكل مَدْرُوس، وباللغة العربية، بعد أن استوطن الضُّبّاط الصهاينة شبكة "الجزيرة" القَطَرِية التي تستضيفهم، باستمرار، وتسْمَحُ لهم بنشر دعايتهم، منذ عُقُود.
يتوجّه جُزْءٌ من الدّعاية الصهيونية الحكومية مباشرة للفلسطينيين، بالإعتماد على أساليب مدروسة، هدفها غسيل الأدمغة، مع بث الإحباط، والحث على قُبُول "الأمر الواقع"، وهو ما أصبحت تُرَدّدُهُ العديد من وسائل الإعلام الرسمية العربية، ومن الحُكّام العرب، خصوصًا منذ أعلن أنور السادات "إن الولايات المتحدة (ومن ورائها الكيان الصهيوني) تمتلك 99% من أوراق الحل"، ولم تُؤَسِّس المخابرات والحكومة الصهيونية هذه المواقع لتناقش أيًّا كان، بل لتُؤَكِّدَ وجهة النّظر الصّهيونية، بأساليب تمرّست عليها الحركة الصهيونية، منذ تأسيسها، وجنّدت لها ما لديها من وسائل مالية وبشرية، لشراء الصّحف، منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ثم محطات الإذاعات والتلفزيون ودُور نَشْر الكُتُب، وشركات إنتاج المُسلسلات والأشرطة السينمائية، قبل أن تنتشر وسائط الإتصال المُسمّى "اجتماعي"، لينشر بها الكيان الصهيوني التطبيقات التي تُزيّف التاريخ والجغرافيا، وتكيّفت الحركة الصهيونية مع التغييرات، ومع التطور التكنولوجي، وأنشأت منظومة متكاملة تعمل على التّأثير في الرّأي العام الفلسطيني والعربي والعالمي، بالتوازي مع منطق القُوّة المُطلقة للجيش الذي تُزَوِّدُهُ القوة الإمبريالية العُظْمى (الإمبريالية الأمريكية) بأحدث أسلحة الفَتْك والدّمار، وتدرس الدعاية الصهيونية، بكافة أشكالها (في الإذاعة والتلفزيون والصحف والشبكة الإلكترونية...) الْفِئة المُستهدَفَة من الجمهور، لتوجيه الخطاب الذي تعتبره مناسبًا، من أجل تمرير نفس المضمون، ومن أجل كَسْر شوكة المقاومة وإظهارها كعمل عَبَثِي، مع تأكيد "حق" يهود العالم في استيطان فلسطين، ونفي "الآخر"، بدءًا من الفلسطيني والعربي، ومحاربة أي شكل من أشكال المعارضة، بالكلمة أو بمقاطعة الكيان الصهيوني أو بإظهار الوقائع التاريخية، ودعمت الإمبريالية الأمريكية الكيان الصهيوني وكافة أدوات الهيمنة والدّعاية التي أنشأها، بواسطة المنظمات الصهيونية الأمريكية التي أسست، منذ سنة 2003، شبكة من مؤسسات العلاقات العامة والدّعاية للدفاع عن الكيان الصهيوني، ولتعزيز "المُكتسبات" الصهيونية في مجالات الإعلام والمُسلسلات التلفزيونية والسينما الأمريكية (التي تُهيمن على الإتجاهات الإعلامية والفنية العالمية )، وأحصت بعض الدّراسات الفلسطينية بَثَّ سَنَوِيًّا، بين 2003 و 2019، ما لا يقل عن خمسة أشرطة ومُسلسلات درامية، أنتجها صهاينة، ونالت شهرة عالمية، وعلى نطاق واسع جدًّا، وخَدَمَت الدعاية الصهيونية، واختصت بعض منصّات البث التلفزيوني الرّقمي (مثل "نتفليكس" التي تُشغّل نحو 900 مهندس، و "إتش بي أُو") التي تجتذب الشباب، في بث الأعمال الدّرامية الصهيونية التي تحطُّ من قيمة وقدر الفلسطيني والعربي وتُجرّدُهُ من إنسانيته، فهو غير قادر وغير مُؤَهّل ليحكم نفسه، مقابل التّفَوُّق المادّي والأخلاقي للعدو، الذي يُمثّل امتدادًا للمشروع "الحضاري" للإمبريالية الأوروبية والأمريكية، ما يُبرٍّرُ الإحتلال والإغتيال والإعتقال والتّهجير، و"إحلال التّقَدّم والمَدَنِيّة، محلّ التّخلّف والهمَجِيّة"، بحسب "ثيودور هرتزل"، أحد مؤسسي الحركة الصهيونية، في القرن التاسع عشر...
أنشأ الكيان الصهيوني، منذ سنة 1965، إذاعة رسمية، ناطقة بالعربية، وتبث الأغاني العربية، وتطورت هذه الدّعاية مع تطور وسائل الإعلام، ومع انتشار استخدام الشبكة الإلكترونية، وتنوعت الأشكال والمضامين، دون أن تحيد عن البرامج والأهداف الصّهيونية، وأنشأت أداة استخباراتية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، تحت إسم "إذاعة المُنسّق"، التي يُشرف عليها جهاز "الأمن الدّاخلي" (شاباك) بهدف تشويه مبدأ وفكر وممارسة المُقاومة، بالإضافة إلى العديد من المواقع والصفحات غير المُعلَنَة، والتي يعسر، في البداية، رَبْطُها بالمخابرات الصهيونية.
اللغة والثقافة العربيّتَان في الدعاية الصهيونية:
يستغل الكيان الصّهيوني التراث الثقافي العربي، للتوجّه إلى الفلسطينيين والعرب، باللغة العربية، وباستخدام أغاني أم كلثوم وفيروز، وصباح فخري، وغير ذلك، عبر إذاعة "صوت إسرائيل"، باللغة العربية، وأشرفت المخابرات الصهيونية (والجيش) على إنتاج مسرحية موسيقية عن سيرة "أم كلثوم"، بهدف تمرير الإيديولوجيا الصهيونية بأشكال "ناعمة"، إلى جانب القوة العسكرية والأسلحة الفتاكة والمجازر، كما يستغل الكيان الصهيوني بشكل كبير مواقع التواصل "الاجتماعي"، للتأثير في الرأي العام العربي والعالمي، وخاصة في فئة الشّباب، وأنشأ صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، بهدف "تنظيف" الكيان الصهيوني من كل الجرائم، وتغيير صورة الإحتلال الإستيطاني لدى الشباب العربي، واستكمال ما بدأته السينما الأمريكية (هوليود) منذ أربعينيات القرن العشرين.
أصبحت وسائل الإتصال الحديثة تُركّز على تفوق العدو، ليس في المجال العسكري فحسب (بفضل الدعم الإمبريالي غير المحدود) بل في المجالات العلمية والثقافية والأدبية، وغيرها، بدعم من المؤسسات الإمبريالية، فكم من مجرم صهيوني حصل على جائزة نوبل للسلام، مثل رابين وبيغين وبيريز، ويستغل الكيان الصهيوني هذه الجوانب، والإنحياز الإمبريالي، ليبث دعايته "النّاعمة" وبلغتنا التي يُعاقَبُ الفلسطينيون الذين يتكلمونها في المتاجر والمَحلات والمُؤسّسات الصهيونية، في فلسطين المحتلّة...
خاتمة:
انتشر استخدام وسائل الإتصال "الإجتماعي"، وأصبح الأداة المُفضّلة للتواصل، والأوسع انتشارًا، والأرخص ثمنًا، لكن من يتحكّم بهذه الأدوات، ومن يُديرُها ويُشرف على تطويرها؟
إن الشركات الرأسمالية الإحتكارية التي أسّست هذه الشبكات تهدف استعادة المبالغ التي استثمرتها، وتحقيق أكبر قدر من الربح، لقاء هذه الخدمات، التي يتمثل الجانب الأهم منها في تجميع وتخزين بيانات ومميزات المستخدمين، وبيْعها إلى الشركات والحكومات والمؤسسات الرسمية، كالجيش وقوات الأمن، وتُشكّل هذه البيانات سلعةً أو "مُنْتَجًا" تحتاجه الشركات التجارية ومؤسسات الإستطلاع وسبْر الآراء، والأحزاب السياسية والحكومات، لمعرفة اتجاهات المُستهلكين، أو الرّأي العام، أو للتّأثير في شرائح معيّنة، وتشكيل وَعْيِها، بما يتّفق مع مصالح هذه الشركات أو هذا الأحزاب والحكومات...
نحن نَنْتَمِي إلى أُمّة مُضْطَهَدَة وواقعة تحت الإستعمار المباشر (فلسطين) ويستهدفها العدوان العسكري (ليبيا واليمن والعراق وسوريا...) وواقعة تحت الهيمنة الإمبريالية، وتتَعَرّض للتّقسيم والتّفتيت...
يتمثل الرّدّ الطبيعي للشعوب العربية في العمل على تحرير الأوطان، ومقاومة المُستعمر والقوى المُهيْمِنَة، والتّصَدِّي للنّهب والإستغلال الذي تُمارسه الشركات العابرة للقارات وَوُكَلاؤُها في الدّاخل، وهي مقاومة لن يُكتَبَ لها النجاح، إذا لم تكُنْ مُنظّمة وجماعية (وليست فردية)، وهي مقاومة حقيقية في الشوارع والسّاحات والمصانع والمزارع، وليست مقاومة "افتراضية"، دُون تَجْرِيد الفضاء الإفتراضي من دَوْرهِ في الدّعاية والتّحريض ونشر الوعي الثقافي والحضاري، لكن هذا الدّوْر ضئيل وثانوي، ما دامت شركات "فيسبوك" أو "غوغل"، أو غيرها تتحكم بقواعد الإستخدام، وبشكل ومحتوى وتقنيات هذه الأدوات...
تمكّنت الإمبريالية والكيان الصّهيوني من استخدام هذه الأدوات، لأنها أدواتُها، وخلقَتْها من أجل إنجاز برامجَ وأهداف واضحة، خلافًا للمُستخدمين الأفراد، وخاصّة من الشباب، الذين تقمعهم الأنظمة المحلّية، وتحرمهم من حرية الرأي والتعبير، في ظل ارتفاع البطالة والفَقْر، وعندما تكون هذه الشرائح من المجتمع غير مُحصّنة، سياسيا وثقافيا وحضاريّا، تكون عُرضة للإختراق ولتشويه الوعي ولتزييف التاريخ.
يشكّل الإنتاج المُقاوم أو البديل جزءًا صغيرًا جدًّا من محتوى وسائل التّواصل "الإجتماعي"، ولكن لا خيار لنا سوى المُقومة بمختلف الأساليب والوسائل...
أدوات الإستعمار الثقافي
الطاهر المعز
قُدِّرَ (بنهاية سنة 2016) عدد مستخدمي الإنترنت في العالم بنحو أربعة مليارات شخص، أو نحو 60% من سكان العالم آنذاك، وفي سنة 2017، قُدِّرَ عدد المُستخدمين "النّشطين" لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحوالي ملياري شخص شهريا (300 ألف مُشاركة في النقاشات، كل دقيقة)، و يقضون حوالي خمسة مليارات دقيقة على موقع "فيسبوك"، ويرسل مستخدمو البريد الإلكتروني نحو ثلاثمائة مليار رسالة بريد إلكتروني، مع تنزيل 35 مليون تطبيق، كل دقيقة، ويُشارك نحو مليار مستخدم في موقع "يوتوب"، كل دقيقة أيضًا، ويتردد على موقع "واتساب" نحو 950 مليونًا، و440 مليونًا على "غوغل"، و430 مليونًا على "إنستغرام"، و420 مليونًا على "لينكدإن"، و325 مليونًا على "تويتر"، و230 مليونًا على "تمبلر"، و110 ملايين على "بينتريست"، وتمر عبر البريد الإلكتروني، نحو 204 مليون رسالة إلكترونية، كل دقيقة...
وتَتَبّعُ الشركات التي تُدير هذه المواقع، حركات وسكنات المستخدمين، ومُحتوى ما يتبادلونه من المواد، خلال اتصالاتهم عبر "سكايب"، وتغريداتهم عبر "تويتر" (حوالي 600 ألف كل دقيقة)، ونَشْر الصّوَر، وغير ذلك من المعلومات المهمة التي تمثل كَنْزًا، وتستخدمها شركات التجارة والإشهار والمخابرات ووسائل الإعلام ومراكز البحوث والدّراسات، بهدف التّسويق، كما التوجيه العقائدي (الإيديولوجي) للرأي العام، حيث لم يقتصر دور وسائل التواصل الاجتماعي على التواصل بين الأصدقاء وأفراد العائلة، والأصدقاء الإفتراضيين، بل أصبحت هذه الوسائل محل دراسات وبحوث علمية، للتأثير في عُقول الناس، وخاصة الشباب الذين وُلِدُوا مع هذه الأدوات، ولم يعرفوا الرسائل البريدية والبطاقات المُرسَلَة خلال العُطَل والمُناسبات، وغيرها، واستغلت السُّلطات السّياسية والأحزاب وأجهزة الإستخبارات هذه الأدوات لتوجيه الرأي العام، ولِبَثِّ الأفكار التي تُريد إيصالها، للفئة التي تختارها من مواطني العالم، وكلما عَلَتْ مكانة الجهة التي تبث الدعاية، تضخّمت ميزانياتها وإمكاناتها، وكان تأثيرها أكبر في عقول النّاس، وفي تشكيل وَعْيِهِم، ما يطرح العديد من التّساؤلات حول أمن واستقرار البُلدان المُسمّاة "نامية"، أو التي تستهدفها دعاية الإستخبارات الإمبريالية، أو الصهيونية، بالنسبة لنا كعرب...
قُدِّرَ عدد مستخدمي وسائل التواصل "الإجتماعي"، بنحو 3,5 مليارات شخص، سنة 2019، من بينهم أكثر من 136 مليون مواطن عربي، لفترة لا تقل عن تسعين دقيقة، لكلّ منهم، يوميًّا، ويرتفع عدد ساعات استخدام هذه الوسائل إلى أكثر من أربع ساعات في السعودية، سنة 2019، بحسب دراسة نشرتها مؤسسة "هوتسويت" (كندا)، وتستغل الشركات العابرة للقارات، من مختلف القطاعات، هذه الفترة الزمنية لتسويق منتجاتها، فيما تستغل أجهزة أخرى، هذا الحيّز الزّمني لبث سُمُوم أخرى، تتعلق ببثّ فكرة سلبية عن حضارتنا وثقافتنا وتاريخنا، وتمجيد "مزايا ومحاسن" الإستعمار والصهيونية، بعنوان "التطور والتّقدّم"، من خلال تسريب ثقافة التطبيع، بدل ثقافة المُقاوَمة، باسم "التّسامح، وقُبُول الآخر"، حتى إذا كان "الآخر" مُستَعْمِرًا، يستوطن البلاد بقوة السلاح، ويُطرد أصحاب الوطن الشرعيين...
قدّرت شركات التواصل "الإجتماعي" عدد مواقع التواصل بنحو 1,7 مليار موقع، وخمسمائة مليون مدونة، وينشُرُ المُستخدمون حوالي سبعين مليون منشور وحوالي سبعة وسبعين مليون تعليق، شهريا، ويشاهد أكثر من 409 ملايين شخص ما يزيد عن عشرين مليار صفحة تدوين شهريا، تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
وسائل تخريب الوعي:
بَرَعت مراكز دراسات وبُحوث الدّول الإمبريالية في ابتداع وسائل وأساليب التأثير في الرأي العام العالمي، وحَجْب الأخبار وتحريف الحقائق والوقائع، وتَشْوِيه رُموز المُقاومة، عبر التضليل الإعلامي وتوظيف تقنيات الإتصال بهدف عَوْلَمة التّضْلِيل، وعولمة استهلاك السّلع والخدمات والأخبار والتحاليل التي تخدم المصالح الإقتصادية والسياسية والثقافية للشركات الكُبرى والإمبريالية، وبث الأوهام ضمن عالم افتراضي، يتشكل من مجموعات افتراضية يتجادل ويتحاوَرُ أفرادُها في فضاء افتراضي، ما يجعلهم، بعد فترة، مُدمنين على هذا الشكل من "النّضال" السياسي والفكري والثقافي، أي على الوَهْم، وينسون الإعتصام في السّاحات والتظاهر في الشوارع والهتاف بشعارات تُعبّر عن شُعورهم (الحقيقي وليس الإفتراضي)، ومجابهة قُوى القمع، أما أجهزة المخابرات فإنها تحشد وتستقطب فِعْلِيًّا وليس افتراضيًّا، لأن مهمتها الأولى تتمثل في غسيل الأدمغة، وتحويل المجرمين الصهاينة إلى "حلفاء"، يتجولون في الأماكن المُقدّسة في مكة والمدينة، بالإضافة إلى القُدْس المُحتلّة...
يبقى العُمّال والمُزارعون والكادحون، الذين ينتجون سِلَعًا حقيقية، وليست "مُفْتَرَضَة"، وعندما يتوقّفون عن العمل، من أجل تحسين الرواتب وظروف العمل، تتوقف أدوات الإنتاج، وتتوقف أو تنخفض معها أرباح الشركات والرأسماليين، وهذا نضال حقيقي، لا يقضي على الإستغلال، ولكنه يُشكّل مدرسة نتعلّم من خلالها افتكاك الحقوق، أو بعضها، ونتعلم مجابهة العدو الطّبقي.
باعت شركة "فيسبوك" عشرات الملايين من البيانات الخاصة بالمُستخدمين لشركات استغلت هذه البيانات من أجل التّأثير في الرأي العام، وتوجيه النّاخبين، في أوروبا وفي أمريكا الشمالية، بحسب طلب الجهة التي تُسَدّدُ ثمن هذه "الخدمة"، المتمثلة عادة في ترويج بعض الأفكار بين أكْبَر نسبة ممكنة أو شريحة من سكان بلدٍ مَا أو من سكان العالم، وتوجيه سُلوكيات وتصرفات أو استهلاك هؤلاء، "لغاية في نفس الرّأسماليِّين"، عبر تكرار نفس المحتوى الدّعائي، بأشكال مختلفة، بينما يتوهّم المواطن أنه حُرٌّ، وأنه "صحافي-مواطن"، يتمتع بحرية التعبير عن الرأي، ويصيغ وينشر "إعلامًا بديلاً"، ويكتب ويناقش ويتصل بغيره افتراضِيًّا، سواء عبر "فيسبوك" أو مُدَوّنة خاصة، أو غيرها من وسائل الإتصال، ونجحت الشركات وأجهزة استخبارات الدول الإمبريالية في توجيه رأي عام دولي، بحسب رغبتها، بشأن بعض القضايا، لأن وسائل التواصل "الإجتماعي" أصبحت مصدَرًا رئيسيًّا للأخبار وللتثقيف السياسي لجيل الشباب، ما أَسْهَمَ في إضْعَاف ثقافة المقاومة، وإضعاف المنظمات التي تهتم بالبحث عن بدائل تخدم العاملين والكادحين والفُقراء، والشُّعُوب المُضْطَهَدَة، والواقعة تحت الإحتلال، وما يسهم في إضْعَاف الهوية الطّبَقية والوطنية، لبعض الفئات من هذه الشعوب والبُلْدان...
يمكن أن تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا إيجابيًّا، لكنها تبقى مِلْكًا لمن أنشأها، ليُديرها ويتحكّم بها، وليُوجّهُها، ويُقرّرُ مُحتواها وأهدافها، وطُرُقَ تسيِيرها، لأنها وسائل الإتصال "المجانية، شركات رأسمالية، استثمر بها أصحاب الأسْهُم، لتكون مصدر أرباح مُرتفعة، عبر الإعلانات والتّرويج للسلع والخدمات (بمقابل)، أو عبر التأثير في الرأي العام، وتغْيِيب الوعي ببعض القضايا الوطنية، خدمة للشركات العابرة للقارات (بمقابل أيضًا)، ولتبرير عدوان جيوش الدول الإمبريالية، أو عبر توجيه النّاخبين للتصويت لفائدة قُوَى سياسية تُمثل مصالح اقتصادية وفكرية وحضارية مُعَيَّنَة، وبذلك يصبح دور وسائل الإتصال "الإجتماعي" مُضلِّلاً ومُخَرِّبًا للوعي، كما استخدمت المنظمات الإرهابية هذه الأدوات الإعلامية (بواسطة حسابات وَهْمِية) لاستقطاب إرهابيين جُدُد، يُساهمون في تخريب وتدمير أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا والمنطقة المُحيطة بالصّحراء الكُبْرى، بدعم مُباشر أو ضمْنِي من الإمبريالية الأمريكية والأوروبية، ومن الكيان الصهيوني، ولعبت دُوَيْلات الخليج دور الوكيل والمُمَوّل لهذه المجموعات الإرهابية، فيما تقمّصت تركيا دَورَ الوكيل المباشر لحلف شمال الأطلسي.
التجسس الإلكتروني على الأفراد والجماعات:
نشر موقع القسم العربي للإذاعة الدولية الألمانية "دوتشه فيلله" (منتصف شهر آذار/مارس 2018) تقريرًا عن استخدام الأنظمة العربية لمواقع التواصل الاجتماعي، وَوَصفت الإذاعة هذه المواقع بمصيدة للمعارضين (في مصر، على سبيل المثال) تراقب الأنظمة من خلالها مُستخدمي هذه المواقع، بذريعة بث وترويج أخبار زائفة، من شأنها بث البلبلة وزعزعة استقرار البلاد، ويبدو أن هذا "الإستقرار"، شديد الهشاشة لتقع زعْزَعَتُهُ بواسطة بعض الفقرات في فيسبوك أو بعض الجُمَل في تويتر، وطَوَعت الحُكومات ( ومنها الحكومة المصرية، على سبيل المثال ) جهازَ القضاء، لمراقبة هذه المواقع التي "تُصدر أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة"، أو "الإساءة إلى الجيش أو الشرطة" بحسب الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي يعتبر ذلك لا ينضوي تحت بند "حُرّية الرأي والتّعبير، بل "خيانة عظمى"، في خطاب ألقاه خلال شهر آذار/مارس 2018، واشترت الحكومة المصرية، لهذا الغرض، برامج مُستَوْرَدة من فرنسا، بالعملة الأجنبية، لمراقبة نشاط المواطنين على الشبكة الإلكترونية ووسائل التواصل، ثم شَرْعَنَ البرلمان هذه الإجراءات القَمعية بإقرار قانون "الجريمة الإلكترونية" (أو قانون جرائم المعلومات الإلكترونية)، بذريعة مكافحة التّطَرُّف والإرهاب، بحسب الصحف المصرية التي فقدت هامش الحرية الضّيّق الذي كانت تتمتع به، إثر تفعيل "قانون الطّوارئ"، الذي يُسهّل، ويُشَدّدُ عملية مراقبة المطبوعات والصحف والمنشورات، وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان...
نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية (الجمعة 30 آذار/مارس 2018) مقالاً يُفنّد ما تُرَوِّجُهُ مختلف المواقع عن أوهام "احترام أو حماية خُصُوصية" المستخدمين، ويؤكد المقال أن جهات عديدة تستغل البيانات الشخصية لمُسْتَخْدِمِي الشبكة الإلكترونية، وذكرت مثال شركة "أندر آرمور" الأمريكية للملابس الرياضية التي أعلنت (خلال الأسبوع الأخير من آذار/مارس 2018) تعرّض تطبيقها "ماي فيتنيس بال"، الخاص بإحصاء السعرات الحرارية، إلى القرصنة، وسرقة البيانات الخاصة، بما فيها أسماء وعناوين البريد الإلكتروني، لنحو مائة وخمسين مليون مُستخدم...
يستغل مُحرك شركة "غوغل"، خاصية تطبيقات تحديد المكان، ليُحصِي حركات وسَكَنات مالكي الهواتف "الذّكية"، كما يُراقب نشاط المُستخدمين على الشبكة، وعلى محركات البحث، وصُوَرَهُم، والوقت الذي يقضونه في كل موقع، لكي يقع تبويب هذه المعلومات، من قِبَلِ خوارزميات شركة "غوغل" التي تبيع هذا الحجم الهائل من البيانات إلى شركات الإشهار...
أصبحت التطبيقات "الذكية" تطلب من المستخدمين السماح لها بالدخول إلى كاميرا التصوير والميكروفون والتخزين الداخلي للهاتف، أو الحاسوب، وباستخدامها (أحيانا بدون طلب أي إذن)، كما تطلب تطبيقات أخرى (فيسبوك) الإجابة على بعض الأسئلة التي تخص خُصوصية المُسْتخدم، والبيانات الشخصية (مثل مكان وتاريخ الولادة ودرجة التعليم، ونوعية الوظيفة، والوضع العائلي، وغير ذلك)، ل"شَرْعَنَةِ" استغلال البيانات والمعلومات الشخصية، لأهداف سياسية أو تجارية، رغم القوانين التي تحمي البيانات الشخصية، منذ 1970، في أوروبا، ومنذ 2004 في بعض البلدان العربية، لكن هذه القوانين تبقى حِبْرًا على ورق، أمام مصالح الشركات الرأسمالية الإحتكارية المُعَوْلَمَة.
نشرت منظمة العفو الدولية (الخميس 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) تقريرا اعتَبر ما تقوم به شركتا غوغل وفيسبوك خطراً على حقوق الإنسان، ويتطلب اتخاذ إجراء يراقب عمل هذه الشركات، ويضمن حقوق المواطنين، لأن شركتي غوغل وفيسبوك تسيطران على أهم القنوات التي يستخدمها مليارات الأشخاص عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الخدمات التي تُعَدُّ جزءًا من شركة "غوغل، ومنها: "واتس آب" و"إنستغرام". و"يوتيوب" ونظام "أندرويد"، وما إلى ذلك، ما يتيح للشركتَيْن مراقبة الأشخاص في كل مكان، لجمع واستخدام بياناتهم الشخصية لأغراض دعائية"، دون علمهم ودون موافقتهم.
شركات في خدمة الإمبريالية والصهيونية:
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" (الإثنين 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) خبر بدء شركة "غوغل" أشغال وضع الأساس لشبكة ألياف بصرية بين الجزيرة العربية (السعودية) وفلسطين المحتلة، في خطوة تطبيعية لم تُعلنها صُحف ووسائل إعلام الخليج، ويتنزل هذه الخط المباشر ضمن مخططات "غوغل" لمشروع ضخم للشبكات "يربط أوروبا بالهند مرورا بالشرق الأوسط (الأردن والسعودية وفلسطين المحتلة وعُمان...)، بهدف زيادة القدرات التمريرية للشبكات القائمة وتطوير مراكز بيانات الشركة"، بقيمة أربعمائة مليون دولار، بحسب موقع الصحيفة الأمريكية، ويهدف المشروع تخفيف ازدحام الطلب على الإنترنت في المنطقة، والتقليل من مخاطر انقطاع الشبكة الإلكترونية التي تمر خطوطها عبر البحر الأحمر، وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى دور الولايات المتحدة التي أشرفت على سلسلة من الصفقات، وضغطت من أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين دول الخليج والكيان الصهيوني، كما أشرفَت الإدارة الأمريكية، بشكل مباشر على إعلان تطبيع العلاقات بين الدول العربية (الإمارات والبحْرَيْن وعُمان والسودان، وقريبًا السعودية...)، والكيان الصهيوني.
لا تختلف دولة آل سعود عن منظمات الإسلام السياسي، بشأن الموقف من الكيان الصهيوني ومن التطبيع، وبشأن خدمة الإمبريالية، فقد نَشَرَ موقع مجلة "ماذر بورد" (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) تحقيقًا أشار إلى شراء الجيش الأمريكي لمعلومات خاصة جمعتها تطبيقات داخل الولايات المتحدة وخارجها، ومنها تطبيقات "إسلامية"، مثل "مسلم برو"، الذي تمّ تحميله حوالي 100 مليون مرة عبر العالم، وهو تطبيق يحتوي على بعض مقاطع من القُرآن، بعدة لُغات، و يُذَكٍّرُ المُؤمنين بمواعيد الصلاة واتجاه القبلة، وكذلك تطبيق "مسلم مينغل" الذي تمّ تحميله 100 ألف مرة في مناطق مختلفة من العالم، وهو تطبيق خاص بالدردشة وإنشاء "علاقات صداقة" بين المسلمين، وقام المُشرفون على هذه التطبيقات بِبَيْع معلومات المستخدمين لشركات أخرى، من بينها الشركة الأمنية "بابل ستريت" التي طوّرت أداة أمنية اسمها "لوكايت إكس"، والتي اشتراها الجيش الأمريكي، واشترت مجموعة من المُؤسّسات والوكالات الأمنية الأمريكية هذه التّطبيقات التي تتيح تحديد المكان وتعقب أصحاب الهواتف والحواسيب واللوحات والأجهزة المحمولة، وتم بيع بيانات المستخدمين "المُسلمين" أيضًا إلى شركات إشهار وإعلانات انكَبّت على تحليل البيانات الخاصة، إلى جانب الجيش الأمريكي، والشركات العسكرية المرتبطة به، بحسب تحقيق "ماذر بورد".
أدّى نشر هذا التحقيق إلى إعلان مستخدمين حذف التطبيق "الإسلامي" من هواتفهم، لكن ذلك لن يُجْدِي، لأن بياناتهم أصبحت بحوزة الجيش الأمريكي والمُؤسسات العسكرية والأمنية المتعاونة معه، في مختلف مناطق العالم، من أفغانستان إلى نيجيريا.
تُشكل موافقة المستخدمين على شروط استخدام مجموعة من التطبيقات والخدمات دون قراءة بنودها، ورْطة حقيقة، إذ تعمد هذه التطبيقات، فور الموافقة، إلى بيع البيانات لطرف ثالث قد يستغلها لأغراض التجسس، ولم تتوقف الشركات العملاقة (مثل غوغل وفيسبوك) عن ابتكار طُرُق جديدة لانتهاك البيانات الخاصة، واستغلالها، مباشرة أو عبر طرف ثالث، لأغراض تجارية وسياسية وعسكرية، وأعمال تجسس، ونشر موقع "نيويورك تايمز" مقالا (23 تشرسن الثاني/نوفمبر 2020) يوضّح أنه "حالما يتم جمع البيانات الخاصة، يصير بإمكان أيّ كان الحصول عليها بمقابل، وإعادة بيعها، ولا توجد منافذ قانونية لطلب تعويضات من قيمة عملية البيع، بل هناك شركات تحاول خلق نظام جديد من "سمسرة البيانات" يعوّض النظام الحالي...
تُعتَبَرُ البيانات ثروةً، في عدة مجالات، وجمعت إحدى شركات التطبيقات الصحية البيانات من شركات تتوفر على السجلات الصحية للمرضى، ثم باعتها إلى باحثين وإلى شركات تجارية، بذريعة أن المرضى سوف يستفيدون من تقدّم البحوث، أو قد يحصلون على نسبة معينة من عمليات البيع، وهو أمر مجافي للواقع. أما مستخدمو تطبيق "مسلم برو" فقد قدم العديد منهم دعاوى قضائية، خاصة في أوروبا، من أجل فتح تحقيق في "انتهاك حقوق الإنسان، بواسطة الملفات أو تطبيقات إلكترونية"، و "خيانة الأمانة"، وتشكيل " خطر على حياة الآخرين "و"التواطؤ في القتل "، بالتعاون مع "القوات الخاصة" لأقوى جيش في العالم، ويتقاسم الجيش الأمريكي هذه البيانات الشخصية مع وكالات "إنفاذ القانون" الأمريكية، مثل الجمارك، وقوات حماية الحدود، وإدارة الهجرة، ووكالات حُكومية أخرى، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب. 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020)، وأورد موقع "سي إن إن" أن الشركة الأمريكية "إكس-مود" تتعقب 25 مليون جهاز داخل الولايات المتحدة كل شهر، و40 مليونا خارج الولايات المتحدة (منها تطبيقات مسلم برود )، في الاتحاد الأوروبي وأميركا الجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
الحرب الإعلامية الصهيونية بمواقع التواصل "الإجتماعي":
ارتبط استخدام شبكة الإنترنت في فلسطين المحتلة بالإحتلال ونتائجه وامتداداته الإعلامية، لأن الإتصالات (مثل أي جانب آخر من حياة الفلسطينِيِّين) تمر عبر سلطات الإحتلال، ولأنه احتلال من نوع خاص، يُزَيِّفُ تاريخ المكان وأهله، ويختلق وُجُودًا وهْمِيًّا لمجموعات بشرية جاءت من أوروبا ومن مناطق أخرى من العالم، مُدّعية أن علاقتها بهذا "المكان" قديمة، ما يستدعي طَرْدَ الشعب الفلسطيني من وطنه، ويُرَوِّجُ الإحتلال هذه الرواية بكافة الوسائل، ومنها وسائل الإتصال "الإجتماعي"، وخصوصًا شبكة "فيسبوك"، حيث يُروّجُ الإحتلال دعايته بشكل مَدْرُوس، وباللغة العربية، بعد أن استوطن الضُّبّاط الصهاينة شبكة "الجزيرة" القَطَرِية التي تستضيفهم، باستمرار، وتسْمَحُ لهم بنشر دعايتهم، منذ عُقُود.
يتوجّه جُزْءٌ من الدّعاية الصهيونية الحكومية مباشرة للفلسطينيين، بالإعتماد على أساليب مدروسة، هدفها غسيل الأدمغة، مع بث الإحباط، والحث على قُبُول "الأمر الواقع"، وهو ما أصبحت تُرَدّدُهُ العديد من وسائل الإعلام الرسمية العربية، ومن الحُكّام العرب، خصوصًا منذ أعلن أنور السادات "إن الولايات المتحدة (ومن ورائها الكيان الصهيوني) تمتلك 99% من أوراق الحل"، ولم تُؤَسِّس المخابرات والحكومة الصهيونية هذه المواقع لتناقش أيًّا كان، بل لتُؤَكِّدَ وجهة النّظر الصّهيونية، بأساليب تمرّست عليها الحركة الصهيونية، منذ تأسيسها، وجنّدت لها ما لديها من وسائل مالية وبشرية، لشراء الصّحف، منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ثم محطات الإذاعات والتلفزيون ودُور نَشْر الكُتُب، وشركات إنتاج المُسلسلات والأشرطة السينمائية، قبل أن تنتشر وسائط الإتصال المُسمّى "اجتماعي"، لينشر بها الكيان الصهيوني التطبيقات التي تُزيّف التاريخ والجغرافيا، وتكيّفت الحركة الصهيونية مع التغييرات، ومع التطور التكنولوجي، وأنشأت منظومة متكاملة تعمل على التّأثير في الرّأي العام الفلسطيني والعربي والعالمي، بالتوازي مع منطق القُوّة المُطلقة للجيش الذي تُزَوِّدُهُ القوة الإمبريالية العُظْمى (الإمبريالية الأمريكية) بأحدث أسلحة الفَتْك والدّمار، وتدرس الدعاية الصهيونية، بكافة أشكالها (في الإذاعة والتلفزيون والصحف والشبكة الإلكترونية...) الْفِئة المُستهدَفَة من الجمهور، لتوجيه الخطاب الذي تعتبره مناسبًا، من أجل تمرير نفس المضمون، ومن أجل كَسْر شوكة المقاومة وإظهارها كعمل عَبَثِي، مع تأكيد "حق" يهود العالم في استيطان فلسطين، ونفي "الآخر"، بدءًا من الفلسطيني والعربي، ومحاربة أي شكل من أشكال المعارضة، بالكلمة أو بمقاطعة الكيان الصهيوني أو بإظهار الوقائع التاريخية، ودعمت الإمبريالية الأمريكية الكيان الصهيوني وكافة أدوات الهيمنة والدّعاية التي أنشأها، بواسطة المنظمات الصهيونية الأمريكية التي أسست، منذ سنة 2003، شبكة من مؤسسات العلاقات العامة والدّعاية للدفاع عن الكيان الصهيوني، ولتعزيز "المُكتسبات" الصهيونية في مجالات الإعلام والمُسلسلات التلفزيونية والسينما الأمريكية (التي تُهيمن على الإتجاهات الإعلامية والفنية العالمية )، وأحصت بعض الدّراسات الفلسطينية بَثَّ سَنَوِيًّا، بين 2003 و 2019، ما لا يقل عن خمسة أشرطة ومُسلسلات درامية، أنتجها صهاينة، ونالت شهرة عالمية، وعلى نطاق واسع جدًّا، وخَدَمَت الدعاية الصهيونية، واختصت بعض منصّات البث التلفزيوني الرّقمي (مثل "نتفليكس" التي تُشغّل نحو 900 مهندس، و "إتش بي أُو") التي تجتذب الشباب، في بث الأعمال الدّرامية الصهيونية التي تحطُّ من قيمة وقدر الفلسطيني والعربي وتُجرّدُهُ من إنسانيته، فهو غير قادر وغير مُؤَهّل ليحكم نفسه، مقابل التّفَوُّق المادّي والأخلاقي للعدو، الذي يُمثّل امتدادًا للمشروع "الحضاري" للإمبريالية الأوروبية والأمريكية، ما يُبرٍّرُ الإحتلال والإغتيال والإعتقال والتّهجير، و"إحلال التّقَدّم والمَدَنِيّة، محلّ التّخلّف والهمَجِيّة"، بحسب "ثيودور هرتزل"، أحد مؤسسي الحركة الصهيونية، في القرن التاسع عشر...
أنشأ الكيان الصهيوني، منذ سنة 1965، إذاعة رسمية، ناطقة بالعربية، وتبث الأغاني العربية، وتطورت هذه الدّعاية مع تطور وسائل الإعلام، ومع انتشار استخدام الشبكة الإلكترونية، وتنوعت الأشكال والمضامين، دون أن تحيد عن البرامج والأهداف الصّهيونية، وأنشأت أداة استخباراتية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، تحت إسم "إذاعة المُنسّق"، التي يُشرف عليها جهاز "الأمن الدّاخلي" (شاباك) بهدف تشويه مبدأ وفكر وممارسة المُقاومة، بالإضافة إلى العديد من المواقع والصفحات غير المُعلَنَة، والتي يعسر، في البداية، رَبْطُها بالمخابرات الصهيونية.
اللغة والثقافة العربيّتَان في الدعاية الصهيونية:
يستغل الكيان الصّهيوني التراث الثقافي العربي، للتوجّه إلى الفلسطينيين والعرب، باللغة العربية، وباستخدام أغاني أم كلثوم وفيروز، وصباح فخري، وغير ذلك، عبر إذاعة "صوت إسرائيل"، باللغة العربية، وأشرفت المخابرات الصهيونية (والجيش) على إنتاج مسرحية موسيقية عن سيرة "أم كلثوم"، بهدف تمرير الإيديولوجيا الصهيونية بأشكال "ناعمة"، إلى جانب القوة العسكرية والأسلحة الفتاكة والمجازر، كما يستغل الكيان الصهيوني بشكل كبير مواقع التواصل "الاجتماعي"، للتأثير في الرأي العام العربي والعالمي، وخاصة في فئة الشّباب، وأنشأ صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، بهدف "تنظيف" الكيان الصهيوني من كل الجرائم، وتغيير صورة الإحتلال الإستيطاني لدى الشباب العربي، واستكمال ما بدأته السينما الأمريكية (هوليود) منذ أربعينيات القرن العشرين.
أصبحت وسائل الإتصال الحديثة تُركّز على تفوق العدو، ليس في المجال العسكري فحسب (بفضل الدعم الإمبريالي غير المحدود) بل في المجالات العلمية والثقافية والأدبية، وغيرها، بدعم من المؤسسات الإمبريالية، فكم من مجرم صهيوني حصل على جائزة نوبل للسلام، مثل رابين وبيغين وبيريز، ويستغل الكيان الصهيوني هذه الجوانب، والإنحياز الإمبريالي، ليبث دعايته "النّاعمة" وبلغتنا التي يُعاقَبُ الفلسطينيون الذين يتكلمونها في المتاجر والمَحلات والمُؤسّسات الصهيونية، في فلسطين المحتلّة...
خاتمة:
انتشر استخدام وسائل الإتصال "الإجتماعي"، وأصبح الأداة المُفضّلة للتواصل، والأوسع انتشارًا، والأرخص ثمنًا، لكن من يتحكّم بهذه الأدوات، ومن يُديرُها ويُشرف على تطويرها؟
إن الشركات الرأسمالية الإحتكارية التي أسّست هذه الشبكات تهدف استعادة المبالغ التي استثمرتها، وتحقيق أكبر قدر من الربح، لقاء هذه الخدمات، التي يتمثل الجانب الأهم منها في تجميع وتخزين بيانات ومميزات المستخدمين، وبيْعها إلى الشركات والحكومات والمؤسسات الرسمية، كالجيش وقوات الأمن، وتُشكّل هذه البيانات سلعةً أو "مُنْتَجًا" تحتاجه الشركات التجارية ومؤسسات الإستطلاع وسبْر الآراء، والأحزاب السياسية والحكومات، لمعرفة اتجاهات المُستهلكين، أو الرّأي العام، أو للتّأثير في شرائح معيّنة، وتشكيل وَعْيِها، بما يتّفق مع مصالح هذه الشركات أو هذا الأحزاب والحكومات...
نحن نَنْتَمِي إلى أُمّة مُضْطَهَدَة وواقعة تحت الإستعمار المباشر (فلسطين) ويستهدفها العدوان العسكري (ليبيا واليمن والعراق وسوريا...) وواقعة تحت الهيمنة الإمبريالية، وتتَعَرّض للتّقسيم والتّفتيت...
يتمثل الرّدّ الطبيعي للشعوب العربية في العمل على تحرير الأوطان، ومقاومة المُستعمر والقوى المُهيْمِنَة، والتّصَدِّي للنّهب والإستغلال الذي تُمارسه الشركات العابرة للقارات وَوُكَلاؤُها في الدّاخل، وهي مقاومة لن يُكتَبَ لها النجاح، إذا لم تكُنْ مُنظّمة وجماعية (وليست فردية)، وهي مقاومة حقيقية في الشوارع والسّاحات والمصانع والمزارع، وليست مقاومة "افتراضية"، دُون تَجْرِيد الفضاء الإفتراضي من دَوْرهِ في الدّعاية والتّحريض ونشر الوعي الثقافي والحضاري، لكن هذا الدّوْر ضئيل وثانوي، ما دامت شركات "فيسبوك" أو "غوغل"، أو غيرها تتحكم بقواعد الإستخدام، وبشكل ومحتوى وتقنيات هذه الأدوات...
تمكّنت الإمبريالية والكيان الصّهيوني من استخدام هذه الأدوات، لأنها أدواتُها، وخلقَتْها من أجل إنجاز برامجَ وأهداف واضحة، خلافًا للمُستخدمين الأفراد، وخاصّة من الشباب، الذين تقمعهم الأنظمة المحلّية، وتحرمهم من حرية الرأي والتعبير، في ظل ارتفاع البطالة والفَقْر، وعندما تكون هذه الشرائح من المجتمع غير مُحصّنة، سياسيا وثقافيا وحضاريّا، تكون عُرضة للإختراق ولتشويه الوعي ولتزييف التاريخ.
يشكّل الإنتاج المُقاوم أو البديل جزءًا صغيرًا جدًّا من محتوى وسائل التّواصل "الإجتماعي"، ولكن لا خيار لنا سوى المُقومة بمختلف الأساليب والوسائل...
 Hitskin.com
Hitskin.com