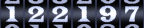أصول الفقه
إن أغلب الأبحاث الثقافية والعلمية تقوم على أسس أو قواعد وحقائق تقوم عليها، ليكون التفكير صادراً عن قواعد صلبة وحقائق راسخة لكي يتأتى الوصول إلى الغاية المقصودة من هذا التفكير، ولتكون الثمرة المرجوة من هذا العلم أو الثقافة ثمرة نافعة للإنسان، فتعطي الفكر الصحيح أو الصائب الذي يعالج مشاكل الانسان والأخطار المحدقة به، وإلا فإن هذه العلوم والثقافة تكون وبالاَ على الانسان وسبباً في ضلاله وهلاكه.
وأصول الفقه جزء من الثقافة الإسلامية، وهي من الجزء الأساس لأن عليه يقوم حسن فهم الإسلام وأحكامه، فهو يحدد طريقة الإسلام في فهم الإسلام واستنباط أحكامه، ويرسخ لبنة الشرعية للنصوص الشرعية لكي تكون النظرة عند المسلمين هي النظرة الإسلامية في معالجة الوقائع المتعلقة بالحياة، وبهذا يكون أساس النظرة واحدة عند المسلمين، وإن اختلفوا في فهم بعض النصوص التي تحتمل عدة أفهام، حسب المعارف اللغوية والشرعية.
يعتبر الشافعي أنه الذي حد أصول الاستنباط وضبطه بقواعد عامة كلية، فكان بذلك واضع علم أصول الفقه. وقد كان الفقهاء قبل الشافعي من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يجتهدون من غير أن يكون بين أيديهم حدود مرسومة للاستنباط، بل كانوا يعتمدون على فهمهم لمعاني الشريعة، ومرامي احكامها، وغاياتها، وما تومئ إليه نصوصها، وما تشير إليه مقاصدها. إذ أن تمرس هؤلاء الفقهاء بدراسة الشريعة، وتضلعهم في اللغة العربية، جعلهم يتعرفون معانيها، ويدركون أغراضها ومقاصدها. فكانوا يوفقون في إستنباط الأحاكم من النصوص ومفاهيمها ومقاصدها، من غير أن تكون بين أيديهم حدود مدونة مرسومة. نعم إن الفقهاء قبل الشافعي كانوا يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، كما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تحدث بالمطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ. إلا أن ذلك لم يكن بشكل حدوداً مرسومة، ولا كان لهؤلاء الفقهاء الذين تكلموا في بعض مسائل أصول الفقه قوعد عامة كلية يرجع إليها في معرفة دلائل الشريعة في كيفية معارضاتها وترجيحاتها. حتى إذا جاء الشافعي استنبط علم اصول الفقه، ووضع للناس قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع.
وعليه فقد كان المسلمون في فجر الإسلام حتى نهاية القرن الثاني، لا يحتاجون إلى قواعد معينة لفهم النصوص الشرعية واستنباط أحكامها، لا من الناحية اللغوية، ولا من الناحية الشرعية، نظراً لقرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصرف عنايتهم في الحياة إلى الدين، ونظراً لسلامة سليقتهم اللغوية وبعدهم عن فساد اللسان. ولذلك لم تكن هنالك أي شروط معروفة للاجتهاد وكان الاجتهاد أمراً مألوفاً، ولم تكن الحاجة ماسة لوضع قواعد لاستنباط الأحكام وفهم النصوص. فكان المجتهدون يعدون بالآلاف. فقد كان كافة الصحابة مجتهدين، ويكاد يكون أكثر الحكام والولاة والقضاة من المجتهدين، إلا أنه لما فسد اللسان العربي ووضعت قواعد معينة لضبطه، وشغل الناس بالدنيا، وقلَّ من يفرغ أكثر وقته للدين، وفشا الكذب في الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت قواعد للناسخ والمنسوخ، ولأخذ الحديث أو رفضه، ولفهم كيفية استنباط الحكم من الآية أو الحديث، كل ذلك كان سبباً في ضرورة وضع علم أصول الفقه كما وضع علم اللغة العربية وعلم الفقه والحديث، ومن هنا يدرك قيمة أصول الفقه وأهميته في ديمومة سيطرة النظرة الإسلامية على المسلمين في فهم نصوص الشرع ومعالجة الوقائع مهما تجددت حسب أحكام الشرع.
وأصول الفقه هو القواعد التي يبتنى عليه الفقه، اي أن موضوع أصول الفقه هو القواعد التي على أساسها يمكن فهم الفقه الإسلامي أي الأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة الشرعية، فهو يمَكننا من استنباط الأحكام، وفهم أصول الفقه ليصبح المسلم واعياً على أسس الأحكام وكيفية استنباطها، فهو أساس لمن يطمح أن يكون من المجتهدين، كما أنه يرسخ العمق في التفكير ويسهم في بناء المفكرين.
وبحث أصول الفقه بحث في القواعد، وفي الأدلة، أي بحث في الحكم وفي مصادر الحكم، وفي كيفية استنباط الحكم من هذه المصادر. وتشمل أصول الفقه الأدلة الاجمالية (كمطلق الامر، ومطلق النهي، وفعل النبي عليه السلام، وإجماع الصحابة، والقياس) وجهات دلالتها على الاحكام الشرعية، وحال المستدل أي معرفة الإجتهاد وكيفية الاستدلال وهو التعادل والتراجيح في الأدلة. إلا أن الاجتهاد والترجيح بين الأدلة يتوقف على معرفة الأدلة، وجهات دلالتها. ولذلك كان هذان البحثان: الأدلة، وجهة دلالتها، هما أساس أصول الفقه مع بحث الحكم ومتعلقاته.
ونصوص الشريعة الإسلامية تستوجب من المسلمين الإجتهاد، والإجتهاد يقوم على قواعد فلا بد من معرفتها قبل القيام بعملية الإجتهاد.
والإجتهاد هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية الواردة في النصوص الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه. فالإجتهاد هو استنباط الحكم من النص، إما من منطوقه، أو من مفهمومه، أو من العلة التي وردت في النص.
والإجتهاد ثايت بنص الحديث. فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأبي موسى حين وجهه إلى اليمن: “ أقض بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله، فإن لم تجد فاجتهد رأيك”. والإجتهاد فرض على الكفاية على المسلمين، إن أقامه البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقمه أحد أثم المسلمون جميعاً في ذلك العصر الذي لا يوجد فيه مجتهد.
ولذلك لا يجوز أن يخلو عصر من مجتهد مطلقاً، ولما كان الإجتهاد يحتاج إلى المعارف اللغوية والشرعية، أي يحتاج إلى معرفة القواعد، لذلك كان تعلم أصول الفقه فرض على الكفاية لكي يسهم هذا التعلم في بناء المجتهدين.
وأمر الإجتهاد محصور في فهم النصوص الشرعية بعد بذل أقصى الجهد في سبيل الوصول إلى هذا الفهم لمعرفة حكم الله، والنصوص الشرعية هي محل الفهم، وهي محل طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية. والنصوص الشرعية هي الكتاب والسنة ليس غير وما عداهما من النصوص لا يعتبر من النصوص الشرعية مهما كانت منزلة قائلها.
والكتاب والسنة كلام عربي جاء بهما الوحي من عند الله إما لفظاً ومعنى وهو القرآن، وإما معنى فحسب، وعبر الرسول عن هذا المعنى بألفاظ من عنده وهو الحديث، ولفظ الكتاب والسنة إما أن يكون له معنى لغوي فحسب مثل كلمة مترفين، وإما أن يكون له معنى شرعي كالصلاة وتنوسي المعنى اللغوي وإن كان له معنى لغوي وورد في القرآن والسنة بالمعنى اللغوي ولكنه ورد بشكل قليل فأصبح المعنى الشرعي هو المعني البارز والمعروف والمشهور عند المسلمين، وإما أن يكون له معنى لغوي ومعنى شرعي كالطهارة مثلاً.
ومن هنا صار فهم النصوص الشرعية يعتمد على المعارف اللغوية والمعارف الشرعية، لذلك كان لزاماً على المسلمين دراسة علم أصول الفقه والمحافظة عليه نقيا صافياً لأن عليه يعتمد إحسان فهم الإسلام واستنباط أحكامه، وبالتالي إحسان تطبيقه وحمله رسالة للعلم بالدعوة والجهاد.
صحيح أن هنالك إختلاف بين علماء الأصول، إلا أن هذا الإختلاف هو ضمن إطار الإسلام، وكل من يفهم أحكام الإسلام حسب أصل من هذه الأصول يعتبر فهمه فهماً شرعياً، إلا أن الغرب وأدواته من علماء السلاطين بعد أن أدركوا أهمية أصول الفقه عند المسلمين وأدركوا آثاره الهائلة والعظيمة في المحافظة على فهم الإسلام فهماً صحيحاً وفق طريقة الإسلام في الفهم، قام الغرب عن طريق أدواته بالتشكيك في الأصول تارة وباحتواء مضمونه تارة أخرى لحرف المسلمين عن الفهم الصحيح للإسلام، فتذرع هؤلاء أن علم الأصول غير مهم للإسلام والحاجة ليست ماسة إليه لأنه وجد بعد عصر الصحابة وأننا يجب علينا أن نفهم الإسلام كما فهمه الصحابة من غير حاجة إلى أصول الفقه، كما أن الغرب قام بمحاولات عن طريق أدواته بتغيير قواعد وحقائق واضافة قواعد تتعارض مع الإسلام وأصول أحكامه لكي يبعد المسلمين عن حسن فهم الإسلام تحت ذرائع التجديد وفقه الواقع وفقه الموازنات وغير ذلك من الشعارات.
صحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أقدر الناس على فهم الإسلام لأنهم من أعلم الناس بالعربية، ولأنهم شاهدوا الظروف والوقائع التي نزل فيها القرآن، وكان الرسول عليه السلام يبين لهم المعاني الشرعية والأحكام التي تلزمهم في حياتهم، وكان الإسلام مركز التنبه فيهم والشغل الشاغل لهم، لذلك كانوا يملكون الوسائل التي تمكنهم من فهم الإسلام، وقد كان الرسول بينهم وهم ملازمين له، لذلك لم تكن الحاجة ماسة لكي يعرفوا القواعد المتعلقة بالأصول لأن مضمونها موجود لديهم، فالمعارف اللغوية والشرعية التي هي أساس أبحاث الأصول موجودة عندهم، بخلاف المسلمين اليوم فهم بحاجة ماسة لمعرفة هذه المعارف ليتأتى لهم التفكير بالنصوص الشرعية تفكيراً حسب النظرة الإسلامية التي كانت موجودة عنده الصحابة والفقهاء الذين جاءوا بعدهم. أما بالنسبة لمسألة الأحتواء للأصول فإن الواعي على الإسلام وعلى أصوله أي أصول الأحكام يبدد عملية الأحتواء ويكشف زيف القواعد التي نسبت إلى الإسلام والإسلام بريء منها كقاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان.
والكتاب والسنة كلام عربي فلا بد من معرفة اللغة العربية ومعرفة أقسامها، كالمنطوق والمفهوم، والحقيقة والمجاز، والإشتراك والترادف والإنفراد، ومعاني الحروف، والنحو والصرف، ونحو ذلك من الابحاث المتعلقة باللغة العربية.
وألفاظ الكتاب والسنة نصوص تشريعية، ولمعرفة كيفية الإستدلال بها على الأحكام الشرعية لا يكفي فيها معرفة اللغة العربية ومعرفة أقسامها، بل لا بد أيضاً من معرفة أقسام الكتاب والسنة من حيث الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، والمجمل والبيان والمبين، والناسخ والمنسوخ.
وعليه فإن التفكير في النصوص الشرعية والوقوف على ما تحتويه هذه النصوص من أفكار، والوصول إلى إستنباط الأفكار، لا يكفي فيه أن يفهم الألفاظ والتراكيب وما تدل عليه، ولا يحتاج إلى معلومات سابقة أية معلومات، وإنما يحتاج إلى أمرين إثنين معاً:
يحتاج أولاً إلى معرفة دلالة الألفاظ والتراكيب، ثم المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ والتراكيب، ثم إستعمال معلومات معينة للوقوف على الفكر أو استنباط الفكر.
أما معرفة معاني الألفاظ والتراكيب، فإنه يحتاج إلى معرفة باللغة ألفاظاً وتراكيب، ويحتاج إلى معرفة إصطلاحات معينة ثم بعد ذلك يأتي الوقوف على الأفكار والأحكام.
وعليه فالتفكير بالنصوص الشرعية يحتاج إلى وجود معلومات كافية عن اللغة العربية، والأمور الشرعية، ومعرفة حقيقة الواقع، وانطباق الحكم الشرعي على ذلك الواقع، وإنه وإن كان الانطباق ليس من المعارف اللازمة للاستنباط ولكنه نتيجة لصحة المعرفة للأمور الثلاثة.
ومن هنا كان للإسلام طريقة واحدة في الإجتهاد أي معالجة المشاكل، فهو يدعو المجتهد لأن يدرس المشكلة الحادثة حتى يفهمها، ثم يدرس النصوص الشرعية المتعلقة بهذه المشكلة، ثم يستنبط حل هذه المشكلة وطريقة حلها من النصوص، أي يستنبط الحكم الشرعي لهذه المسألة من الأدلة الشرعية، ولا يسلك طريقة غيرها مطلقاً. على أنه حين يدرس هذه المشكلة، يدرسها باعتبارها مشكلة إنسانية ليس غير، لا باعتبارها مشكلة اقتصادية أو اجتماعية أو مشكلة حكم أو غير ذلك، بل باعتبارها مسألة تحتاج إلى حكم شرعي حتى يعرف حكم الله فيها.
والنصوص الشرعية سواء أكانت من الكتاب أم من السنة هي أصلح النصوص التشريعية ميداناً للتفكير، وأفسحها مجالاً للتعميم، وأخصبها تربة لإنبات القواعد العامة، وهي وحدها التي تصلح لأن تكون نصوصاً تشريعية لجميع الشعوب والأمم.
أما كونها أصلح النصوص ميداناً للتفكير فإنه بارز في إحاطتها بجميع أنواع العلاقات بين الناس جميعاً. ذلك أن جميع أنواع العلاقات سواء أكانت علاقات بين الأفراد بعضهم مع بعض، أم علاقات بين الدولة والرعية، أم علاقات بين الدول والشعوب والأمم، فإنها مهما تجددت وتعددت وتنوعت يمكن للفكر أن يستنبط أحكامها من هذه النصوص الشرعية، فهي أصلح النصوص ميداناً للتفكير بين جميع النصوص التشريعية.
وأما كونها أصلح النصوص مجالاً للتعميم، فإنه واضح في جملها وألفاظها وأسلوب سبكها من حيث شمولها للمنطوق والمفهوم وللدلالة وللتعليل ولقياس العلة، مما يجعل الإستنباط متيسراً ودائمياً وشاملاً لكل عمل، مما يجعلها غير قاصرة عن شمول أي شيء بل كاملة عامة.
وأما كونها أخصب النصوص لانبات القواعد العامة، فإنه ظاهر في غزارة المعاني العامة التي تحتويها هذه النصوص. وظاهر في طبيعة هذه المعاني العامة. ذلك أن القرآن والحديث قد جاءا خطوطاً عريضة حتى عند التعرض للتفصيلات. وطبيعة الخطوط العريضة يجعلها معاني عامة تندرج تحتها التفصيلات، ومن هنا جاءت غزارة المعاني العامة.
وفوق ذلك فإن مدلولات هذه المعاني العامة أمور واقعية محسوسة، وليست من الأمور الفرضية نظرياً أو منطقياً. وهي في نفس الوقت لعلاج الإنسان وليست لعلاج أفراد معينين، أي لبيان حكم فعل الإنسان مهما كان مظهر الغريزة الدافع لهذا الفعل، ولذلك جاءت منطبقة على معان متعددة وأحكام كثيرة. وبهذا كله كانت النصوص الشرعية أخصب النصوص تربة لانبات القواعد العامة.
هذه هي حقيقة النصوص الشرعية من الناحية التشريعية. وإذا أضيف إلى ذلك أنها جاءت لبني الإنسان من حيث هو إنسان، وكانت تشريعا لجميع الأمم والشعوب، يتبين أنه لا بد من وجود مجتهدين لفهمها فهماً تشريعياً وتطبيقها في كل وقت لأخذ الحكم الشرعي منها لكل حادثة.
والحوادث تتجدد كل يوم ولا تدخل تحت حصر، فلا بد من مجتهد يستنبط حكم الله لكل حادثة تحدث وإلا لبقيت الحوادث دون معرفة حكم الله فيها، وهذا لا يجوز، ومن هنا كان لزاماً على الأمة الإسلامية الإهتمام بأصول الفقه لكي ينبت فبها الحشد الهائل من المجتهدين.
وتجدر الإشارة هنا إلا أنه لا يحق لنا أن نبحث إلا في التشريع الإسلامي لأن الأمر الجازم الذي تحتمه عقيدتنا، يحصر تفكيرنا بالتشريع الإسلامي وحده. وأما غير التشريع الإسلامي فلا يحق لنا أن نبحثه، حتى ولا أن نقرأه. فإن التشريع حين يقرأ إنما يقرأ من أجل الأخذ بما جاء فيه، وليس قراءة متعه ولذة. وحين يبحث ويجري التفكير فيه إنما يفعل ذلك من أجل أخذه، ويحرم علينا أخذ شيء من غير الإسلام، ويحرم علينا أن نأخذ غير الحكم الشرعي بغض النظر عن كون هذا التشريع الآخر يوافق الإسلام أو يعارضة لأنه شرع طاغوت، والقرآن نهانا عنه بشكل صريح.
 Hitskin.com
Hitskin.com