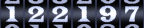الزهايمر" لهنادي زرقه: روح الطفلة الناضجة / رباب هلال
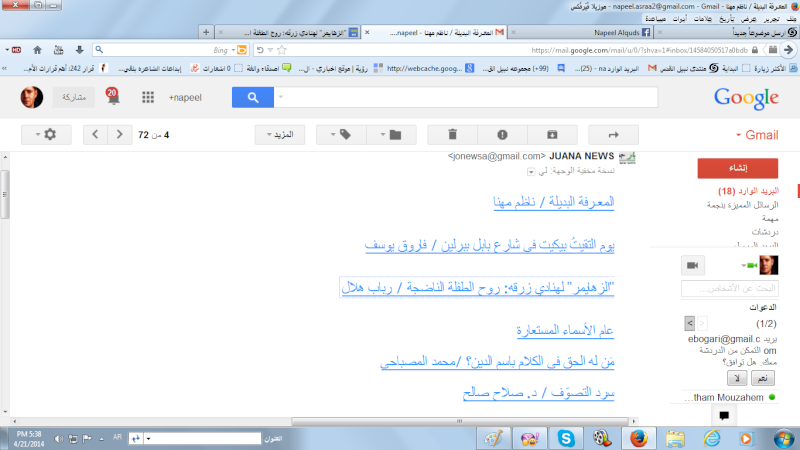
هو الشعر مرة أخرى فسحة هنادي زرقه الوحيدة للهرولة بعيداً عن أصفاد الزمن، وعمّا تجدله، بلا رحمة، حول روحها أسلاك المحيط/ المجتمع الشائكة. مرات ثلاث سابقة حطت فيها هنادي زرقه بصمتها الشعرية الفارقة، منذ أول مجموعة لها «على غفلة من يديك» 2001، تبعتها «إعادة الفوضى إلى مكانها» 2004، ثمّ «زائد عن حاجتي» 2008، وحديثاً «الزهايمر» 2014.
قصائد جديدة، استهلتها بـ: أحسدُ مرضى الزهايمر/ لا فرح/ لا حزن/ لا ألم/ يعيشون طفولتهم مرتين./ بهذه الكلمات الموجزة تكثف هنادي زرقه بوابتها العريضة، تقتحم بكارة درب في موضوعات الشعر العربي: الزهايمر.
تعجز الأمّ وتصاب بالزهايمر، فيحدث أن تصير الابنة حاضنة للأمّ عاجزة الذاكرة وفاقدة الجسد المشتعل. في القصائد إذن أم وابنة، تستحضران في الذاكرة ما حدثنا به علم النفس، وما سردته بعض النصوص الأدبية النثرية، عن تلك العلاقة الشائكة بين الأم وابنتها.
وهنا امرأتان تتجاذبان أطراف القصائد. فكلتاهما الأم والابنة حواء؛ السيدة الولود، كلتاهما إلهة الخصب والحياة، هما نديتان إذن! وما يحدث الآن، أن الزهايمر أطاح بالسيدة الكبرى عن العرش، ووهب الابنة نُدْحته المغوية!
بشجاعة يانعة الاخضرار، تغوص هنادي في الذات، على مدرج الصدق تسفح مشاعرها، وهي تسرد يومياتها مع أمّ كانت سيدة الحضن الدافئ، ووسادة دمع التعب، أمّ كانت أيضاً الحاكمة المستبدة القامعةّ، بيدها مفتاح الباب الذي أوصدته على حلم الابنة بالطيران والتحليق في فضاءات الحياة رحيبة الاشتهاء! فينبثق الصراع ويتلوّن بتلوّنات النفس البشرية وأمزجتها المحيّرة حدّ العراك. هنا الشعر مرآة للذات البشرية، ذات الشاعرة وذواتنا نحن القارئات خاصّة! فنهيم بأُخْذة الصراع، نشمت حيناً ونفرح حيناً آخر، وقد تعترف كلّ واحدة منّا، بأنها ليست الوحيدة الملتاثة بشهوة التنافس إذن! الطافحة بلوثة الرفض والاستقلال والتشفي والانتقام، لوثة مجبولة برعش الحب لأمها!
فلنقرأ جذاذة من أول القصائد، «سأعتاد غيابك»:.../ إزاء نظراتكِ التائهة/ التي تستقرئ المكان/ كلما استيقظتِ/ وأمسكتِ يدي/ وطلبتِ مني أن أمضي معكِ/ إلى أماكن لا أعرفها/ سأعترف/ إنني كثيراً ما تواريت أمامك مدحورة/ لكنني على الرغم من كل هزيمتي/ سأعتاد غيابك./ مزاجك... لم يكن يوماً يشبه مزاجي/... / سأنزع يدي بقوة من يديك/ وأخبط الباب بعنف/ وأنظر إلى البيت/ كما لو كان خالياً/ سأعدّ الشاي لشخص واحد/ وأدخن في كل الغرف/ أنشر ثيابي على كل الأسرة./ لن أطبخ/ أعرف أنك تحبين ما أطبخه،/ نعم.../ أخيراً سأكفّ عن الأعمال المنزلية/ أكتب الشعر الذي تكرهين./
لكنها لا تلبث أن تعترف بفشل ثورتها، آن تشعر بخوف الانفصال، وانقطاع جادّ لحبل السرة، وغياب الأم وزوال سلطتها، تروّعها الوحدة الموحشة، إذ ترد في بعض المواطن الأخرى حبل إنقاذها، خالقة حالة من توسّل التشابه بينهما، وتوسّل عودة الأمور إلى نصابها أحياناً، كما في «قطعة جبن متعفنة لا أكثر»:
أستلقي إلى جانبك كالنعاس،/ أرقب الهواء الداخل/ إلى رئتيكِ/ صعوداً/ هبوطاً/ أتصيد أحلام غفوة قرب حياة/ بدأت تخط تجاعيدها حتى على روحي./ إلى أن تنضح أمنية بقاء الأم إلى جانبها: لو أنك تعودين/ كما كنتِ، أمي،/ وأعود كما كنتُ، ابنتك العاصية،/ لو أنك فقط لا تنصاعين إلى أوامري لما أطلبه منك،/ وتصرّين: مازلتُ أمك/ مازلت أمّكِ./
لا قداسة
تدمج هنادي الآني بالديمومي، من دون أن يفلت لسانها فيض الشعر في أكثر قصائدها، تدخلنا في مسرود يومياتها/ يومياتنا ترينا ما نراه، وتعرّفنا بما نعرفه، إنما على غفلة منّا واستغفال، خوفاً من مسّ المقدّس العلويّ والأرضيّ في آن معاً، فتعيد لنا ما نعيشه إنما في زرقة الخيال، تطهرنا من هباب الشعور بالذنب. ولأنها شاعرة انتبهت، فرأت، كسّرت الصمت وحكت، مثل ذلك هي الطفل الذي أشار إلى عري الملك!
إذن لا قداسة لشيء في الشعر وفي الطفولة، كأنما تحاول هنادي زرقه الانعتاق من النفاق الأسود والاستكانة في ملكوت الحقيقة الأبيض.
تشيل هنادي العادي البسيط في حياتنا، وتلمّ المشاهد اليومية المألوفة لحياتنا الرتيبة، تلوّنها ببسيط الكلام وموجزه، ثم تعجنها بماء التكثيف المركز في كثير من المطارح، لتطلقها في أغوار لوحتها، وتزركش بها الأبعاد والمسافات، مستبعدة أي إطار، لتنفتح لوحتها إلى أمداء لامتناهية، يغوص فيها القارئ متحرراً من سطوة القول الفصيح، وسلطة المعنى الوحيد، فتتعدّد القراءات وتتلوَن بحسب لون قارئها. ولتحقق هنادي عنصر الإقناع في صدق القول والشعور، هي التي تثور لنيل حريتها، تكتب النصّ الحرّ تروم للقارئ حريته هو الآخر. هو الصدق ترياق الشعر.
في «الزهايمر» تتعرّى روح هنادي الطفلة، طفلة لا تعرف الكذب، وقحة في صراحتها وصلفة. لدرجة أجدني كقارئة يستوقفني السؤال وترتديني غبطة كشف المستور ومتعته إزاء تقمّص الابنة الكبيرة الناضجة روح الطفلة التي كانتها في زمن لن يعود! فهل لجأت إليها للهروب من الإحساس بالذنب حيال ما تشعر به من قوة وسطوة، وقد آلت الآن السلطة إليها؟ أم أنها إحدى التقنيات التي تجهد هنادي كعادتها في إظهارها ممحوضة المباغتة والطرافة، يانعة الدهشة؟! فحين ترتاح من صراعها المضني وممّا شاقته للفرار من الأسر والخلاص والتحرر من نير الأمومة، تبدأ بالانتقام مثل طفلة تشاكس أمها وتناكدها، ناثرة كينونتها العاصية في بعض المواضع من القصائد، أو تقرّها في قصيدة تخصّ تلك الطفلة وحدها، كأنما تبحث عن مكان لها وحدها لإنزال حمولة المسؤولية الثقيلة عن كاهلها الراشد، فتحط رحال قصيدة في الموضع الأثير لديها؛ الطفولة، بعنوان «أمي والذئب»، تأخذ عبرها تعابير وجوه أرواحنا المشحونة بسخام الأسى إلى بهرة البساطة والطزاجة ودهشة الطرافة اليانعة، وعبر استخدامها الرمز المدجج بحكاية من تراث البشرية الذكوري، حكاية منتقاة بعناية الأنثى الواعية المثقفة الرافضة للخضوع والاستلاب، من كلّ حدب وصوب كان، تزعزع المقدس المخاتل: الحكاية، الأم، أو سدنة البطريركية الذكورية، وقد قوّضت الحكاية الشهيرة ببراءتها المزعومة، ودمرتها لتبني على ظلالها حكاية أنثى الحلم/ الحرّة. فلنتأمل توازن ظاهر سطح القصيدة وقرار باطنها، تدهشنا لغة طفولية باذخة البساطة: أستيقظ في الليل/ عازمة أن أعقد صفقة مع الذئب!/ الذئب!/ لم لا؟!/ لن أركض وراء دجاجاتك إلى الأبد./ منذ أربعين عاماً وأنت توقظينني/ لأبحث عن دجاجاتك الضائعة./ لن أتعب نفسي في إقناعك/ بأنه لا خمّ لدينا./ كل ما سأقوله لك:/ نعم، / تركت الدجاجات تبيض أنّى تشاء/ تسرح مع الديكة في الليل/ في النهار... كما تشاء./ والأسوأ / أنني أرشدت الذئب إلى مواضعها./ صديقي: تعال، وكُلْ دجاجات أمي./
تتناسل أيضاً في القصائد المفارقات المربكة، والشاعرة تتأرجح ما بين الخسران والفوز، إذ تنغمر أيضاً بحس الذنب فتفقد البوصلة! كما في قصيدة «يحدث دائماً»:.../ أفتعل كل شيء/ لكي أنزع المريلة/ عن روحي./.../ كأنني أعاني سوء توجه/ بدل أن أطير/ كما يحدث للطائرات الورقية،/ أنزلق باكية إلى حضنك/ أعتذر عن الليلة التي آذيت فيها حبك./ إلى أن يصير الولوج من جديد في أسر الأمّ واستبدادها ملاذاً لها من سطوة الخارج الأكثرغشماً واستبداداً فيما يبدو، مثل اعترافها في «دمية عاقلة»:.../ سأمشي كما تشائين/ أنام متى تضعينني في حضنك/ أبكي/ أضحك/ تضفرين شعري كما تشائين/ أكون كما تريدين/ دمية عاقلة/ يويو/ أرقص وأغني حين تضجرين/... بمقدورك نزع البطارية متى تشائين/ إذ ليس بوسعي أن افعل شيئاً./ لكن لا ترميني بين أيديهم/ أرجوك... أرجوك/ العبي بي وحدك./ وتباغتنا الخاتمة وتبلبل الذهن واللّبّ! فمن هم أولئك الآخرون؟ هل هم الأخوة المشغولون بأعبائهم تاركين إيّاها وحيدة مع الزهايمر؟ أم أولئك الرجال الذين عجزت عن استبقائهم؟ أم هو المجتمع الذكوري الذي يعجزها ويحبط محاولاتها في أن تكون امرأة مختلفة عن نسائه؟! كومة أسئلة تنثّ من قصائد عديدة، ليُصان اخضرار الكلام الأنيف.
كما في أغلب خواتيم قصائدها، وكعادتها تصنع هنادي غابة خضراء نديّة، حيث تتشابك أفانين الحيرة المباغتة الماتعة المغوية، تظلّل القارئ بفيء الشعر، وتفاجئه بدروب مستترة تنبثق أمامه، وشعاب مشاكسة تتربص به، تأسره، فتستلبه متعة القراءة ثانية وثالثة. ورغبة الارتواء والامتلاء تسربله، فيشحط روحه الهابطة، الخاوية من الفرح والبياض، في زمن الارتواء بالدم البشري، إلى هدهدة يفاعة الدهشة وبكارة القول وسلاسة الكلام المهموس، وإلى بهجة تسمو بالروح إلى الأعلى.
كاتبة سورية*
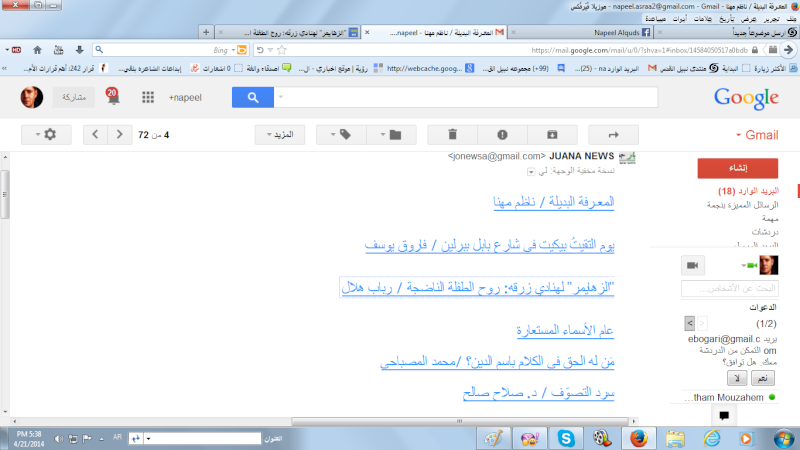
هو الشعر مرة أخرى فسحة هنادي زرقه الوحيدة للهرولة بعيداً عن أصفاد الزمن، وعمّا تجدله، بلا رحمة، حول روحها أسلاك المحيط/ المجتمع الشائكة. مرات ثلاث سابقة حطت فيها هنادي زرقه بصمتها الشعرية الفارقة، منذ أول مجموعة لها «على غفلة من يديك» 2001، تبعتها «إعادة الفوضى إلى مكانها» 2004، ثمّ «زائد عن حاجتي» 2008، وحديثاً «الزهايمر» 2014.
قصائد جديدة، استهلتها بـ: أحسدُ مرضى الزهايمر/ لا فرح/ لا حزن/ لا ألم/ يعيشون طفولتهم مرتين./ بهذه الكلمات الموجزة تكثف هنادي زرقه بوابتها العريضة، تقتحم بكارة درب في موضوعات الشعر العربي: الزهايمر.
تعجز الأمّ وتصاب بالزهايمر، فيحدث أن تصير الابنة حاضنة للأمّ عاجزة الذاكرة وفاقدة الجسد المشتعل. في القصائد إذن أم وابنة، تستحضران في الذاكرة ما حدثنا به علم النفس، وما سردته بعض النصوص الأدبية النثرية، عن تلك العلاقة الشائكة بين الأم وابنتها.
وهنا امرأتان تتجاذبان أطراف القصائد. فكلتاهما الأم والابنة حواء؛ السيدة الولود، كلتاهما إلهة الخصب والحياة، هما نديتان إذن! وما يحدث الآن، أن الزهايمر أطاح بالسيدة الكبرى عن العرش، ووهب الابنة نُدْحته المغوية!
بشجاعة يانعة الاخضرار، تغوص هنادي في الذات، على مدرج الصدق تسفح مشاعرها، وهي تسرد يومياتها مع أمّ كانت سيدة الحضن الدافئ، ووسادة دمع التعب، أمّ كانت أيضاً الحاكمة المستبدة القامعةّ، بيدها مفتاح الباب الذي أوصدته على حلم الابنة بالطيران والتحليق في فضاءات الحياة رحيبة الاشتهاء! فينبثق الصراع ويتلوّن بتلوّنات النفس البشرية وأمزجتها المحيّرة حدّ العراك. هنا الشعر مرآة للذات البشرية، ذات الشاعرة وذواتنا نحن القارئات خاصّة! فنهيم بأُخْذة الصراع، نشمت حيناً ونفرح حيناً آخر، وقد تعترف كلّ واحدة منّا، بأنها ليست الوحيدة الملتاثة بشهوة التنافس إذن! الطافحة بلوثة الرفض والاستقلال والتشفي والانتقام، لوثة مجبولة برعش الحب لأمها!
فلنقرأ جذاذة من أول القصائد، «سأعتاد غيابك»:.../ إزاء نظراتكِ التائهة/ التي تستقرئ المكان/ كلما استيقظتِ/ وأمسكتِ يدي/ وطلبتِ مني أن أمضي معكِ/ إلى أماكن لا أعرفها/ سأعترف/ إنني كثيراً ما تواريت أمامك مدحورة/ لكنني على الرغم من كل هزيمتي/ سأعتاد غيابك./ مزاجك... لم يكن يوماً يشبه مزاجي/... / سأنزع يدي بقوة من يديك/ وأخبط الباب بعنف/ وأنظر إلى البيت/ كما لو كان خالياً/ سأعدّ الشاي لشخص واحد/ وأدخن في كل الغرف/ أنشر ثيابي على كل الأسرة./ لن أطبخ/ أعرف أنك تحبين ما أطبخه،/ نعم.../ أخيراً سأكفّ عن الأعمال المنزلية/ أكتب الشعر الذي تكرهين./
لكنها لا تلبث أن تعترف بفشل ثورتها، آن تشعر بخوف الانفصال، وانقطاع جادّ لحبل السرة، وغياب الأم وزوال سلطتها، تروّعها الوحدة الموحشة، إذ ترد في بعض المواطن الأخرى حبل إنقاذها، خالقة حالة من توسّل التشابه بينهما، وتوسّل عودة الأمور إلى نصابها أحياناً، كما في «قطعة جبن متعفنة لا أكثر»:
أستلقي إلى جانبك كالنعاس،/ أرقب الهواء الداخل/ إلى رئتيكِ/ صعوداً/ هبوطاً/ أتصيد أحلام غفوة قرب حياة/ بدأت تخط تجاعيدها حتى على روحي./ إلى أن تنضح أمنية بقاء الأم إلى جانبها: لو أنك تعودين/ كما كنتِ، أمي،/ وأعود كما كنتُ، ابنتك العاصية،/ لو أنك فقط لا تنصاعين إلى أوامري لما أطلبه منك،/ وتصرّين: مازلتُ أمك/ مازلت أمّكِ./
لا قداسة
تدمج هنادي الآني بالديمومي، من دون أن يفلت لسانها فيض الشعر في أكثر قصائدها، تدخلنا في مسرود يومياتها/ يومياتنا ترينا ما نراه، وتعرّفنا بما نعرفه، إنما على غفلة منّا واستغفال، خوفاً من مسّ المقدّس العلويّ والأرضيّ في آن معاً، فتعيد لنا ما نعيشه إنما في زرقة الخيال، تطهرنا من هباب الشعور بالذنب. ولأنها شاعرة انتبهت، فرأت، كسّرت الصمت وحكت، مثل ذلك هي الطفل الذي أشار إلى عري الملك!
إذن لا قداسة لشيء في الشعر وفي الطفولة، كأنما تحاول هنادي زرقه الانعتاق من النفاق الأسود والاستكانة في ملكوت الحقيقة الأبيض.
تشيل هنادي العادي البسيط في حياتنا، وتلمّ المشاهد اليومية المألوفة لحياتنا الرتيبة، تلوّنها ببسيط الكلام وموجزه، ثم تعجنها بماء التكثيف المركز في كثير من المطارح، لتطلقها في أغوار لوحتها، وتزركش بها الأبعاد والمسافات، مستبعدة أي إطار، لتنفتح لوحتها إلى أمداء لامتناهية، يغوص فيها القارئ متحرراً من سطوة القول الفصيح، وسلطة المعنى الوحيد، فتتعدّد القراءات وتتلوَن بحسب لون قارئها. ولتحقق هنادي عنصر الإقناع في صدق القول والشعور، هي التي تثور لنيل حريتها، تكتب النصّ الحرّ تروم للقارئ حريته هو الآخر. هو الصدق ترياق الشعر.
في «الزهايمر» تتعرّى روح هنادي الطفلة، طفلة لا تعرف الكذب، وقحة في صراحتها وصلفة. لدرجة أجدني كقارئة يستوقفني السؤال وترتديني غبطة كشف المستور ومتعته إزاء تقمّص الابنة الكبيرة الناضجة روح الطفلة التي كانتها في زمن لن يعود! فهل لجأت إليها للهروب من الإحساس بالذنب حيال ما تشعر به من قوة وسطوة، وقد آلت الآن السلطة إليها؟ أم أنها إحدى التقنيات التي تجهد هنادي كعادتها في إظهارها ممحوضة المباغتة والطرافة، يانعة الدهشة؟! فحين ترتاح من صراعها المضني وممّا شاقته للفرار من الأسر والخلاص والتحرر من نير الأمومة، تبدأ بالانتقام مثل طفلة تشاكس أمها وتناكدها، ناثرة كينونتها العاصية في بعض المواضع من القصائد، أو تقرّها في قصيدة تخصّ تلك الطفلة وحدها، كأنما تبحث عن مكان لها وحدها لإنزال حمولة المسؤولية الثقيلة عن كاهلها الراشد، فتحط رحال قصيدة في الموضع الأثير لديها؛ الطفولة، بعنوان «أمي والذئب»، تأخذ عبرها تعابير وجوه أرواحنا المشحونة بسخام الأسى إلى بهرة البساطة والطزاجة ودهشة الطرافة اليانعة، وعبر استخدامها الرمز المدجج بحكاية من تراث البشرية الذكوري، حكاية منتقاة بعناية الأنثى الواعية المثقفة الرافضة للخضوع والاستلاب، من كلّ حدب وصوب كان، تزعزع المقدس المخاتل: الحكاية، الأم، أو سدنة البطريركية الذكورية، وقد قوّضت الحكاية الشهيرة ببراءتها المزعومة، ودمرتها لتبني على ظلالها حكاية أنثى الحلم/ الحرّة. فلنتأمل توازن ظاهر سطح القصيدة وقرار باطنها، تدهشنا لغة طفولية باذخة البساطة: أستيقظ في الليل/ عازمة أن أعقد صفقة مع الذئب!/ الذئب!/ لم لا؟!/ لن أركض وراء دجاجاتك إلى الأبد./ منذ أربعين عاماً وأنت توقظينني/ لأبحث عن دجاجاتك الضائعة./ لن أتعب نفسي في إقناعك/ بأنه لا خمّ لدينا./ كل ما سأقوله لك:/ نعم، / تركت الدجاجات تبيض أنّى تشاء/ تسرح مع الديكة في الليل/ في النهار... كما تشاء./ والأسوأ / أنني أرشدت الذئب إلى مواضعها./ صديقي: تعال، وكُلْ دجاجات أمي./
تتناسل أيضاً في القصائد المفارقات المربكة، والشاعرة تتأرجح ما بين الخسران والفوز، إذ تنغمر أيضاً بحس الذنب فتفقد البوصلة! كما في قصيدة «يحدث دائماً»:.../ أفتعل كل شيء/ لكي أنزع المريلة/ عن روحي./.../ كأنني أعاني سوء توجه/ بدل أن أطير/ كما يحدث للطائرات الورقية،/ أنزلق باكية إلى حضنك/ أعتذر عن الليلة التي آذيت فيها حبك./ إلى أن يصير الولوج من جديد في أسر الأمّ واستبدادها ملاذاً لها من سطوة الخارج الأكثرغشماً واستبداداً فيما يبدو، مثل اعترافها في «دمية عاقلة»:.../ سأمشي كما تشائين/ أنام متى تضعينني في حضنك/ أبكي/ أضحك/ تضفرين شعري كما تشائين/ أكون كما تريدين/ دمية عاقلة/ يويو/ أرقص وأغني حين تضجرين/... بمقدورك نزع البطارية متى تشائين/ إذ ليس بوسعي أن افعل شيئاً./ لكن لا ترميني بين أيديهم/ أرجوك... أرجوك/ العبي بي وحدك./ وتباغتنا الخاتمة وتبلبل الذهن واللّبّ! فمن هم أولئك الآخرون؟ هل هم الأخوة المشغولون بأعبائهم تاركين إيّاها وحيدة مع الزهايمر؟ أم أولئك الرجال الذين عجزت عن استبقائهم؟ أم هو المجتمع الذكوري الذي يعجزها ويحبط محاولاتها في أن تكون امرأة مختلفة عن نسائه؟! كومة أسئلة تنثّ من قصائد عديدة، ليُصان اخضرار الكلام الأنيف.
كما في أغلب خواتيم قصائدها، وكعادتها تصنع هنادي غابة خضراء نديّة، حيث تتشابك أفانين الحيرة المباغتة الماتعة المغوية، تظلّل القارئ بفيء الشعر، وتفاجئه بدروب مستترة تنبثق أمامه، وشعاب مشاكسة تتربص به، تأسره، فتستلبه متعة القراءة ثانية وثالثة. ورغبة الارتواء والامتلاء تسربله، فيشحط روحه الهابطة، الخاوية من الفرح والبياض، في زمن الارتواء بالدم البشري، إلى هدهدة يفاعة الدهشة وبكارة القول وسلاسة الكلام المهموس، وإلى بهجة تسمو بالروح إلى الأعلى.
كاتبة سورية*
 Hitskin.com
Hitskin.com