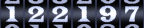واقع النظام الدولي: قراءة في الميديا الغربية
12615
0
د. أكرم حجازي
أفريل/ نيسان 2016
مقدمة
ثمة فرق كبير، بين دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب إلى « إقامة نظام دولي جديد» في أعقاب حرب الخليج الثانية سنة 1992، وبين الحديث عن « إعادة بناء النظام الدولي»!! تلك؛ كانت دعوة تستهدف بالدرجة الأساس تعزيز الهيمنة الأمريكية على العالم، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وإحكام السيطرة على العالم الإسلامي على وجه الخصوص، وفي القلب منه العالم العربي. لكن الأحداث قلبت الدعوة إلى قلق، يتعاظم بسرعة سيبيرية، حتى بتنا نراقب نقاشات وتصريحات ودعوات وأطروحات، تتحدث ليس عن تراجع النفوذ الأمريكي وانحسار الهيمنة والتفكير بفك الارتباط، بل وعن فراغ في القيادة، وتعطل في اشتغال النظام الدولي، وحتى عن لحظة « انهيار النظام الدولي».
يتحدث وزير الخارجية الألماني السابق، Joschka Fischer، الغارق في مشكلات النظام الدولي، عن مفارقة ظريفة للغاية، وهو يستذكر نشوة الأمريكي الياباني، فرانسيس فوكوياما، عن « الإنسان الأخير ونهاية التاريخ»، ليدلل على أن الرأسمالية انتصرت انتصارا ساحقا، وأن الإنسان وصل إلى قمة التقدم، وأنه لم يعد ثمة بدائل لهذا الإنسان إلا التسليم بالرأسمالية، كأفضل نمط حياة. مفارقة Fischer جاءت في مقالة له بعنوان: « الشرق الأوسط وعودة التاريخ[1] – 1/7/2014» وليس نهايته. فهو « يدور دورته الثانية الآن في منطقة الشرق الأوسط» .. فلنسمح لبعض النص، أن يفضفض عما في متنه، لنرى ما الذي جرى في ربع القرن الماضي. يقول Fischer:
« حين زعم فرانسيس فوكوياما، قبل أكثر من عقدين من الزمان، أن العالم بلغ نهاية التاريخ، أجبر التاريخ العالم على حبس أنفاسه. فكان صعود الصين، وحروب البلقان، والهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، والحروب في أفغانستان والعراق، والأزمة المالية العالمية في عام 2008، وثورات الربيع العربي، والحرب الأهلية في سوريا، كان كل ذلك مكذباً لرؤية فوكوياما التي صورت له الانتصار الحتمي للديمقراطية الليبرالية. بل وقد يكون بوسعنا أن نقول إن التاريخ أتم دورة كاملة في غضون ربع قرن من الزمان، منذ انهيار الشيوعية في أوروبا عام 1989 وإلى تجدد المواجهة بين روسيا والغرب. ولكن في الشرق الأوسط يعمل التاريخ على أساس يومي وبعواقب جسيمة. ومن الواضح أن الشرق الأوسط القديم، الذي تَشكَّل من بقايا الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، يتهاوى الآن … بل وربما يُعاد رسم حدود العديد من البلدان المجاورة بالقوة. ومن المؤكد أن الكارثة الإنسانية الهائلة بالفعل سوف تتفاقم».
على ضوء هذه الفقرة سنتوقف في هذا القسم عند أبرز القضايا التي تعصف بالنظام الدولي، معتمدين بالدرجة الأساس على المصادر الغربية، عبر العودة إلى أصول المعلومات والتحليلات والآراء التي قدمها كبار الكتاب من السياسيين والعسكريين والأمنيين والأكاديميين والمسؤولين الغربيين والمتخصصين، فضلا عن البيانات الاقتصادية من مصادرها الأصلية المتخصصة، أملا في تقديم أوضح صورة لحقيقة الأزمات التي تضرب النظام الدولي في الصميم. وسنتطرق على التوالي للمحاور التالية:
أولا: الثورات العربية ونقطة اللاعودة
ثانيا: أزمات الرأسمالية العالمية
ثالثا: تآكل النظام الدولي
رابعا: تآكل الدولة العربية
المبحث الأول
الثورات العربية ونقطة اللاعودة
سواء كانت على « الهامش»، كما هو حالها منذ المائة سنة الماضية، أو احتلت « المركز»، ستظل المنطقة العربية كما كانت منذ فجر التاريخ، فعلا أو ردا لفعل، مصدرا للانعطافات الكبرى في تاريخ البشرية برمتها. ولو تأملنا المدى الزمني بين نزول آدم عليه السلام إلى الأرض وبعثة محمد r لربما بلغ ملايين أو مليارات السنين!!!! وعلى امتدادها كان الرسل يبعثون برسالة واحدة هي « التوحيد». ومع كل رسول أو نبي كان هناك دعوة وتشريعات، لكن مع خاتم الأنبياء يكون الله عز وجل قد أكمل الدين دعوة وتشريعا. وهو ما يعني أن محمدا r هو الذي اؤتمن، من بين كل الأنبياء والرسل، على آخر كلام الله في الأرض. وهذا الحدث لا يضاهيه أي حدث في الكون، وتشريف للعرب لا يماثله أي تشريف[2]. هذه هي المنطقة العربية. فيها مركز الأرض ومركز الكون. فمنها خرج الأنبياء والرسل، ومنها انطلقت دعوة « التوحيد»، وفيها وقعت المعجزات والصراعات والسجالات والحروب بين دعوى الحق ودعوى الباطل، وفيها ستكون الفتن والملاحم الكبرى، وستكون أرض المحشر والمنشر. وفيها يقع ما لا يقع في أي منطقة أخرى، ويوجد فيها ما لا يوجد بغيرها ولن يوجد أبدا.
حقائق أزلية! لا تقوى أعتى القوى الكبرى على طمسها أو التلاعب بها أو تجاهلها أو التنكر لها، في أي مستوى كان، بقدر ما تعبر عنها اليوم بموجب مصطلحات سياسية من قبيل أن « الأزمات في المنطقة هي القاعدة وليس الاستثناء»، أو عبر دعوات، كالحفاظ على « الأمن والاستقرار»، لم تنقطع أو تفارق أبجديات النظام الدولي وسياساته واستراتيجياته وأمنياته منذ نشأته قبل مائة سنة. بل أن كل توصية أو دعوة تتضمن مفهومي « الأمن والاستقرار» إنما تعني أمن النظام الدولي واستقراره أو أمن النظم السياسية.
لذا فإن أي فعل بحجم الثورات العربية التي اندلعت وقائعها الأولى من تونس في 14/12/2010 ستكون له ارتداداته الطاحنة عاجلا أم آجلا، هنا في المنطقة وفي أي مكان آخر في العالم. بل سيكون من العبث النظر إليها بمعزل عما يجري في العالم سواء على مستوى الأزمات المالية الطاحنة التي تضرب المنظومة الرأسمالية المهيمنة، أو على مستوى نظم الاستبداد المستوطنة في العالم العربي منذ عشرات العقود. وسيكون من العبث أيضا النظر إلى الثورات المضادة التي تجتاح دول الثورات، على الأقل، كما لو أنها نهاية المطاف لما أسمي إعلاميا بـ « الربيع العربي»، بحيث يمكن القول أو الركون إلى القول بأن الثورات فشلت، أو الاعتقاد، عبثا وغطرسة، بأن نجاح الانقلاب في مصر شكل ضربة ساحقة لها.
قد يكون واردا الاعتقاد؛ بأن حزبا ما أو حركة أو جماعة فشلت وتلاشت لأسباب سياسية أو أيديولوجية أو مالية أو اجتماعية أو ثقافية … لكن الحديث عن فشل جموع بشرية تزامنت فعالياتها في أكثر من مكان، وتجاوزت في بنيتها وغاياتها ومضامينها، كل الأيديولوجيات أو الانتماءات السياسية أو الولاءات هو اعتقاد لا يمكن أن يصدر (عن) أو يجد له موضعا إلا أن يكون الاستبداد بعينه. ذلك أن الحراك الشعبي العفوي، يعني بالضرورة انتفاء كل أو أغلب أسباب الاحتواء، وفي المقابل لا بد أن يعني توفر كل أو أغلب أسباب الانتفاض المتراكمة في الذاكرة الشعبية، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة .. أسباب اجتهدت أدوات الاستبداد وآلياته في بعثرتها على مر السنين، إلى أن تَيسَّر لها الاجتماع، ولو في الحد الأدنى، وفي لحظة معينة من الزمن، لتنفجر في صيغة ما من الصيغ.
فإذا انتظمت الأحداث في الذاكرة الجماعية، بعد تشتيت طويل، سيكون من شبه المستحيل محوها أو السيطرة عليها، كونها تغدو جزء من الوعي المتراكم في الذاكرة، والخبرة التي تساهم في توجيه السلوك الجمعي حاضرا ومستقبلا. فالحقيقة التي لا يجب أن يماري بها أحد؛ أن الذاكرة الشعبية غدت عاجزة عن الاستمرار في دعاوى التبرير التي شرُعت عقودا للنظم السياسية، وتجاوزت عن المظالم لأسباب عديدة، وغضت الطرف إلى حد الاستغفال، لكنها فاضت بما اختزنت، ولم تعد تتسع لمزيد من الخداع والتضليل والمجاملات والمداهنات والنفاق والكذب والتزوير وألوان التحريف وصنوف القهر والفقر والعدوان والبغي والظلم والنهب وما إلى ذلك من فنون الاستبداد.
وفي السياق، لم يعد مهما القول بأن « الربيع» تحول إلى خريف أو شتاء أو جليد[3]، ولا يهم الزعم والمكابرة بأن هذه الدولة مرشحة للانفجار وتلك آمنة أو عصية، ولا يهم التواري خلف محاولات التضليل والخداع ببعض الإصلاحات هنا أو هناك، ولا يهم التحصن بالشرعيات التاريخية أو العقدية، ولا يهم التهديد والوعيد بمعادلة الأمن مقابل الاستبداد.
فالثابت أنه من المستحيل الاعتقاد بأن الاستبداد هو قدر الناس الذي لا فكاك منه. فلا العقائد، حيث قمة الوعي، تقول بهذا، ولا الفطرة الإنسانية، حيث قعر الجهل، تقبل به. وبالتالي فهو لا يمكن أن يكون إلا حالة استثنائية من المعيش، لا بد وأن تتعرض إلى مفاصلة حاسمة في يوم ما. وعليه فلا الانقلابات والقتل الوحشي واستحضار الفاشية بأبشع صورها ستنفع، ولا إشاعة الاستقطاب الاجتماعي، ولا محاولات الاحتواء المالي والسياسي، فضلا عن التدخلات الخارجية، قادرة على عرقلة الثورات عن الاستمرارية في الفعل الاحتجاجي. ولا ما يسمى بالحاجة إلى تعديل قواعد القانون الدولي ستصلح. فالمشكلة ليست مشكلة حزب أو جماعة أو نظام سياسي، بل في أميز ما قدمته الثورات العربية، ممثلا بذاك الفعل الجمعي الذي تمدد كالنار في الهشيم، مما يعني أن المشكلات في العالم العربي متماثلة، وواحدة لا تتجزأ. فكلها رفعت ذات الشعارات والمطالب، ونفذت نفس الفعل، وحققت نفس الهدف في مرحلتها الأولى ..
باختصار: فقد بدأ الحوار الشعبي مع النظم السياسية بلغة « إرحل»!!! وإلا!!! فلحظة الانفجار وقعت .. وحواجز الاستبداد تهشمت .. والنظم السياسية سرعان ما تبلورت في صيغة نظم بلطجة .. وحقيقة أجهزتها الأمنية القمعية انكشفت .. وانفضحت دموية جيوشها التي خلت من أية عقيدة قتالية، أو تحديد لهوية العدو، إلا من الناس الذين بدوا وكأنهم العدو الوحيد المؤهل لتلقي شتى صنوف التنكيل والموت، من الرصاصة إلى الأسلحة الإستراتيجية، وصولا إلى الموت غرقا، رُضَّعا وأطفالا وصغارا وكبارا. بل تبين للعامة من الناس أن نظم الاستبداد ومن ورائها نظم الهيمنة، على السواء، بدت أمام ناظريهم وفي قرارة أنفسهم، خالية تماما من أية مرجعية عقدية أو أخلاقية أو إنسانية أو فلسفية تبرر وجودها أو سلوكها الوحشي .. خالية من السياسة والاقتصاد والعلم والثقافة والقانون .. خالية من الأهداف والغايات .. خالية من أية قواعد توجه سلوكها السياسي أو العسكري أو الأمني.
هكذا؛ ما كان للثورة المضادة أن تفهم الحدث دون التأمل في مآلاته. وهكذا أدرك كل رموزها، أن الهدف التالي هو، لا محالة، إسقاط قواعد النظام. وأنها بالضرورة ستخوض معركة وجود مع الحشود البشرية، وإلا فقد تتعرض للسحق التام ولو بعد حين. وهكذا أيضا أدرك النظام الدولي أنه الهدف الأكبر الذي لا بد وأن يسقط، وتسقط معه قواعد الهيمنة بكل رموزها وأدواتها وقواعدها. فهو بعامته وخاصته، من الكتاب والمسؤولين، ممن هم في أعلى سلم المسؤولية، بل، وبدءً من الرئيس الأمريكي باراك أوباما فما دون، يتحدثون بصريح القول، ويُجمعون على أن النظم السياسية العربية كافة هي نظم استبداد بامتياز، ونظم طغاة، تابعة وخاضعة خضوعا تاما لهيمنة « المركز». ولا يراؤون بهذه الحقيقة التي تعج بها تقاريرهم ودراساتهم وصحفهم وتصريحاتهم وتوصيفاتهم بقليل أو كثير كما سنرى. بل أنهم ولحماية مصالحهم وما يصفونه بـ « الأمن» و « الاستقرار»، يصرحون رسميا بأن سياساتهم تميل إلى تفضيل النظم الديكتاتورية في الحكم على حقوق الناس المهدورة، وحياتهم المعرضة لشتى صنوف الخطر. وعليه فمن شبه المستحيل أن تستسلم النظم المحلية أو النظام الدولي لانهيارهما في أول مواجهة من نوعها منذ نحو مائة عام، حتى لو سلّم بعضهم بحقيقة « انهيار النظام الدولي»، ممن عقدوا لهذه الحقيقة أرفع المؤتمرات الأمنية لمناقشتها[4].
وعليه فقد كان من الطبيعي أن تتحرك الثورة المضادة محليا وإقليميا ودوليا، لرد عاصفة الثورات الشعبية، لكنه لم يكن طبيعيا أبدا أن تعتقد الثورة المضادة أو بعض الثوار أو عامة الناس أن الثورات الشعبية فشلت في تحقيق أهدافها، وباتت حدثا من الماضي يصعب استعادته أو تفعيله ثانية. فما يجري بالضبط هو سنة تدافع في الأرض، ليست الثورات الشعبية إلا شرارتها الأولى. ولو كانت الثورات انتهت فعلا، لما بقي ثمة صراع يذكر في أي من دولها، وعلى العكس تماما فإن ما نشهده واقعا هو إصرار الثورات على تصعيد فعالياتها، حتى لو اضطرت إلى الرد على الثورات المضادة بذات المنطق والأدوات. وهذا ما نتابع وقائعه في العراق وسوريا ولبنان واليمن ومصر وليبيا. ولا ريب أن في الثورة السورية بالذات يكمن ما لا يكمن في غيرها حتى هذه اللحظة.
فرادة الثورة السورية
فما من ثورة عربية أو حركة سياسية أو حزب أو جماعة إسلامية أو وطنية أو جهادية ولا حتى فكرة تحررية أو أخلاقية أو إنسانية مناهضة للاستبداد، إلا وكانت الثورة السورية لها بمثابة الرافعة والطاقة الدافعة والديمومة التي تجعلها قادرة على الاستمرار، خاصة بعد انطلاق الثورات المضادة. وما من أيديولوجيا وضعية، كالقومية واليسارية واللبرالية والعلمانية والعنصرية، فضلا عن الصفوية ومنتجاتها الهدامة، إلا وكانت لها الثورة السورية بالمرصاد، فضحاً وتعريةً .. وما من منظومة أخلاقية أو إنسانية أو مرجعية قانونية أو مؤسسية، لدولة أو نظام سياسي أو جماعة أو مؤسسة، إلا وجردتها الثورة السورية من كل شرعية .. أما النظام الدولي فقط تعرض، بفعل الثورة السورية، ولما يزل لأخطر مواجهة في تاريخه، تصل إلى حد التهديد بزواله، أو على الأقل السعي لإعادة بنائه.
ليست الثورة السورية؛ ولم تكن في يوم ما، ولا الشعب السوري، ولا سوريا، شأنا محليا أبدا أبدا، حتى لو انزلق بعض السوريين واعتقدوا بذلك، وعولوا طويلا على نصرة دولية لا يمكن أن تأتي. وإذا كانت مصر مركز « المربط الثقافي» فإن سوريا « النصيرية» هي مركز « المربط الأمني الدولي»، وفي انفجاره؛ انتشار عارم للفوضى في المنطقة والعالم. فما من بلد عربي سيغدو آمنا أو مستقرا، وما من قدرة لأية دولة على الصمود، وما من مربط آخر يمكنه الاستمرار على الإطلاق. فكيف تكون سوريا شأنا محليا؟ وكيف يكون التحصن بالوطنية رسائل تطمين للنظام الدولي بعدم الخروج؟
قد يكون مألوفا أن تشرع الثورات العربية بتدشين الشعار الأول لها « ارحل» ليعبر عن المرحلة الأولى، التي عليها أن تخوضها وتقطعها، قبل أن تصل إلى المرحلة الثانية، وهي « إسقاط قواعد النظام». وبقليل من التأمل سنلاحظ يقينا أن الثورة المصرية، بوصف مصر مربطا ثقافيا، بدأت من المرحلة الأولى، لكن في خضمها وقبل أن يرحل الرئيس المصري حسني مبارك، كانت أول ثورة ترفع شعار المرحلة الثانية « الشعب يريد إسقاط النظام»!! وهو الشعار الذي بدأت الثورات الأخرى، وحتى الاحتجاجات، برفعه. وهذا يعني أن الشعوب كانت تدرك حركتها، ومراحل عملها حتى لو كانت بلا قيادة. أما الثورة السورية، صاحبة « المربط الأمني النصيري» في الشام والموازي لـ « المربط اليهودي العسكري» في بيت المقدس، فلم يكن أمامها من سبيل إلا الانطلاق من المرحلة الثالثة والأخيرة، « إسقاط قواعد الهيمنة»، سواء علم قادتها بذلك أو لم يعلموا، وسواء رغبوا أو لم يرغبوا. لأن إسقاط حكم الأسد، هو في المبدأ والمنتهى إسقاطا لـ « المربط الأمني » الطائفي، وإسقاطا للطائفة ذاتها، وبالتالي إسقاطا لعمود مركزي من أعمدة النظام الدولي، أو خلع وتدا من أوتاده. ودون ذلك فالحديث سيغدو مضيعة للوقت والجهد، أشبه ما يكون بانتفاضة فلسطينية تطالب برحيل رئيس حكومة « إسرائيلية»، أو اليهود من فلسطين!!!! فكيف ستكون المواجهة سلمية من الأساس!!؟ وعليه فإذا كان من المستحيل أن يقول الفلسطينيون بذلك، فمن المستحيل أن يكون ذلك ممكنا مع الأسد أو النصيرية في الشام. وتبعا لذلك لا بد من الإقرار بأن الثورات في « دول المرابط» لا يمكن أن تنطلق سلمية وتستمر، حتى لو بدأت كذلك.
كل التصريحات الغربية، لاسيما الروسية منها، وحتى السورية الرسمية، قطعت الشك باليقين، وفي أوضح الكلمات والعبارات، ومنذ اللحظات الأولى، أن الثورة السورية ليست شأنا محليا، ولا يمكن أن تكون كذلك. ومع توفر العشرات منها موثقا في سلسلة « الثورة السورية ومسارات التدويل»، إلا أنه لا ضرر من التذكير بنماذج منها. ففي مقابلة واسعة مع صحيفة « وول ستريت جورنال – 1/2/2011» الأميركية تلقى الرئيس السوري بشار الأسد السؤال التالي:
كرئيس لسورية، كيف ترى ما يحدث في تونس ومصر والجزائر والأردن؟ كيف ترى المنطقة تتغير؟ وأخيراً، ماذا يعني ذلك لسورية بالذات؟ فكان الجواب:
« إذا أردت أن تتحدث عن تونس ومصر، فنحن خارج هذا الأمر. وفي النهاية، نحن لسنا تونسيين ولسنا مصريين. لا نستطيع أن نكون موضوعيين، ولاسيما أن الوضع ما زال ضبابياً وليس واضحاً. إن الأمور لم تستقر بعد، ولذلك فإن أياً كان ما تسمعه أو تقرأه في هذه المرحلة، لا يمكن أن يكون واقعياً أو محدداً أو موضوعياً».
لكنه في مقابلته مع صحيفة « الصندي التلغراف – 30/10/2011 » البريطانية، كان « موضوعيا» وبلا « ضبابية»، حين قال:
« إن سوريا اليوم هي مركز المنطقة .. سوريا مختلفة كل الاختلاف عن مصر وتونس واليمن. التاريخ مختلف، والواقع السياسي مختلف .. إنها الفالق الذي إذا لعبتم به تتسببون بزلزال، .. هل تريدون رؤية أفغانستان أخرى أو العشرات من أفغانستان؟ .. أي مشكلة في سوريا ستحرق المنطقة بأسرها .. إذا كان المشروع هو تقسيم سوريا، فهذا يعني تقسيم المنطقة برمتها … ».
أما الروس، وفي إطار صراعهم مع الغرب على قيادة النظام الدولي، وسعيهم لإعادة بنائه، بما يمكنهم من استعادة مناطق نفوذهم التي فقدوها بعد تفكك الاتحاد السوفياتي سنة 1992 وخسارتهم للكثير منها، فقالوا ما لم يقله أحد قبلهم ولا بعدهم. ولأول مرة منذ توضيعه في عشرينات القرن الماضي، أقر وزير الخارجية، سيرغي لافروف، بـ (1) حجم الخطر الذي تمثله الثورة السورية على النظام الدولي، و (2) محصلة أهدافها، و (3) محذرا من الخطر الذي يتهدد « المربط النصيري». ففي مقابلة له عبر إذاعة « كومرسانت إف إم – 21/3/2012» رد بغضب عارم على محاولات ابتزاز الغرب للروس في المسألة السورية: « إنّ الصراع يدور في المنطقة كلها، وإذا سقط النظام الحالي في سوريا، فستنبثق رغبة قوية وتُمارس ضغوط هائلة من جانب بعض بلدان المنطقة من أجل إقامة نظام سنِّي في سوريا، ولا تراودني أي شكوك بهذا الصدد».
بعد تصريح لافروف أوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية، الكسندر لوكاشيفيتش، في مؤتمر صحفي عقده بموسكو في 21/6/2012 ما قاله لافروف أعلاه: « من الواضح تماما أن الوضع السوري مرتبط بأسس النظام العالمي المستقبلي، وكيفية تسوية الوضع ستحدد إلى حد كبير كيف سيكون هيكل نظام الأمن الدولي الجديد والوضع في العالم عموما». وردا على التصريحات الغربية التي أعقبت بيان « مؤتمر جنيف1» بشأن سوريا في 30/6/2012، واتهام روسيا بالتمسك بالأسد كرر السفير الروسي، ألكسندر أورلوف، في باريس (20/7/2012)، ما أعلنه لوكاشيفيتش: } إن ما تدافع عنه روسيا ليس نظام بشار الأسد، « لكنه النظام الدولي»{.
تصريحات الروس هذه جرى ترجمتها عسكريا، حتى قبل المسألة الأوكرانية، ففي شهر يونيو/ حزيران 2012 اعترض البريطانيون سفينة الشحن الروسية « ألايد»، التي كانت متوجهة إلى سوريا، وتحمل على متنها طائرات مروحية هجومية، ورفعوا عنها غطاء التأمين الدولي، مما اضطرها للعودة. لكنها عادت للإبحار مجددا تحت العلم الروسي بدلاً من علم جزيرة كوركاو في البحر الكاريبي. وتفاعلت المسألة، إلى أن نقلت صحيفة « ميل أون صندي – 15/7/2012» عن مصدر بارز في البحرية الروسية قوله: « نأمل ألا يُطلق أحد شرارة الحرب العالمية الثالثة بسبب ذلك، فنحن لم نتلق أوامر حتى الآن لمرافقة السفينة ألايد، لكننا نتوقع صدورها في أي وقت، بعد أن تم التخطيط للعملية»!!!
وخلال وجودها في نيويورك، في ضيافة مجلس العلاقات الخارجية، قالت وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون: « لم تعد المشكلة خاصة بسوريا فقط الآن. لم أعتقد مطلقا أنها مشكلة سوريا. كنت أرى أنها مشكلة إقليمية». هذه الشهادة وردت في مقالة مشتركة صدرت في صحيفة « نيويورك تايمز» الأمريكية، لكل من: تيم أرانغو وكريم فهيم وبين هوبارد، ونقلتها صحيفة « الشرق الأوسط – 17/6/2014» السعودية[5].
قبل انطلاقة الثورة السورية في 18/3/2011، كان الحديث يقع في مستوى ضحايا القتل فقط، دون الاعتقال والاختطاف والتشريد والتنكيل، يجري عن عشرات الآلاف في حماة وحلب وجسر الشغور والجزيرة. أما بعد الانطلاقة، ودخولها عامها الخامس، فقد صار الحديث الموثق فقط يتعلق بمئات الآلاف من القتلى[6] ومثلهم من المفقودين وأكثر من 1.5 مليون جريح، أغلبهم معاقين، وآلاف المغتصبين والمغتصبات، وملايين اللاجئين، وبنى تحتية مدمرة، وعقيدة منتهكة، وكرامات مطحونة. وسيغدو الحديث عن مثل هذه الانتهاكات جنونيا، ما أن تضع الحرب أوزارها، وتبدأ الحقائق بالانكشاف على مصاريعها الدموية والوحشية. فالعدو هنا داخلي وليس خارجي!!!
الشائع والمألوف لدى نظم الاستبداد، كما تصفها كتابات الغربيين والشرقيين، هو استعدادها لانتهاك كافة الحقوق الفردية والجماعية، من قتل واعتقال واختطاف ونفي وتشريد وإقصاء وتهميش ومضايقات وتمييز وانتهاك للأعراض وحتى الاغتصاب دون الالتفات لأية عواقب. وإنْ كان ثمة بعض القيود والمخاوف من ردود الفعل، أو توقع بعض الاحتجاجات الشعبية أو الانفجارات، أو الحرج الدولي أو تضرر الشرعية، إلا أنه في النظام السوري وأمثاله، قبل الثورة وبعدها، لا يمكن الحديث عن أية فضائل أو قيم أخلاقية أو إنسانية أو روادع أو ضوابط أو محرمات من أي نوع، وعلى أي مستوى، لا في النفس البشرية ولا في النوع ولا في العمر ولا في التاريخ ولا في الدين ولا في الحضارة ولا في الحاضر ولا في المستقبل، ولا عن أية محاذير في استخدام القوة، لا في أدواتها ولا في وسائلها. والحقيقة أن المشكلة ليست في كون « النصيرية» مربطا يحظى بحماية دولية تؤمن لدمويته ووحشيته وإرهابه اللامحدود، ما يحتاج من الأغطية السياسية والأمنية والعسكرية، بل أيضا؛ في عقائد طائفة منبوذة اجتماعيا وأخلاقيا لا تحتمل بشرا ولا يحتملها أحد، حتى الطوائف والأقليات المتحالفة معها. فهي طائفة لا تجيد أي نوع من الجوار الإنساني أو الحضاري أو الأخلاقي. وبالتالي فإن مجرد التفكير بإحراج نظام يتمتع بامتياز دولي هو ضرب من العبث.
لا يمكن لكل الكوارث والفواجع والأحقاد والضغائن والمآسي والدمار التي ارتكبها النظام أو خلفها، بما يعز عن الوصف ويتعاظم؛ أن تكون مجرد ثمن لمصالحات سياسية معه أو مع الطائفة. لذا لم يكن ثمة خيار أمام السوريين إلا أن يصبوا جام غضبهم على النظام، ويمضوا بعناد لا مثيل له في ضربه حيثما كان، غير آبهين بأفدح الخسائر، ولا بأعلى درجات القهر، ولا بأقصى مستويات الخذلان، ولا حتى بالفتن التي تعصف بالثورة السورية، أو المؤامرات المحلية والإقليمية والدولية التي تحاك ضدهم.
ولعل الحقيقة الأولى التي لا يمكن أن يماري فيها أحد، أياً كان محتوى التحركات السياسية ماضيا وحاضرا، هي التي تؤكد قطعا بأن الأسد لا يمكن أن يستمر سياسيا، وأن بقاءه في السلطة اليوم أو غدا بات أشبه بالعدم. وبنفس المقدار؛ فإن هيمنة الطائفة « النصيرية» سياسيا تحطمت بالكامل، أما استمرارها فسيغدو حلما سياسيا، ناهيك أن يرقى إلى مستوى ذلك اجتماعيا، ولو في مستوى ما يسمى بالتعايش الاجتماعي.
والحقيقة الثانية فهي التي تقول بأن الثورة السورية التي أريد بها كسر إرادة الشعوب، ورغم تكلفتها المدمرة، انتشلت في المحصلة عموم الثورات العربية، وقدمت نموذجا حقيقيا لما تتطلبه الحرية من أثمان حقيقية لانتزاعها.
أما الحقيقة الثالثة التي بات الجميع يتحدث عنها اليوم بلا استثناء، وسنأتي على تفاصيلها تاليا، فهي التي أنجز فيها السوريون، واقعا، ما لم تنجزه الأمة في مائة عام، فالثورة هدمت النظام الدولي، أو تكاد. فهذا النظام الذي نعرفه منذ مائة عام، لم يعد فعليا قائما، وغدا بحاجة إلى بناء جديد أكثر منه ترميما. وهذا يعني أن المشاكل الدولية على وشك أن تبدأ، ربما بصيغة أكثر عدوانية ودموية مما وقع حتى الآن. وهو ما سنراه في محور « تآكل النظام الدولي».
والحقيقة الرابعة أن بقاء « الدولة العربية» صار موضع نقاش في الغرب قبل الشرق، بعد أن تآكلت مشروعيتها، إلى الحد الذي لم يعد النظام السياسي يعنيه لا خدمات ولا حقوق ولا أمن اجتماعي ولا حاضر ولا مستقبل، بقدر ما تعنيه اللحظة الراهنة التي يعيشها. بل أن التغيير الديمغرافي والجغرافي صار واردا على كل لسان إلى الحد الذي يتحدث فيه البعض عن اختفاء دول مثل العراق وسوريا[7]، وهو ما يتجاوز الحديث عن انهيار الشرعيات التي أوجدت الدولة نفسها.
http://almoraqeb.org/2016/06/16/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84/
 Hitskin.com
Hitskin.com