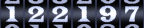إذًا، يرتبط فائضُ القيمة التاريخيّ بتراكم السِّلع، ولكنّه يرتبط أيضًا بتراكم المخزون الفكريّ المؤاتي لرأس المال. إنّ معدّلَ فائض القيمة هو معدّل الاستغلال، بما في ذلك سلبُ الوعي الثوريّ أو روحِ المقاومة. وهنا الصعوبة في تكميم علاقة القيمة؛ أي إنّها مبنيّة على إلغاء الذاتيّة. والماركسيّ لا يَفهم "المَصْنعَ" الذي ذُكر في كتاب رأس المال (الجزء الأول) على أنّه بناءٌ ذو حيّزٍ فيزيائيّ وأسسٍ اقتصاديّةٍ عينيّةٍ فحسب؛ هذه أقربُ إلى الفلسفة التجريبيّة، التي تمثِّل قمّةَ الإيديولوجيا الغربيّة، أيْ سلاحَها الطبقيّ. في ظل علاقات رأس المال، فإنّ إعطاءَ الفكرة الرسميّة (formal idea) شكلًا مادّيًّا (أو ما نسمّيه "التمدية" reification ) ممارسةٌ للفساد الفكريّ؛ فهذا الإسقاط يرى الجوهرَ المادّيّ (substance) ولا يرى الذاتَ (subject): أي يرى الشيءَ من دون العلاقة الاجتماعيّة/التاريخيّة التي صنعتْه. وفي هذا تجريدٌ منحازٌ، كفعلِ مَن يرى المستوطناتِ ولا يرى الشعبَ المهجَّرَ التي كان تهجيرُه مستنِدًا إلى بنائها، ومن ثمّ "يفاوض" ببراغماتيّة كأنّ حقَّ المهجَّر أُسقط!
الفلسفة الوضعيّة-التجريبيّة تلغي التاريخَ، أيْ تلغي الواقعَ بصيرورته. فلولا تدميرُ مقدِّرات الشعوب وسلبُ إرادتِها وإلغاءُ تنميتِها بالإمبرياليّة، في منظومةٍ مأزومةٍ بفائض الإنتاج، لَما كان هناك عمرانٌ ولا صناعةٌ في المركز. لذا، فإنّ التجريدَ الوضعيّ يجرِّد الواقعَ من القوى الفاعلة ومن تاريخه، ويلغي حقوقَ الشعوب، كلِّ الشعوب، لا الشعبِ الفلسطينيِّ وحده، وبالذات تلك الشعوبِ التي أبيدتْ لبناء ثراء الاستعمار. المصْنع الحقيقيّ هو كلُّ المجتمع الكونيّ ذي الإنتاج الاجتماعيّ والمنظَّم بصراعه الطبقيّ.
يقول كارل ماركس في الجزء الثالث من رأس المال إنّ المجتمع، ككلّ، هو مادّةٌ للصناعة. إنّ التركيز على المَصْنع الأوروبيّ بحدوده المذكورة أعلاه (الحيّز الفيزيائيّ والأسس الاقتصاديّة... إلخ) يقزِّم الاستغلالَ ويجرِّدُه من معناه. الماركسيّة الغربيّة تشدِّد على التفوّق الإنتاجيّ الغربيّ، بمعامله العالية التقنيّة وبعمّالها المنتِجين، لكنّ المنتوجَ الأهمَّ في الحقيقة هو حلقاتُ الإنتاج الدوليّة التي تتّصف بالهدر على مدى الدورة الحياتيّة، بما في ذلك هدرُ الإنسان في الحروب. الاقتصاد السياسيّ يُعنى بدور السلعة في إعادة إنتاج المجتمع، لا بتسوية معدَّل الأرباح، إلّا بما للأخير من تأثيرٍ في الأوّل. وهذه الرؤى [الماركسيّةُ الغربيّة] رؤًى أورو-مركزيّة اقتصادويّة تحذف الواقعَ وتنتقي ما يَخدم مصالحَ الإمبرياليّة.
لطالما كانت الماركسيّةُ الغربيّةُ العصا الغليظةَ للإمبرياليّة لأنّها تشوِّه الوعيَ الثوريّ. عمليّة الإنتاج هي الدورة الحياتيّة، بترابطها الكونيّ، في زمنٍ اجتماعيٍّ "ما فوق محدَّد" (overdetermined). وهذا يعني أنّ السببيّة لا ترتبط بتسلسلٍ كرونولوجيّ، وأنّ علاقةَ المتغيِّرات بعضها ببعض كيفيّةٌ ديناميكيّة، وأنّ القيمة - كشيء - تَفترض مسبّقًا علاقةَ القيمة. لذا قال ماركس، في رسالته إلى كوغلمان، إنّه لم يكن في حاجةٍ إلى أن يفنّدَ القيمةَ في فصلٍ ما؛ "فكُلّ طفلٍ يعرف ما هي القيمة."[3]
العلم معنيٌّ بدراسة العلاقة التي تتجلّى من خلالها القيمةُ/الشيء. وهذه العلاقة ما هي إلّا الصراعُ الطبقيّ في مجتمعٍ كونيّ - - ذلك المصنعِ الاجتماعيّ الذي تبقى أُولى حساباته حساباتِ توظيف العمل بإملاءات قانون القيمة. وهذا يعني إعادةَ إنتاج اليد العاملة أو طاقةِ العمل؛ وهذه هي السلعةُ الأولى والأخيرة في عمليّة الإنتاج لأنّ العاملَ هو المنتِجُ والمنتَج، المستهلِكُ والمستهلَك، في آن. فكيف لهذا المَصْنع الكونيّ أن يعيد إنتاجَ نفسه بغير العنف، في كنف ربحيّةٍ تَهْدر (أو تسيِّل) العامَّ لاقتناصه بالخاصّ؟
ما نراه في فلسطين هو نتاجٌ للخلل في الصراع الطبقيّ وفي الوعي الطبقيّ. إنه من إنجازات رأس المال. وإلّا فكيف نفسِّر صعودَ رأس المال هذا على حساب العمل - - وهو صعودٌ انتهى بالعالم إلى زمن النيوليبراليّة وإلى أوسلو؟
وأوسلو لا يخصّ الفلسطينيين فقط؛ ذلك لأنّ ما يحصل في فلسطين يؤثّر في حركة العمّال الكونيّة، ويؤثّر في الجوار بسبب كونيّة الإمبرياليّة، التي تحبك من نسيجٍ واحدٍ، وتمثّل الصهيونيّةُ رأسَ حربتها. كيف لنا أن ننهزمَ أمام علاقة اجتماعيّة – طبقة – حالة إيديولوجيّة متراكمة تتحكّم فيها سلعةٌ مُصنَّمة؟ كيف لنا أن نفاوضَ مع عقلٍ مسلّع، مع سلعةٍ تتوسّع تلقائيًّا بالعنف؟
يعود هذا إلى التنظير الخاطئ أو المماهاة بين النظريّة والإيديولوجيا. نظريًّا، لا يمكن التفاوضُ مع الكيان الصهيونيّ لأنّه يجسِّد عقلَ السلعة/الشيءِ بأقصى درجاتها. فالصهيونيّة تتعلّق بالأرض لا لدينٍ أو مبدأٍ ما، وإنّما لأنّ توسُّعَها بالحرب يوسِّع أهمَّ السلع: الحربَ والأمنَ الإمبرياليّ. ما حصل هو تنازلٌ نظريٌّ غذّى الإيديولوجيا على حساب النظريّة. لقد شُيِّئ الفكرُ حين اتُّبِع المنهجُ الإمبيريقيّ (التجريبيّ) السابقُ الذكر، والبعيدُ كلَّ البعد عن الصحّة. والتشييء (أو التمْدِية) يَخْلع التكوّنَ التاريخيَّ عن التطوّر، فتصبح المستوطَنةُ أمرًا واقعًا، نتاجَ القوّة، أيْ نتاجَ الانزلاق الإيديولوجيّ كذلك. فالإيديولوجيا لبُّ القوّة، وهذا بدوره نتاجٌ للتضحية بالتاريخ أو بالنظريّة.
ماذا عن قوّة الإيديولوجيا؟ تصوّروا أنّ الرأسماليّة، بفكرها "التنويريّ" وإيديولوجيّاتها، قتلتْ منذ 500 سنة حوالى مليار نسمة في حروبها الكولونياليّة. وهي تكاد تقضي، لا بل قضت فعليًّا، على أسس وجود الكون البيئيّة اليوم. ما حصل من دمار، وآخرُ الدراسات تحدّثتْ عن انهيار في النظام البيئيّ،[4]هو مِن فِعل الفكرةِ أو الطبقة السائدة؛ ما يثبت أنّ الناس تعيش خيالًا، وأنّ مجمل الإيديولوجيا المهيمنة ليس إلّا مؤامرةً على الشعوب. ومع ذلك، فما زال هناك مَن يتبجّح بـ"تفوّق" الغرب الثقافيّ! إذا كانت تلك هي محصّلةَ ثقافة الرأسماليّة، ناهيكم بإنتاجها المسموم، فهل ثمّة أيُّ شيءٍ "تقدّميٍّ" جاء من الرأسماليّة كحقبة تاريخيّة؟ كلّا!
لقد كانت الماركسيّةُ الغربيّة تتغنّى بـ "تقدّميّة الرأسماليّة" كي تُماثلَ تاريخَ العالم الثالث بتاريخ الغرب الدمويّ، بذريعةِ أنْ لا تقدُّمَ من دون إراقة دماء. كان هذا تبريرًا رأسماليًّا لهدرنا بعمليّة إنتاجٍ هدريّة. أصبح الهدرُ تاريخَنا، وبُرِّرَ القتلُ بـ"التقدّم التقنيّ،" الذي استُلِب منا أصلًا، وهو يُستعمل سلاحًا ضدّنا. متوسِّطُ أعمارنا أعلى بقليل من نصف أعمار الغربيين، على الرغم من توافر ذلك التقدّم التقنيّ!
* من اللافت أنّ صفقة القرن أعادت موضعةَ العلاقة بين المركز والأطراف على مستوى منطقتنا، فبدا وكأنّ هذه العلاقة باتت تمرُّ من خلال تل أبيب. صار ثمّة موقعٌ جديدٌ لـ "إسرائيل" يتجاوز فلسطينَ الجغرافيّة. هل توافقنا الرأي؟
- ثمّة ورقةٌ لفاندر هوفن ليون هارد (1960)، عنوانُها "الحقيقة عن فلسطين."[5] الورقة تتحدّث عن الحقائق التي يبنيها المستوطنون على الأرض؛ فهم يَخْلقون واقعًا على الأرض، اسمُه واقعُ القوّة. تقول ليون هارد إنّ ذلك لا يعني شيئًا ما لم يقبلْه الشعبُ الفلسطينيُّ أو العربيّ؛ وبذا لا يصبح - أبدًا - واقعًا مكتملًا أو حقًّا.
منذ العام 1960، تمدَّدتْ "إسرائيل." وهي اليوم أكثرُ ارتباطًا بالرجعيّة العربيّة، التي هي أصلًا امتدادٌ للصهيونيّة؛ ذلك لأنّ دورة هذه الرجعيّة غيرُ إنتاجيّة، والخليج أساسًا مستتبَعٌ بالكيان. الموألة تُدوْلِرُ أسسَ الطبقات وتجانسها. وعليه، فقد جاءت "الصفقة" لاستغلال نضوج الظرف الطبقيّ، ولخلق اصطفافِ قوّةٍ جديدٍ يناهض الصينَ.
صفقة القرن انعكاسٌ هزليٌّ لأمبراطوريّةٍ في طورالأفول. التوسّع على الأرض يجب أن يواكبَه أو يسبقَه توسّعٌ فكريٌّ إيديولوجيٌّ معلِّلٌ له - وما هذا بحاصلٍ على الرغم من تواطؤ السلطة الفلسطينيّة. اليوم، الموازين الدوليّة تغيّرتْ مع نهوض الصين، التي برهنتْ من خلال تعاملها مع الكورونا مؤخّرًا قدراتٍ اجتماعيّةً عالية. والمستعمِر الغربيّ، الذي أمدّ الكيانَ الاستيطانيَّ بالتبرير الخرافيّ للتطهير العرقيّ، ولّى.
يستحيل إنهاءُ الصراع في فلسطين من دون هزيمة الإمبرياليّة، ومن دون تكاتُف القوى العاملة ضدّها. إنّ فلسطين هي نقطةُ ارتكازٍ في عمليّة التراكم الدوليّ، وهي المرسى في إعادة إنتاج الطبقة العاملة الدوليّة، لِما تبثّه الصهيونيّةُ من قوّةٍ للإمبرياليّة. هذا التركيز الإمبرياليّ على فلسطين ليس بعقدة ذنْب الرجل الأبيض؛ فـ"الشيء" لا يَعْرف الذَّنْبَ. وإنّما التركيزُ هو مصلحةٌ كلّيّةٌ هدفُها استهلاكُ الإنسان والبيئة في عمليّةٍ إنتاجيّةٍ هدريّةٍ كونيّةٍ لا يستمرّ فيها الإنسانُ ما لم يناضلْ من أجل البقاء - - وهنا أعني "البقاء" حرْفيًّا؛ فالكوكبُ تآكل!
لكنّ القوى الرجعيّة العربيّة تحتاج إلى اعتراف الشعب العربيّ بـ "إسرائيل." وهذا مستحيلٌ لأسبابٍ وجوديّة، ناهيكم بسبب حبّ الشعب للوطن. هذه حربٌ طبقيّة، والحربُ الطبقيّة عمليّةُ تراكُم. فإذا خسرت الطبقةُ العاملةُ في فلسطين، خسرتْ معظمُ الطبقات العاملة أسسَ وجودها وإعادةِ إنتاج ذاتها، أي خسرتْ خبزَها. سيَكْبر التراكمُ بالهدر، وسيموت فعليًّا عددٌ أكبرُ من الناس في صناعات الحروب، أو في متوسّط عمرٍ أقلّ مرتبطٍ بالتقشّف الناتج من انتصار الإمبرياليّة.
إنّ الدورة الاقتصاديّة هي، فعليًّا، دورةُ الصراع الطبقيّ عالميًّا. وبهذا أعني أنّ الطبقة العاملة ليست الطبقةَ الفلسطينيّةَ وحدها، بل الدوليّةَ أيضًا. زدْ على ذلك أهمّيّةَ القضيّة الفلسطينيّة في ميزان القوى الدوليّ. كما أعني بـ "الدورة الاقتصاديّة" دورةَ القيمة المتعلّقة بالوعي الطبقيّ؛ فعلاقةُ القيمة علاقةُ ذاتٍ بذات، وعلاقةُ الذات بالغرض؛ إنّها الذاتيّة المتكوِّنة في رحم الوعي الطبقيّ. والربحيّة تَنْتج من تكثيف ساعات العمل الضروريّة، لكنها أوّلًا تَنتج من تدمير الذات وتشويهِ الوعي؛ من سلب الإنسان إرادتَه، ومن استعبادِه. العبد لا يفاوِضُ أجرَه. العبد هو الإنسان/الشيء المتكامل الذي أصبح ماكينةً. لكنْ، بحكم التغاير الجدليّ، لا تفرز الماكينةُ فائضَ قيمة؛ فهي عملٌ ميت.
لذا، فإنّ الدورة الاقتصاديّة والربحيّة منوطةٌ بقدرة رأس المال على خلق إيديولوجيا عمّاليّة بديلة لا تنافي المنظومةَ الرأسماليّة، بل تكون هذه الأخيرةُ قادرةً على سحقها. من هنا تَنبع الماركسيّةُ الغربيّة، والليبراليّةُ، والأنجزةُ (من NGOs= منظّمات مجتمع مدنيّ) كي تساهم جميعُها في دورة تكرار السحق وإلغاء الوجود المتكرّر للعمل. ولذلك، فإنّ قضيّة فلسطين أولويّةٌ نظريّة.
أعود وأذكّر بأنّ الرجعيّة العربيّة والصهيونيّة والإمبرياليّة طبقةٌ أو علاقةٌ مبنيّة على أرضيّةٍ مادّيّةٍ واحدة. لكنْ أضيفُ الآن أنّ الرجعيّة العربيّة هي في أسفل التراتب الطبقيّ. لذا، لا إشكالَ عند الصهيونيّة-الإمبرياليّة في التخلّي عن هذه الرجعيّة، كما فعلتْ حين تخلّت عن مبارك أو زين العابدين بن علي أو شاه إيران. التراكم بالهدر يَستهلك، كمدخل، الدولَ بمن فيها.
ثمّ إنّ الإمبرياليّة، في سيطرتها على منطقتنا، تزيد هيمنتَها على الكون. وبسبب أهمّيّة منطقتنا في عمليّة الارتكاز التراكميّ لرأس المال، فإنّ هذه الطبقة (أي التحالف الإمبرياليّ الصهيونيّ الرجعيّ) كلّما تحكّمتْ بقدرات الشعب الفلسطينيّ، قويتْ على غيرها من الشعوب أيضًا. لذا من الممكن أن تتنازل الإمبرياليّةُ والصهيونيّةُ للشرائح الحاكمة في فلسطين، بشراء ذممٍ هنا وهناك، ببطاقات VIP، لكنْ على حساب الملايين التي استُشهدتْ في الجوار. وللتذكير، فإنّ أصحاب الـVIP مشاركون في الحروب على سورية والعراق.
منظومة العلاقات الطبقيّة تخلق عدوَّها التي تستريح إليه بشكلٍ دائم، ولا يمكن أن تستكين. وعندما يقول جورج حبش إنّ جوهرَ الكيان الصهيونيّ هو جوهرٌ توسّعيٌّ وعدائيّ، فهو يقول إنّ هذا الكيان لن يَقبل معنا بأيّ اتفاقٍ حتّى إنْ قبلناه نحن. فالتدمير هو منظومةُ عمل "إسرائيل" لأنّه رأسُ الحربة في عمليّة الإنتاج الهدريّ نفسِها.
التوسّع الصهيونيّ عمليّةُ إنتاجٍ من ضمن عمليّة التراكم بالتدمير والهيمنة. إنّ قاعدة إنتاج الصراع العربيّ -الصهيونيّ ليست مبنيّةً فقط على "حبّ الوطن" الذي ذكرناه أعلاه، على الرغم من وجود هذا الحبّ. ذلك أنّ حبَّ الوطن جزءٌ فحسب من الذاكرة الجماعيّة التي تتجدّد مع ظروف إعادة إنتاج الذات الاجتماعيّة. حبُّ الوطن (وحبُّ العودة إليه) لا يموت مع اضمحلال الذاكرة لأنّ العدوان الصهيو-إمبرياليّ يجدِّد إحياءَ هذه الذاكرة ما دام يقضي على أسس وجودنا. العلاقة الإمبرياليّة هي تحديدًا حربُ وجود، ليس لشعوبنا فحسب، بل لكلّ شعوب الأرض أيضًا، وللأرض ككيانٍ بيئيٍّ كذلك. وعمليّةُ استهلاك الأرض والإنسان، بإلغاءِ وجودهما، هي المدخلات الإنتاجيّة في عمليّة التراكم الهدريّ الذي يشكّل الشطرَ المقرِّرَ في علاقة رأس المال.
وعليه، فحين يقال "إنّ حربَنا مع الكيان الصهيونيّ حربُ وجود،" فهذه ليست عبارةً مجازيّةً، وإنّما واقعًا حقيقيًّا يُعاش منذ نشأة هذا الكيان. فلننظرْ إلى هذا الدمار الشامل الذي حلّ بنا، لا في فلسطين وحدها وإنّما في المنطقة كلّها: ملايين هُجّرتْ، وقُتلتْ، والحبلُ على الجرّار. أوَليست هذه حربَ إلغاء؟!
هناك نوعٌ من الترابط والتقاطع بين التقاء السياسات الاستسلاميّة لبرجوازيّة أوسلو، ومعدَّلاتِ التدمير في الجوار العربيّ والإسلاميّ. هذه الشريحة تُشارك الإمبرياليّةَ - النسيجَ الواحدَ - في إعادة صياغة مدخلات إنتاجها بالإفراغ السكّانيّ، المركّبِ على سيرورة العمل، كي تنتج القيمةَ بإعادة هيكلة موازين القوى لصالح الإمبرياليّة.
* هل تعبِّر "صفقةُ القرن" عن أزمةٍ إيديولوجيّة كونيّة؛ عن أزمة السياسة في زمنِ "ما بعد النهايات" الذي طالعَنا بها عددٌ من المثقّفين الغربيين إبّان سقوط الاتحاد السوفياتيّ؟
- نعيش اليوم أزمةً إيديولوجيّةً عميقة. الخطورة في الموضوع أنّه عندما تكون أزمةٌ كهذه، ناتجةً من فقدان الفاعليّة التاريخيّة للعمل، تنفرد السلعةُ بالسلطة، وتشيِّئ الرأسماليَّ معها - - فنصبح أمام سلطةِ السلعة/الشيءِ الذي يرتكز على الموألة والتي باختزالها المكان بالزمن من أجل تسريع التبادل تُنتج فائضَ القيمة بالطرق الهدريّة أكثر فاكثر. أي إنّها تنتقص من حياة البشر بتسييل رزقها، كالخصخصة مثلًا.
هنا يَحْضرني غسّان كنفاني، عندما سأله مراسلٌ أستراليٌّ: "لماذا لا تنخرط منظّمتُكم [المقصود: الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين] في مباحثات سلام؟" فأجابه: "هذا نوعٌ من الحوار بين السيف والرقبة!"[6]هذه نقطةٌ مهمّة، لأنّ كنفاني يشير إلى طبيعة موازين القوى المختلّة التي تُضْمرُها هذه "المباحثات." لكنْ يمكننا، انطلاقًا من هذا القول، الذهابُ أبعدَ من ذلك. نحن اليوم لا نفاوض السيّافَ الذي يمتلك هذا السيفَ. نحن اليوم، مع ترامب، وفي ظلّ العقليّة التشييئيّة التي تحكم عالمَ اليوم، نفاوض السيفَ، الأداةَ، الشيءَ؛ لا هو قادرٌ على فهمنا، ولا نحن قادرون على الحديث معه.
السيف/الشيء هنا علاقةٌ اجتماعيّةٌ محكومةٌ بموازين السوق. السلعة/السيف محكومةٌ بعلاقاتها التوسّعيّة، لأنّها تطمح إلى زيادة إنتاج ذاتها من خلال خفض تكاليف هذا الإنتاج نفسه. وخفضُ التكاليف يعني تخفيضَ ما هو متوفّر للإنسان الاجتماعيّ - - بما في ذلك تقصيرُ عمره.
هذا التصوّرُ لعالمٍ محكومٍ بروحِ سلعةٍ تستبطن القيمةَ، وتتوسّع من ذاتها ضروريًّا (لكنْ ليس استثنائيًّا) بالعنف، ليس صورةً نظريّةً غيرَ مرتبطة بالواقع، وإنّما هو الواقعُ عينُه. ليس من المستغرَب أن يرتجف العالمُ لحركة السوق، ولا أن يوزِّعَ مواردَه بحسب طلب السوق. وللتمييز بين السوق ما قبل الرأسماليّة، والسوق الرأسماليّة، يمكن أن نقول: لو غرقتْ كلُّ السفن سنة 1100، أو توقّفتْ كلُّ الأسواق، فلن تتوقّف الحياةُ الاجتماعيّة؛ في حين أنّ أيَّ هبوطٍ للأسواق اليوم سيؤدّي إلى كارثة. المفهوم، أيُّ مفهوم، لا يحدَّد إلّا وفق الظروف التاريخيّة. والسوق هذه هي سوقٌ لتبادل السلع، وقد خرجتْ عن الإرادة الاجتماعيّة، وبنتْ في مخيِّلات الناس وهمًا، ألا وهو: أنْ لا خيارَ آخرَ غير خيار هذه السوق!
السلعة، التي تقّمصتْ عقلَها التوسّعيَّ شرائحُ البرجوازيّة، اتّخذتْ خياراتٍ تاريخيّةً مبنيّةً على تراكم قوّتها التاريخيّ (بما في ذلك قوّتُها الإيديولوجيّة)، أيْ على تراكم فائض القيمة التاريخيّ. وهكذا راحت تُمْلي تلك الخياراتِ على الناس، الذين استدخلوا الهزيمةَ، حتى حسِبوا أنّ الخياراتِ المذكورةَ فروضٌ أو طقوسٌ دينيّة عليهم أن يمارسوها! عمليّةُ التصويت السابقةُ الذكر، التي تنظَّم - زورًا - وكأنّها "العمليّةُ الديمقراطيّة،" هي من أكبر آليّات الصنميّة التي تحذف إرادةَ الجماهير. السلعةُ، أي الفاعل التاريخيّ، تضع شروطَها كي تُنتخبَ هي الأخرى مرّةً بعد مرّة كأنّها الحلُّ الأوحد. عمليّة استهلاك المجتمع لذاته مثالٌ آخر.
الديمقراطيّة شكلٌ من أشكال ممارسة السلطة. والحالات الديمقراطيّة هي تلك التي يصوِّت فيها الشعبُ لمصلحته يوميًّا من خلال السياسة اليوميّة للدولة، ويكون فيها نتاجُ التصويت اليوميّ تصويبًا لعمليّة توزيع الموارد بما يَخدم الطبقاتِ العاملة - - أيْ زيادةً في حصص الأجور والطبابة والأمن الذي لا بدّ من أن يواكب عمليّةَ التنمية؛ فالأمن هو حجرُ الأساس، وهو القوة المتمثّلة في مقارعة الإمبرياليّة.
"الحوار" مع السيف، أو الشيء، عدميّةٌ مفرِطة، نابعةٌ من عمق أزمةٍ إيديولوجيّةٍ وصل إليها عالمُ اليوم. لقد انتهت السياسةُ، كما ذكرتُ، لأنّ العالم المشيَّأ لا يحتاج إلى إعادة هيكلةٍ بإجراءاتٍ سياسيّة. ما تمليه السلعةُ يصبح هو الأمرَ الواقع.
ومع ذلك، فها نحن اليوم نقف أمام مفترقٍ أو نموذجٍ جديد، نراه في اليمن وجنوب لبنان وغزّة. والمشترَك بين كلّ هذه المناطق هو ما تُمْكن تسميتُه "حربَ الشعب." وهذه الحرب ستتوسّع، وسيتوسّع معها النموذجُ الجديد.
لكنْ ماذا عن اختلال موازين القوى في كلّ مركَّبٍ على شكلٍ هرميٍّ تكون فيه الإمبرياليّةُ، أي رأسُ المال المكثَّف، العلاقةَ الحكمَ التي تسرِّع تردادَ التداول التجاريّ وسلْخَ العامّ من أجل الخاصّ؟
هذه العمليّة الأخيرة تعني سلخَ كلّ ما هو ملْكيّةٌ عامّةٌ من أجل إعادة إنتاج المجتمع - - والأصحّ من ذلك أن نقول، في ضوء الأزمة الوجوديّة الكونيّة، من أجل إعادة "تسييل" أو هدر المجتمع؛ ما يجعل من التنقيص بما هو مُجدٍ لحياةٍ أفضل، من أجورٍ أو خدماتٍ صحّيّة، عمليّةَ إنتاج فائض القيمة بامتياز. والقيمة هنا علاقة اجتماعيّة، وليست بالشيء، كالمعنى المَنُوط بـ"القيمة المضافة." هذه لا تشبه فائضَ القيمة؛ فتلك شيء، والأخرى علاقة اجتماعيّة غير مشخصنة، وموضوعيّة، وتاريخيّة: إنّها الحمضُ النوويُّ الاجتماعيّ؛ إذا كُبّرتْ بمكبِّرٍ نظريّ، أعطتنا فكرةً عن العلاقات الطبقيّة الكلّيّة.
فماذا عن التداول السلعيّ اليوم؟
نقف في عالمٍ تستملك فيه الصينُ قدراتٍ أكبرَ من خلال تحكُّمها بدورة السِّلَع غيرِ المعسكَرة، أي السِّلَعِ التي تُجدي الحياةَ البشريّةَ خيرًا، خلافًا للتراكم والتسليع بالعسكرة الأميركيّة. هذا الأخير هو الحبلُ السُّرّيّ للكيان الصهيونيّ، الذي يشكّل بدوره طليعةَ الإنتاجيّة الإمبرياليّة المعسكَرة. لقد اختلّت موازينُ القوى في الكلّ المركَّب على شكلٍ هرميّ، وباتت العلاقةُ الإمبرياليّةُ أقلَّ تأثيرًا في تحديد مسار الأطراف. وفي حين كانت الأطرافُ تواجه أزمةً وجوديّةً حقيقيّة، أصبح مَن يواجه هذه الأزمةَ الوجوديّةَ اليوم هو الإمبرياليّةُ والكيانُ الصهيونيّ، صاحبُ الوظيفة المعسكَرة المثلى.
طبعًا هناك مَن هو فاسدٌ فكريًّا، فيرى في صعود الصين "إمبرياليّةً بديلة." الفساد هنا يكمن في استعمال المنطق الشكليّ وإسقاطِه على التاريخ. هذه ممارسة للمنهج التجريبيّ. انهزامُ الإمبرياليّة هو تراجعٌ في الإيديولوجيا المهيمنة، المبنيّة حجرًا فوق حجر، كي تصبح الصنمَ الإله، وفي الحقائق الزائفة التي يفرضها المنهجُ السائدُ على التفكير، بما في ذلك المنطقُ الطفوليّ الذي يقول: "إذا ذهب إمبرياليٌّ سيأتي غيرُه!" والحقّ أنّ صعودَ الصين يحجِّم 500 عام من التراكم الحضاريّ الهمجيّ المبنيّ على العنصريّة.
* سينطلق النموذجُ البديل، في رأيك، من أن يرى الإنسانُ نفسَه صاحبَ إرادة، في مقابل الإنسان المستلَب والمشيَّأ؟
- فلنحدّد الإنسانَ بالإنسان الاجتماعي، أيْ بالعلاقة الاجتماعيّة. وهذه العلاقة هي فئةٌ مجتزأةٌ من الطبقة الاجتماعية - أيْ من العلاقة الكبرى. على الإنسان الاجتماعيّ المستنسَلِ من الطبقة الاجتماعيّة، على عكس الإنسان المجرَّد غيرِ التاريخيّ، أن يطوِّر وعيًا منافيًا للمنظومة (anti-systemic). ولأنّ الطبقة/العلاقة الاجتماعيّة موروثٌ إيديولوجيّ، أيْ مماثلةٌ للإيديولوجيا، فسنبتعد كلّيًّا عن شخصنة التاريخ والتجريد المبتذل، أي ذاك الذي يساوي بين الظاهر المجسَّد والذهنيّ المجرَّد، كما لو كنّا نقول "هذه الوظائف تخصّ طبقة وسطى" (أساتذة المدرس) و"تلك تخصّ طبقةً عاملة" (عمّال البناء) - - هذه عمليّات قياس، لا تحديدٌ لمفهوم. إنّ تشييءَ الطبقة يلغي الذاتَ في الطبقة، وينتقص من المفهوم.
نحن أمام إيديولوجيا سائدة، هي إيديولوجيا رأس المال بوريثها الأمريكيّ؛ وهي إيديولوجيا إذا ما ناقضتْ نفسَها اختارت منافسًا من ضمن السرب أو الطيف الإيديولوجيّ ذاته؛ أيْ من دون أن يؤدّي ذلك إلى عكس المفاهيم أو الموازين بشكلٍ يَقْلب الطاولةَ على رأس المال. وكما ذكرتُ سابقًا، فإنّ رأس المال يَستثمر في نقيضٍ غير فاعل؛ أيْ إنّه يختار عدوَّه.
لكنّ دورةَ القيمة لرأس المال ليست الدورةَ السلعيّةَ المادّيّة فحسب، وإنّما دورةَ القيمة الإيديولوجيّة أو دورةَ الإيديولوجيا أوّلًا. فالانتصار الإيديولوجيّ هو مولِّدُ اتّساع السوق، والربحيّة. هناك بالطبع تفاعلٌ إيجابيٌّ بين التوسّع السلعيّ وتوسُّعِ السوق - - وهذا ما ينعكس على الإيديولوجيا. لكنْ، في هذا الكلّ المركّب، انقلبتْ تراتباتُ القوى الهرميّةُ إلى حدٍّ ما مع تقدّم الصين، وانعكس ذلك على إيديولوجيا رأس المال المهيمنة؛ وأعني تلك التي اتّخذتْ شكلَ النيوليبراليّة مؤخّرًا، وبدأتْ تتعرّى، حتى باتت موضعَ تشكيكٍ من اليمين السياسيّ - - فاليمين ليس غبيًّا، وهو يدرك أولويّةَ السياسة على الربحيّة الفوريّة.
نحن أمام مفترَق إيديولوجيّ: لقد تغيّر المقرِّرُ الجدليّ في الحركة التاريخيّة. لم تعد أميركا "على صوابٍ مهما أخطأتْ" كما في السابق. فأسسُ قوّتها الاقتصاديّة انهارت، وبدأ يتولّد من جديدٍ إرثُ الإنسانيّة الثوريّ الذي خمد لفترةٍ بعد سقوط الاتحاد السوفياتيّ.
الدورة الإيديولوجيّة التي يحدّدها رأسُ المال تلقائيّة. وأعني أنّ المنظومة لا تُصْلح نفسَها، وتقودها سلعةٌ (من المستغرَب كيف يتناسى شيوعيون عرب مفهومَ "الصنميّة"!). لذا فهي، بقوّة الانعكاس الجدليّ (Dialectical inversion)، لن يحالفها الحظُّ في اختلاق عدوٍّ ضعيفٍ في كلّ الاوقات. والصين دليل على ذلك. وهناك أدلّة قاطعة في شأن أسبقيّة التغيير الإيديولوجيّ.
هنا أطرح السؤال: هل الأطراف التي تفرز المقاومة، هنا وهناك، هي المؤثِّر المحدِّد في مجرى التاريخ، أمْ هي الكلُّ الموسِّطُ (the mediating totality) لكلّ الجزئيّات والمحدِّدة لها؟ بمعنًى آخر: هل يمكن أن تغيِّر حركاتُ التحرّر في الأطراف التركيبَ الطبقيَّ/الإيديولوجيّ، أمْ أنّنا في حاجة إلى تمفصل التعبيرات/العلاقات الجزئيّة وترابطِها مع تغيّرٍ أكبريُكْملها؟
الجواب من علم المنظومات هو أنّ منظومةَ المنظومات، التي تشكّل منظومة ذاتها، أو مركّبَ العلاقات الدوليّة، تتولّى توسيطَ قوانين التطوّر التي يمتثل الجزءُ إليها. الطرف فاعلٌ بتناغمه مع التطوّر الكلّيّ. لكنّ الماركسيّة الغربيّة تحبِّذ التجزئة وتبيع بالمفرَّق. تكتب الأشعارَ لشعبٍ نُكِب من دون أن يحصلَ على مساندةٍ دوليّة. وهذه ليست بالرومانسيّة؛ إنّها موقفٌ طبقيّ. فهي (أي الماركسيّة الغربيّة) تَعْلم أنّ الإمبرياليّة تقضي على أيّ حركة تحرّرٍ صغيرة، وبالمجازر كالعادة، لكنّها تُخفي هذا الاتجاهَ بحيث تستكين إلى منهج "ديمقراطيّ غربيّ" - لا يعوَّلُ عليه أساسًا - في "دعم" حركات التحرّر الصغيرة؛ أيْ إنّها تؤْمن ضمنيًّا بـ"ديمقراطيّة الغرب." والحقّ أنّ هذه هي "ديمقراطيّةُ" إعادةِ توزيع الرَّيْع الإمبرياليّ، ولا صلةَ لها بحكم الشعب!
في الكلّ المركّب، في علاقات الإنتاج الدوليّة، إذا لم تضعف الإيديولوجيا الإمبرياليّةُ ولم تنكسرْ هيبتُها، فلن يتغيّرَ شيء. النضالات الجزئيّة الجانبيّة تكون فاعلةً إذا كانت قبضةُ الإمبرياليّة ضعيفةً، وكانت (أي تلك النضالات) مسنودةً بفاعلٍ أكبر، هو صعودُ الصين، وإذا بتنا في نضالنا الجزئيّ - أينما كنّا - أكثرَ تأثيرًا.
الفلسفة الوضعيّة-التجريبيّة تلغي التاريخَ، أيْ تلغي الواقعَ بصيرورته. فلولا تدميرُ مقدِّرات الشعوب وسلبُ إرادتِها وإلغاءُ تنميتِها بالإمبرياليّة، في منظومةٍ مأزومةٍ بفائض الإنتاج، لَما كان هناك عمرانٌ ولا صناعةٌ في المركز. لذا، فإنّ التجريدَ الوضعيّ يجرِّد الواقعَ من القوى الفاعلة ومن تاريخه، ويلغي حقوقَ الشعوب، كلِّ الشعوب، لا الشعبِ الفلسطينيِّ وحده، وبالذات تلك الشعوبِ التي أبيدتْ لبناء ثراء الاستعمار. المصْنع الحقيقيّ هو كلُّ المجتمع الكونيّ ذي الإنتاج الاجتماعيّ والمنظَّم بصراعه الطبقيّ.
يقول كارل ماركس في الجزء الثالث من رأس المال إنّ المجتمع، ككلّ، هو مادّةٌ للصناعة. إنّ التركيز على المَصْنع الأوروبيّ بحدوده المذكورة أعلاه (الحيّز الفيزيائيّ والأسس الاقتصاديّة... إلخ) يقزِّم الاستغلالَ ويجرِّدُه من معناه. الماركسيّة الغربيّة تشدِّد على التفوّق الإنتاجيّ الغربيّ، بمعامله العالية التقنيّة وبعمّالها المنتِجين، لكنّ المنتوجَ الأهمَّ في الحقيقة هو حلقاتُ الإنتاج الدوليّة التي تتّصف بالهدر على مدى الدورة الحياتيّة، بما في ذلك هدرُ الإنسان في الحروب. الاقتصاد السياسيّ يُعنى بدور السلعة في إعادة إنتاج المجتمع، لا بتسوية معدَّل الأرباح، إلّا بما للأخير من تأثيرٍ في الأوّل. وهذه الرؤى [الماركسيّةُ الغربيّة] رؤًى أورو-مركزيّة اقتصادويّة تحذف الواقعَ وتنتقي ما يَخدم مصالحَ الإمبرياليّة.
لطالما كانت الماركسيّةُ الغربيّةُ العصا الغليظةَ للإمبرياليّة لأنّها تشوِّه الوعيَ الثوريّ. عمليّة الإنتاج هي الدورة الحياتيّة، بترابطها الكونيّ، في زمنٍ اجتماعيٍّ "ما فوق محدَّد" (overdetermined). وهذا يعني أنّ السببيّة لا ترتبط بتسلسلٍ كرونولوجيّ، وأنّ علاقةَ المتغيِّرات بعضها ببعض كيفيّةٌ ديناميكيّة، وأنّ القيمة - كشيء - تَفترض مسبّقًا علاقةَ القيمة. لذا قال ماركس، في رسالته إلى كوغلمان، إنّه لم يكن في حاجةٍ إلى أن يفنّدَ القيمةَ في فصلٍ ما؛ "فكُلّ طفلٍ يعرف ما هي القيمة."[3]
العلم معنيٌّ بدراسة العلاقة التي تتجلّى من خلالها القيمةُ/الشيء. وهذه العلاقة ما هي إلّا الصراعُ الطبقيّ في مجتمعٍ كونيّ - - ذلك المصنعِ الاجتماعيّ الذي تبقى أُولى حساباته حساباتِ توظيف العمل بإملاءات قانون القيمة. وهذا يعني إعادةَ إنتاج اليد العاملة أو طاقةِ العمل؛ وهذه هي السلعةُ الأولى والأخيرة في عمليّة الإنتاج لأنّ العاملَ هو المنتِجُ والمنتَج، المستهلِكُ والمستهلَك، في آن. فكيف لهذا المَصْنع الكونيّ أن يعيد إنتاجَ نفسه بغير العنف، في كنف ربحيّةٍ تَهْدر (أو تسيِّل) العامَّ لاقتناصه بالخاصّ؟
ما نراه في فلسطين هو نتاجٌ للخلل في الصراع الطبقيّ وفي الوعي الطبقيّ. إنه من إنجازات رأس المال. وإلّا فكيف نفسِّر صعودَ رأس المال هذا على حساب العمل - - وهو صعودٌ انتهى بالعالم إلى زمن النيوليبراليّة وإلى أوسلو؟
وأوسلو لا يخصّ الفلسطينيين فقط؛ ذلك لأنّ ما يحصل في فلسطين يؤثّر في حركة العمّال الكونيّة، ويؤثّر في الجوار بسبب كونيّة الإمبرياليّة، التي تحبك من نسيجٍ واحدٍ، وتمثّل الصهيونيّةُ رأسَ حربتها. كيف لنا أن ننهزمَ أمام علاقة اجتماعيّة – طبقة – حالة إيديولوجيّة متراكمة تتحكّم فيها سلعةٌ مُصنَّمة؟ كيف لنا أن نفاوضَ مع عقلٍ مسلّع، مع سلعةٍ تتوسّع تلقائيًّا بالعنف؟
يعود هذا إلى التنظير الخاطئ أو المماهاة بين النظريّة والإيديولوجيا. نظريًّا، لا يمكن التفاوضُ مع الكيان الصهيونيّ لأنّه يجسِّد عقلَ السلعة/الشيءِ بأقصى درجاتها. فالصهيونيّة تتعلّق بالأرض لا لدينٍ أو مبدأٍ ما، وإنّما لأنّ توسُّعَها بالحرب يوسِّع أهمَّ السلع: الحربَ والأمنَ الإمبرياليّ. ما حصل هو تنازلٌ نظريٌّ غذّى الإيديولوجيا على حساب النظريّة. لقد شُيِّئ الفكرُ حين اتُّبِع المنهجُ الإمبيريقيّ (التجريبيّ) السابقُ الذكر، والبعيدُ كلَّ البعد عن الصحّة. والتشييء (أو التمْدِية) يَخْلع التكوّنَ التاريخيَّ عن التطوّر، فتصبح المستوطَنةُ أمرًا واقعًا، نتاجَ القوّة، أيْ نتاجَ الانزلاق الإيديولوجيّ كذلك. فالإيديولوجيا لبُّ القوّة، وهذا بدوره نتاجٌ للتضحية بالتاريخ أو بالنظريّة.
ماذا عن قوّة الإيديولوجيا؟ تصوّروا أنّ الرأسماليّة، بفكرها "التنويريّ" وإيديولوجيّاتها، قتلتْ منذ 500 سنة حوالى مليار نسمة في حروبها الكولونياليّة. وهي تكاد تقضي، لا بل قضت فعليًّا، على أسس وجود الكون البيئيّة اليوم. ما حصل من دمار، وآخرُ الدراسات تحدّثتْ عن انهيار في النظام البيئيّ،[4]هو مِن فِعل الفكرةِ أو الطبقة السائدة؛ ما يثبت أنّ الناس تعيش خيالًا، وأنّ مجمل الإيديولوجيا المهيمنة ليس إلّا مؤامرةً على الشعوب. ومع ذلك، فما زال هناك مَن يتبجّح بـ"تفوّق" الغرب الثقافيّ! إذا كانت تلك هي محصّلةَ ثقافة الرأسماليّة، ناهيكم بإنتاجها المسموم، فهل ثمّة أيُّ شيءٍ "تقدّميٍّ" جاء من الرأسماليّة كحقبة تاريخيّة؟ كلّا!
لقد كانت الماركسيّةُ الغربيّة تتغنّى بـ "تقدّميّة الرأسماليّة" كي تُماثلَ تاريخَ العالم الثالث بتاريخ الغرب الدمويّ، بذريعةِ أنْ لا تقدُّمَ من دون إراقة دماء. كان هذا تبريرًا رأسماليًّا لهدرنا بعمليّة إنتاجٍ هدريّة. أصبح الهدرُ تاريخَنا، وبُرِّرَ القتلُ بـ"التقدّم التقنيّ،" الذي استُلِب منا أصلًا، وهو يُستعمل سلاحًا ضدّنا. متوسِّطُ أعمارنا أعلى بقليل من نصف أعمار الغربيين، على الرغم من توافر ذلك التقدّم التقنيّ!
* من اللافت أنّ صفقة القرن أعادت موضعةَ العلاقة بين المركز والأطراف على مستوى منطقتنا، فبدا وكأنّ هذه العلاقة باتت تمرُّ من خلال تل أبيب. صار ثمّة موقعٌ جديدٌ لـ "إسرائيل" يتجاوز فلسطينَ الجغرافيّة. هل توافقنا الرأي؟
- ثمّة ورقةٌ لفاندر هوفن ليون هارد (1960)، عنوانُها "الحقيقة عن فلسطين."[5] الورقة تتحدّث عن الحقائق التي يبنيها المستوطنون على الأرض؛ فهم يَخْلقون واقعًا على الأرض، اسمُه واقعُ القوّة. تقول ليون هارد إنّ ذلك لا يعني شيئًا ما لم يقبلْه الشعبُ الفلسطينيُّ أو العربيّ؛ وبذا لا يصبح - أبدًا - واقعًا مكتملًا أو حقًّا.
منذ العام 1960، تمدَّدتْ "إسرائيل." وهي اليوم أكثرُ ارتباطًا بالرجعيّة العربيّة، التي هي أصلًا امتدادٌ للصهيونيّة؛ ذلك لأنّ دورة هذه الرجعيّة غيرُ إنتاجيّة، والخليج أساسًا مستتبَعٌ بالكيان. الموألة تُدوْلِرُ أسسَ الطبقات وتجانسها. وعليه، فقد جاءت "الصفقة" لاستغلال نضوج الظرف الطبقيّ، ولخلق اصطفافِ قوّةٍ جديدٍ يناهض الصينَ.
صفقة القرن انعكاسٌ هزليٌّ لأمبراطوريّةٍ في طورالأفول. التوسّع على الأرض يجب أن يواكبَه أو يسبقَه توسّعٌ فكريٌّ إيديولوجيٌّ معلِّلٌ له - وما هذا بحاصلٍ على الرغم من تواطؤ السلطة الفلسطينيّة. اليوم، الموازين الدوليّة تغيّرتْ مع نهوض الصين، التي برهنتْ من خلال تعاملها مع الكورونا مؤخّرًا قدراتٍ اجتماعيّةً عالية. والمستعمِر الغربيّ، الذي أمدّ الكيانَ الاستيطانيَّ بالتبرير الخرافيّ للتطهير العرقيّ، ولّى.
يستحيل إنهاءُ الصراع في فلسطين من دون هزيمة الإمبرياليّة، ومن دون تكاتُف القوى العاملة ضدّها. إنّ فلسطين هي نقطةُ ارتكازٍ في عمليّة التراكم الدوليّ، وهي المرسى في إعادة إنتاج الطبقة العاملة الدوليّة، لِما تبثّه الصهيونيّةُ من قوّةٍ للإمبرياليّة. هذا التركيز الإمبرياليّ على فلسطين ليس بعقدة ذنْب الرجل الأبيض؛ فـ"الشيء" لا يَعْرف الذَّنْبَ. وإنّما التركيزُ هو مصلحةٌ كلّيّةٌ هدفُها استهلاكُ الإنسان والبيئة في عمليّةٍ إنتاجيّةٍ هدريّةٍ كونيّةٍ لا يستمرّ فيها الإنسانُ ما لم يناضلْ من أجل البقاء - - وهنا أعني "البقاء" حرْفيًّا؛ فالكوكبُ تآكل!
لكنّ القوى الرجعيّة العربيّة تحتاج إلى اعتراف الشعب العربيّ بـ "إسرائيل." وهذا مستحيلٌ لأسبابٍ وجوديّة، ناهيكم بسبب حبّ الشعب للوطن. هذه حربٌ طبقيّة، والحربُ الطبقيّة عمليّةُ تراكُم. فإذا خسرت الطبقةُ العاملةُ في فلسطين، خسرتْ معظمُ الطبقات العاملة أسسَ وجودها وإعادةِ إنتاج ذاتها، أي خسرتْ خبزَها. سيَكْبر التراكمُ بالهدر، وسيموت فعليًّا عددٌ أكبرُ من الناس في صناعات الحروب، أو في متوسّط عمرٍ أقلّ مرتبطٍ بالتقشّف الناتج من انتصار الإمبرياليّة.
إنّ الدورة الاقتصاديّة هي، فعليًّا، دورةُ الصراع الطبقيّ عالميًّا. وبهذا أعني أنّ الطبقة العاملة ليست الطبقةَ الفلسطينيّةَ وحدها، بل الدوليّةَ أيضًا. زدْ على ذلك أهمّيّةَ القضيّة الفلسطينيّة في ميزان القوى الدوليّ. كما أعني بـ "الدورة الاقتصاديّة" دورةَ القيمة المتعلّقة بالوعي الطبقيّ؛ فعلاقةُ القيمة علاقةُ ذاتٍ بذات، وعلاقةُ الذات بالغرض؛ إنّها الذاتيّة المتكوِّنة في رحم الوعي الطبقيّ. والربحيّة تَنْتج من تكثيف ساعات العمل الضروريّة، لكنها أوّلًا تَنتج من تدمير الذات وتشويهِ الوعي؛ من سلب الإنسان إرادتَه، ومن استعبادِه. العبد لا يفاوِضُ أجرَه. العبد هو الإنسان/الشيء المتكامل الذي أصبح ماكينةً. لكنْ، بحكم التغاير الجدليّ، لا تفرز الماكينةُ فائضَ قيمة؛ فهي عملٌ ميت.
لذا، فإنّ الدورة الاقتصاديّة والربحيّة منوطةٌ بقدرة رأس المال على خلق إيديولوجيا عمّاليّة بديلة لا تنافي المنظومةَ الرأسماليّة، بل تكون هذه الأخيرةُ قادرةً على سحقها. من هنا تَنبع الماركسيّةُ الغربيّة، والليبراليّةُ، والأنجزةُ (من NGOs= منظّمات مجتمع مدنيّ) كي تساهم جميعُها في دورة تكرار السحق وإلغاء الوجود المتكرّر للعمل. ولذلك، فإنّ قضيّة فلسطين أولويّةٌ نظريّة.
أعود وأذكّر بأنّ الرجعيّة العربيّة والصهيونيّة والإمبرياليّة طبقةٌ أو علاقةٌ مبنيّة على أرضيّةٍ مادّيّةٍ واحدة. لكنْ أضيفُ الآن أنّ الرجعيّة العربيّة هي في أسفل التراتب الطبقيّ. لذا، لا إشكالَ عند الصهيونيّة-الإمبرياليّة في التخلّي عن هذه الرجعيّة، كما فعلتْ حين تخلّت عن مبارك أو زين العابدين بن علي أو شاه إيران. التراكم بالهدر يَستهلك، كمدخل، الدولَ بمن فيها.
ثمّ إنّ الإمبرياليّة، في سيطرتها على منطقتنا، تزيد هيمنتَها على الكون. وبسبب أهمّيّة منطقتنا في عمليّة الارتكاز التراكميّ لرأس المال، فإنّ هذه الطبقة (أي التحالف الإمبرياليّ الصهيونيّ الرجعيّ) كلّما تحكّمتْ بقدرات الشعب الفلسطينيّ، قويتْ على غيرها من الشعوب أيضًا. لذا من الممكن أن تتنازل الإمبرياليّةُ والصهيونيّةُ للشرائح الحاكمة في فلسطين، بشراء ذممٍ هنا وهناك، ببطاقات VIP، لكنْ على حساب الملايين التي استُشهدتْ في الجوار. وللتذكير، فإنّ أصحاب الـVIP مشاركون في الحروب على سورية والعراق.
منظومة العلاقات الطبقيّة تخلق عدوَّها التي تستريح إليه بشكلٍ دائم، ولا يمكن أن تستكين. وعندما يقول جورج حبش إنّ جوهرَ الكيان الصهيونيّ هو جوهرٌ توسّعيٌّ وعدائيّ، فهو يقول إنّ هذا الكيان لن يَقبل معنا بأيّ اتفاقٍ حتّى إنْ قبلناه نحن. فالتدمير هو منظومةُ عمل "إسرائيل" لأنّه رأسُ الحربة في عمليّة الإنتاج الهدريّ نفسِها.
التوسّع الصهيونيّ عمليّةُ إنتاجٍ من ضمن عمليّة التراكم بالتدمير والهيمنة. إنّ قاعدة إنتاج الصراع العربيّ -الصهيونيّ ليست مبنيّةً فقط على "حبّ الوطن" الذي ذكرناه أعلاه، على الرغم من وجود هذا الحبّ. ذلك أنّ حبَّ الوطن جزءٌ فحسب من الذاكرة الجماعيّة التي تتجدّد مع ظروف إعادة إنتاج الذات الاجتماعيّة. حبُّ الوطن (وحبُّ العودة إليه) لا يموت مع اضمحلال الذاكرة لأنّ العدوان الصهيو-إمبرياليّ يجدِّد إحياءَ هذه الذاكرة ما دام يقضي على أسس وجودنا. العلاقة الإمبرياليّة هي تحديدًا حربُ وجود، ليس لشعوبنا فحسب، بل لكلّ شعوب الأرض أيضًا، وللأرض ككيانٍ بيئيٍّ كذلك. وعمليّةُ استهلاك الأرض والإنسان، بإلغاءِ وجودهما، هي المدخلات الإنتاجيّة في عمليّة التراكم الهدريّ الذي يشكّل الشطرَ المقرِّرَ في علاقة رأس المال.
وعليه، فحين يقال "إنّ حربَنا مع الكيان الصهيونيّ حربُ وجود،" فهذه ليست عبارةً مجازيّةً، وإنّما واقعًا حقيقيًّا يُعاش منذ نشأة هذا الكيان. فلننظرْ إلى هذا الدمار الشامل الذي حلّ بنا، لا في فلسطين وحدها وإنّما في المنطقة كلّها: ملايين هُجّرتْ، وقُتلتْ، والحبلُ على الجرّار. أوَليست هذه حربَ إلغاء؟!
هناك نوعٌ من الترابط والتقاطع بين التقاء السياسات الاستسلاميّة لبرجوازيّة أوسلو، ومعدَّلاتِ التدمير في الجوار العربيّ والإسلاميّ. هذه الشريحة تُشارك الإمبرياليّةَ - النسيجَ الواحدَ - في إعادة صياغة مدخلات إنتاجها بالإفراغ السكّانيّ، المركّبِ على سيرورة العمل، كي تنتج القيمةَ بإعادة هيكلة موازين القوى لصالح الإمبرياليّة.
* هل تعبِّر "صفقةُ القرن" عن أزمةٍ إيديولوجيّة كونيّة؛ عن أزمة السياسة في زمنِ "ما بعد النهايات" الذي طالعَنا بها عددٌ من المثقّفين الغربيين إبّان سقوط الاتحاد السوفياتيّ؟
- نعيش اليوم أزمةً إيديولوجيّةً عميقة. الخطورة في الموضوع أنّه عندما تكون أزمةٌ كهذه، ناتجةً من فقدان الفاعليّة التاريخيّة للعمل، تنفرد السلعةُ بالسلطة، وتشيِّئ الرأسماليَّ معها - - فنصبح أمام سلطةِ السلعة/الشيءِ الذي يرتكز على الموألة والتي باختزالها المكان بالزمن من أجل تسريع التبادل تُنتج فائضَ القيمة بالطرق الهدريّة أكثر فاكثر. أي إنّها تنتقص من حياة البشر بتسييل رزقها، كالخصخصة مثلًا.
هنا يَحْضرني غسّان كنفاني، عندما سأله مراسلٌ أستراليٌّ: "لماذا لا تنخرط منظّمتُكم [المقصود: الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين] في مباحثات سلام؟" فأجابه: "هذا نوعٌ من الحوار بين السيف والرقبة!"[6]هذه نقطةٌ مهمّة، لأنّ كنفاني يشير إلى طبيعة موازين القوى المختلّة التي تُضْمرُها هذه "المباحثات." لكنْ يمكننا، انطلاقًا من هذا القول، الذهابُ أبعدَ من ذلك. نحن اليوم لا نفاوض السيّافَ الذي يمتلك هذا السيفَ. نحن اليوم، مع ترامب، وفي ظلّ العقليّة التشييئيّة التي تحكم عالمَ اليوم، نفاوض السيفَ، الأداةَ، الشيءَ؛ لا هو قادرٌ على فهمنا، ولا نحن قادرون على الحديث معه.
السيف/الشيء هنا علاقةٌ اجتماعيّةٌ محكومةٌ بموازين السوق. السلعة/السيف محكومةٌ بعلاقاتها التوسّعيّة، لأنّها تطمح إلى زيادة إنتاج ذاتها من خلال خفض تكاليف هذا الإنتاج نفسه. وخفضُ التكاليف يعني تخفيضَ ما هو متوفّر للإنسان الاجتماعيّ - - بما في ذلك تقصيرُ عمره.
هذا التصوّرُ لعالمٍ محكومٍ بروحِ سلعةٍ تستبطن القيمةَ، وتتوسّع من ذاتها ضروريًّا (لكنْ ليس استثنائيًّا) بالعنف، ليس صورةً نظريّةً غيرَ مرتبطة بالواقع، وإنّما هو الواقعُ عينُه. ليس من المستغرَب أن يرتجف العالمُ لحركة السوق، ولا أن يوزِّعَ مواردَه بحسب طلب السوق. وللتمييز بين السوق ما قبل الرأسماليّة، والسوق الرأسماليّة، يمكن أن نقول: لو غرقتْ كلُّ السفن سنة 1100، أو توقّفتْ كلُّ الأسواق، فلن تتوقّف الحياةُ الاجتماعيّة؛ في حين أنّ أيَّ هبوطٍ للأسواق اليوم سيؤدّي إلى كارثة. المفهوم، أيُّ مفهوم، لا يحدَّد إلّا وفق الظروف التاريخيّة. والسوق هذه هي سوقٌ لتبادل السلع، وقد خرجتْ عن الإرادة الاجتماعيّة، وبنتْ في مخيِّلات الناس وهمًا، ألا وهو: أنْ لا خيارَ آخرَ غير خيار هذه السوق!
السلعة، التي تقّمصتْ عقلَها التوسّعيَّ شرائحُ البرجوازيّة، اتّخذتْ خياراتٍ تاريخيّةً مبنيّةً على تراكم قوّتها التاريخيّ (بما في ذلك قوّتُها الإيديولوجيّة)، أيْ على تراكم فائض القيمة التاريخيّ. وهكذا راحت تُمْلي تلك الخياراتِ على الناس، الذين استدخلوا الهزيمةَ، حتى حسِبوا أنّ الخياراتِ المذكورةَ فروضٌ أو طقوسٌ دينيّة عليهم أن يمارسوها! عمليّةُ التصويت السابقةُ الذكر، التي تنظَّم - زورًا - وكأنّها "العمليّةُ الديمقراطيّة،" هي من أكبر آليّات الصنميّة التي تحذف إرادةَ الجماهير. السلعةُ، أي الفاعل التاريخيّ، تضع شروطَها كي تُنتخبَ هي الأخرى مرّةً بعد مرّة كأنّها الحلُّ الأوحد. عمليّة استهلاك المجتمع لذاته مثالٌ آخر.
الديمقراطيّة شكلٌ من أشكال ممارسة السلطة. والحالات الديمقراطيّة هي تلك التي يصوِّت فيها الشعبُ لمصلحته يوميًّا من خلال السياسة اليوميّة للدولة، ويكون فيها نتاجُ التصويت اليوميّ تصويبًا لعمليّة توزيع الموارد بما يَخدم الطبقاتِ العاملة - - أيْ زيادةً في حصص الأجور والطبابة والأمن الذي لا بدّ من أن يواكب عمليّةَ التنمية؛ فالأمن هو حجرُ الأساس، وهو القوة المتمثّلة في مقارعة الإمبرياليّة.
"الحوار" مع السيف، أو الشيء، عدميّةٌ مفرِطة، نابعةٌ من عمق أزمةٍ إيديولوجيّةٍ وصل إليها عالمُ اليوم. لقد انتهت السياسةُ، كما ذكرتُ، لأنّ العالم المشيَّأ لا يحتاج إلى إعادة هيكلةٍ بإجراءاتٍ سياسيّة. ما تمليه السلعةُ يصبح هو الأمرَ الواقع.
ومع ذلك، فها نحن اليوم نقف أمام مفترقٍ أو نموذجٍ جديد، نراه في اليمن وجنوب لبنان وغزّة. والمشترَك بين كلّ هذه المناطق هو ما تُمْكن تسميتُه "حربَ الشعب." وهذه الحرب ستتوسّع، وسيتوسّع معها النموذجُ الجديد.
لكنْ ماذا عن اختلال موازين القوى في كلّ مركَّبٍ على شكلٍ هرميٍّ تكون فيه الإمبرياليّةُ، أي رأسُ المال المكثَّف، العلاقةَ الحكمَ التي تسرِّع تردادَ التداول التجاريّ وسلْخَ العامّ من أجل الخاصّ؟
هذه العمليّة الأخيرة تعني سلخَ كلّ ما هو ملْكيّةٌ عامّةٌ من أجل إعادة إنتاج المجتمع - - والأصحّ من ذلك أن نقول، في ضوء الأزمة الوجوديّة الكونيّة، من أجل إعادة "تسييل" أو هدر المجتمع؛ ما يجعل من التنقيص بما هو مُجدٍ لحياةٍ أفضل، من أجورٍ أو خدماتٍ صحّيّة، عمليّةَ إنتاج فائض القيمة بامتياز. والقيمة هنا علاقة اجتماعيّة، وليست بالشيء، كالمعنى المَنُوط بـ"القيمة المضافة." هذه لا تشبه فائضَ القيمة؛ فتلك شيء، والأخرى علاقة اجتماعيّة غير مشخصنة، وموضوعيّة، وتاريخيّة: إنّها الحمضُ النوويُّ الاجتماعيّ؛ إذا كُبّرتْ بمكبِّرٍ نظريّ، أعطتنا فكرةً عن العلاقات الطبقيّة الكلّيّة.
فماذا عن التداول السلعيّ اليوم؟
نقف في عالمٍ تستملك فيه الصينُ قدراتٍ أكبرَ من خلال تحكُّمها بدورة السِّلَع غيرِ المعسكَرة، أي السِّلَعِ التي تُجدي الحياةَ البشريّةَ خيرًا، خلافًا للتراكم والتسليع بالعسكرة الأميركيّة. هذا الأخير هو الحبلُ السُّرّيّ للكيان الصهيونيّ، الذي يشكّل بدوره طليعةَ الإنتاجيّة الإمبرياليّة المعسكَرة. لقد اختلّت موازينُ القوى في الكلّ المركَّب على شكلٍ هرميّ، وباتت العلاقةُ الإمبرياليّةُ أقلَّ تأثيرًا في تحديد مسار الأطراف. وفي حين كانت الأطرافُ تواجه أزمةً وجوديّةً حقيقيّة، أصبح مَن يواجه هذه الأزمةَ الوجوديّةَ اليوم هو الإمبرياليّةُ والكيانُ الصهيونيّ، صاحبُ الوظيفة المعسكَرة المثلى.
طبعًا هناك مَن هو فاسدٌ فكريًّا، فيرى في صعود الصين "إمبرياليّةً بديلة." الفساد هنا يكمن في استعمال المنطق الشكليّ وإسقاطِه على التاريخ. هذه ممارسة للمنهج التجريبيّ. انهزامُ الإمبرياليّة هو تراجعٌ في الإيديولوجيا المهيمنة، المبنيّة حجرًا فوق حجر، كي تصبح الصنمَ الإله، وفي الحقائق الزائفة التي يفرضها المنهجُ السائدُ على التفكير، بما في ذلك المنطقُ الطفوليّ الذي يقول: "إذا ذهب إمبرياليٌّ سيأتي غيرُه!" والحقّ أنّ صعودَ الصين يحجِّم 500 عام من التراكم الحضاريّ الهمجيّ المبنيّ على العنصريّة.
* سينطلق النموذجُ البديل، في رأيك، من أن يرى الإنسانُ نفسَه صاحبَ إرادة، في مقابل الإنسان المستلَب والمشيَّأ؟
- فلنحدّد الإنسانَ بالإنسان الاجتماعي، أيْ بالعلاقة الاجتماعيّة. وهذه العلاقة هي فئةٌ مجتزأةٌ من الطبقة الاجتماعية - أيْ من العلاقة الكبرى. على الإنسان الاجتماعيّ المستنسَلِ من الطبقة الاجتماعيّة، على عكس الإنسان المجرَّد غيرِ التاريخيّ، أن يطوِّر وعيًا منافيًا للمنظومة (anti-systemic). ولأنّ الطبقة/العلاقة الاجتماعيّة موروثٌ إيديولوجيّ، أيْ مماثلةٌ للإيديولوجيا، فسنبتعد كلّيًّا عن شخصنة التاريخ والتجريد المبتذل، أي ذاك الذي يساوي بين الظاهر المجسَّد والذهنيّ المجرَّد، كما لو كنّا نقول "هذه الوظائف تخصّ طبقة وسطى" (أساتذة المدرس) و"تلك تخصّ طبقةً عاملة" (عمّال البناء) - - هذه عمليّات قياس، لا تحديدٌ لمفهوم. إنّ تشييءَ الطبقة يلغي الذاتَ في الطبقة، وينتقص من المفهوم.
نحن أمام إيديولوجيا سائدة، هي إيديولوجيا رأس المال بوريثها الأمريكيّ؛ وهي إيديولوجيا إذا ما ناقضتْ نفسَها اختارت منافسًا من ضمن السرب أو الطيف الإيديولوجيّ ذاته؛ أيْ من دون أن يؤدّي ذلك إلى عكس المفاهيم أو الموازين بشكلٍ يَقْلب الطاولةَ على رأس المال. وكما ذكرتُ سابقًا، فإنّ رأس المال يَستثمر في نقيضٍ غير فاعل؛ أيْ إنّه يختار عدوَّه.
لكنّ دورةَ القيمة لرأس المال ليست الدورةَ السلعيّةَ المادّيّة فحسب، وإنّما دورةَ القيمة الإيديولوجيّة أو دورةَ الإيديولوجيا أوّلًا. فالانتصار الإيديولوجيّ هو مولِّدُ اتّساع السوق، والربحيّة. هناك بالطبع تفاعلٌ إيجابيٌّ بين التوسّع السلعيّ وتوسُّعِ السوق - - وهذا ما ينعكس على الإيديولوجيا. لكنْ، في هذا الكلّ المركّب، انقلبتْ تراتباتُ القوى الهرميّةُ إلى حدٍّ ما مع تقدّم الصين، وانعكس ذلك على إيديولوجيا رأس المال المهيمنة؛ وأعني تلك التي اتّخذتْ شكلَ النيوليبراليّة مؤخّرًا، وبدأتْ تتعرّى، حتى باتت موضعَ تشكيكٍ من اليمين السياسيّ - - فاليمين ليس غبيًّا، وهو يدرك أولويّةَ السياسة على الربحيّة الفوريّة.
نحن أمام مفترَق إيديولوجيّ: لقد تغيّر المقرِّرُ الجدليّ في الحركة التاريخيّة. لم تعد أميركا "على صوابٍ مهما أخطأتْ" كما في السابق. فأسسُ قوّتها الاقتصاديّة انهارت، وبدأ يتولّد من جديدٍ إرثُ الإنسانيّة الثوريّ الذي خمد لفترةٍ بعد سقوط الاتحاد السوفياتيّ.
الدورة الإيديولوجيّة التي يحدّدها رأسُ المال تلقائيّة. وأعني أنّ المنظومة لا تُصْلح نفسَها، وتقودها سلعةٌ (من المستغرَب كيف يتناسى شيوعيون عرب مفهومَ "الصنميّة"!). لذا فهي، بقوّة الانعكاس الجدليّ (Dialectical inversion)، لن يحالفها الحظُّ في اختلاق عدوٍّ ضعيفٍ في كلّ الاوقات. والصين دليل على ذلك. وهناك أدلّة قاطعة في شأن أسبقيّة التغيير الإيديولوجيّ.
هنا أطرح السؤال: هل الأطراف التي تفرز المقاومة، هنا وهناك، هي المؤثِّر المحدِّد في مجرى التاريخ، أمْ هي الكلُّ الموسِّطُ (the mediating totality) لكلّ الجزئيّات والمحدِّدة لها؟ بمعنًى آخر: هل يمكن أن تغيِّر حركاتُ التحرّر في الأطراف التركيبَ الطبقيَّ/الإيديولوجيّ، أمْ أنّنا في حاجة إلى تمفصل التعبيرات/العلاقات الجزئيّة وترابطِها مع تغيّرٍ أكبريُكْملها؟
الجواب من علم المنظومات هو أنّ منظومةَ المنظومات، التي تشكّل منظومة ذاتها، أو مركّبَ العلاقات الدوليّة، تتولّى توسيطَ قوانين التطوّر التي يمتثل الجزءُ إليها. الطرف فاعلٌ بتناغمه مع التطوّر الكلّيّ. لكنّ الماركسيّة الغربيّة تحبِّذ التجزئة وتبيع بالمفرَّق. تكتب الأشعارَ لشعبٍ نُكِب من دون أن يحصلَ على مساندةٍ دوليّة. وهذه ليست بالرومانسيّة؛ إنّها موقفٌ طبقيّ. فهي (أي الماركسيّة الغربيّة) تَعْلم أنّ الإمبرياليّة تقضي على أيّ حركة تحرّرٍ صغيرة، وبالمجازر كالعادة، لكنّها تُخفي هذا الاتجاهَ بحيث تستكين إلى منهج "ديمقراطيّ غربيّ" - لا يعوَّلُ عليه أساسًا - في "دعم" حركات التحرّر الصغيرة؛ أيْ إنّها تؤْمن ضمنيًّا بـ"ديمقراطيّة الغرب." والحقّ أنّ هذه هي "ديمقراطيّةُ" إعادةِ توزيع الرَّيْع الإمبرياليّ، ولا صلةَ لها بحكم الشعب!
في الكلّ المركّب، في علاقات الإنتاج الدوليّة، إذا لم تضعف الإيديولوجيا الإمبرياليّةُ ولم تنكسرْ هيبتُها، فلن يتغيّرَ شيء. النضالات الجزئيّة الجانبيّة تكون فاعلةً إذا كانت قبضةُ الإمبرياليّة ضعيفةً، وكانت (أي تلك النضالات) مسنودةً بفاعلٍ أكبر، هو صعودُ الصين، وإذا بتنا في نضالنا الجزئيّ - أينما كنّا - أكثرَ تأثيرًا.
 Hitskin.com
Hitskin.com