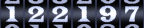أحببت مهنتي و كرهتها في آن واحد، فالتعامل بشكل يومي مع عجائز استغنت عنهم عائلاتهم و ألقوهم في مكان مجهول ليواجهوا، فيما تبقى من أعمارهم، ألم الوحدة و نكران الجميل، مع هواجس الخوف من المرض و الموت ثم الدفن دون أن يكونوا محاطين بأبنائهم و أحفادهم و أفراد عائلاتهم، أمرٌ منهكٌ جداً للروح، كنت أسمعه يومياً و دائماً و في كل دقيقةٍ من الساعات الثمان التي أقضيها في هذا المأوى المتهالك فقير الخدمات للعجائز. كان تابعاً للدولة يعتمد في نفقاته على ما يقدمه أهل الخير من معونات و تبرعات، مادية و عينية، بينما تكتفي الدولة بإرسال لجنةٍ للتفتيش كل عدة أشهر، لجنةٌ لا تفعل شيئاً أكثر من شرب القهوة في مكتب المديرة، بعدها توصي بإقرار نفس المنحة التي لا تكفي لأي شيء، أو زيادتها زيادة طفيفة لا تكفي هي الأخرى لأي شيء، كان كل النزلاء ممن ألقي بهم في الشارع من قبل عائلاتهم، هكذا بلا ذرة رحمة، و دون أن يفكروا للحظة ما الذي سيفعله هؤلاء المساكين و قد بلغوا أرذل العمر، و هم بلا مأوى أو قوة تعينهم على كسب الرزق، و أيضاً هم بحاجة ملحة لرعاية صحية بعد أن تمكنت منهم أمراض الشيخوخة، كان الكثير منهم يموتون في الشوارع تحت وطأة البرد أو الجوع أو بسبب المرض و القهر. لدينا هنا عادة غريبة، و هي أن الآباء -غالباً- ما يكتبون أملاكهم للأبناء و هم على قيد الحياة، و تلك الأملاك في غالبها لا تتجاوز منزلاً ضيقاً- ستوديو- اشتراه الأبوان بعد سنوات من الكد و العمل ليل نهار، و ما أن يكبر الأبناء، ثم يتزوجون و ينجبون حتى يضيق المكان بالجميع، و من هنا إما أن يضطر الآباء إلى اللجوء إلى إحدى دور الرعاية بنفسهم، أو يطردهم أبناؤهم إلى الشارع، و أصبح من الشائع في بلادنا أن ترى العجائز، من الجنسين، متوسدين الأرصفة و الطرقات، متلفعين بأردية ثقيلة، ربما تبرع لهم بها بعض أهل الخير، رائحتهم لا تطاق، و على وجوههم كل بؤس الدنيا. كانوا يقولون لي: كل أملنا أن نموت، لم يعد لنا ما نعيش أو من نعيش من أجله، هكذا كان الموت أمنية عزيزة تزور، بين آن و آخر، من يسميه النزلاء بالمحظوظ! و في كل مرةٍ كان يأتي فيها نزيل جديد، طوعاً و باختياره، إذ كان على من يريد الالتحاق بالمأوى أن يقدم ما يثبت أنه يستحق بالفعل البقاء، كان يعرض علي الكثير من الحالات يومياً، و العدد محدود و علي أن أختار من بينها، و كانوا كلهم يستحقون الرعاية، في كل مرة يأتي فيها نزيل، كنت أبكي بحرارة بعد أن أنتهي من الحديث إليه و تقييم حالته، و كان علي أن أقيم و أقارن و أستبعد من هم أقل حاجة للرعاية، كنت أبكي و أنا أقول لزوجي: ما الذي علي أن أفعله؟ أنا أرفض حالات أقل احتياجاً للرعاية ممن قبلت، لكن هذا لا يعني أنهم لا يستحقون الرعاية أيضاً! نظرة الانكسار في أعينهم بينما أعلمهم بنبأ الرفض، و خطواتهم الهرمة التي آيست من كل شيء فيما يغادرونني و قد زاد انحناؤهم، تقتلني! كان زوجي يسمي الملجأ، مقبرة الأفيال، حيث يلجأ من يأسوا من الحياة و البشر إليه ليموتوا بسلام، كان تشبيهاً دقيقاً لكنه مؤلم.. يؤلمني و إن لم أخبره بهذا، و كان يقول لي و هو يضمني إلى صدره، بينما نحن غاطسان في حوض الاستحمام: انظري للجانب المشرق، ألا يسعدك أيضاً قبول من ترفعين تقاريرهم بالاستحقاق للإدارة؟ و كنت أهز رأسي قائلةً: أكيد. لكنني أبداً لم أكن أكيدةً من هذا، و كنت أسأل نفسي دائماً: أيهما الأوفر حظاً بين الفريقين؟ من يرفض ليموت في الشارع موتة حيوانٍ شريد، أم من يقبل ليموت هنا موتة حيوان أيضاً، بعد سجن و إهمال و سوء معاملة، و نقص شديد في كل الاحتياجات الضرورية؟ يضمني أكثر و يقول: اكتبي عن كل هذا، هل نسيت موهبتك؟ أخرجي المكبوت بداخلك إلى الورق، فضفضي إلى قلمك فهو الوحيد الذي سوف يظل يسمعك دون ملل. ثم ضاحكاً: و ربما أنا أيضاً لبعض الوقت.
بعد العام الأول من الزواج، لم نعد نتعارك على الأصحن و الجوارب و مباريات كرة القدم و مسلسلي المفضل، في العام الثاني بعنا السيارة نظير مبلغ زهيد دفعناه مقدم عام كامل إلى مدرسة ابننا، بعدها لم نعد نتشارك البانو عند الاستحمام، في العام الرابع صرت لا أسأله عن سير عمله، و لا يسأل هو عن (مقبرة الأفيال) حتى هذا الاسم الذي كان يضايقني افتقدته و شعرت بحنين جارف إلى سماعه، في العام الخامس، و حين أصبحنا ننام و كل منا ظهره للآخر، و صبيحة يوم بارد قبل أن نتبادل تحية الصباح، قال: إذاً؟ أطرقت قليلاً و أجبته: أظنه قد آن الأوان. قبلها بأسابيع كانت قد جاءته فرصة للعمل كمصور في إحدى الجرائد في كندا، الحديث عن كيف حصل على الفرصة ليس مهماً، فهي تفاصيل لم أسأل أنا حتى عنها، المهم أن الفرصة قد جاءته أخيراً، كانت مفاجأة غير متوقعة، فرحت لأجله بالطبع، لكنها أربكتني و أوقعتني في الحيرة، و استغرقني الأمر أسبوعين من التفكير المتواصل لأقول: لا، لن أذهب. و هو الذي لم يكن لديه استعداد للتضحية بفرصة عمره، قال: حسناً كما تشائين. لو أنه ألح علي قليلاً، لربما وافقت، قلت له أنني لا أطيق الغربة، و أن عملي هو حياتي و أنه رسالة إنسانية عظيمة ليس من السهولة التضحية بها و بلا بلا بلا..أشياء كثيرة من مثل هذا الكلام الكبير، كلام الإنشاء المرسل، كان جزءًا كبيراً منه صحيحاً، لكنني قلته ليقول: أنا لن أسافر من غيرك، و ساعتها كنت سأسلم له نفسي بكل تفاصيلها، كلمة كنت انتظرها منه لتذيب سد الجليد الذي تراكم بيني و بينه، لكنه قال: كما تشائين! بعدها، متأخراً جداً قال: لو قلت لي ابق من أجلي، لبقيت. كلانا كان يجاهد ليبقي على الآخر.. ليبقي على العلاقة، كلانا تمسك بأهداب الأمل لآخر لحظة، و كلانا تلهف لسماع كلمة واحدة من الآخر، لكن كلانا صمت، و هكذا انتهى كل شيء. اتفقنا في ذاك الصباح البارد على الانفصال، هكذا ببساطة و دون مقدمات، و بهدوء من يناقش حلقة الأمس من مسلسليهما المفضل
"و الولد؟ "
قال، فنظرت إليه و صمت. كنت أعلم أن فرصه هناك أكبر بكثير من فرصه في دولة فقيرة كبلادنا، كنت أقول دائماً أن الحب تضحية، لكنني لم أضح من أجل من أحببت، كان من الممكن أن أتغاضى عن بروده و أبدأ صفحة جديدة أشعلها أنا و أجبره على الانصهار معي، لم يكن ليقاوم، و كان ينتظر، لو أنه لا يريدني لما طلب مني أن أصاحبه إلى كندا، كان سوف يخبرني و يسافر بكل بساطة، كانت محاولته تلك هي الحجر الأخير الذي ألقاه لتحريك الماء الراكد.. أنا لم أفهمه، هو أيضاً لم يفهمني، كان عليه أن يفهمني، لماذا يأخذ الرجال كل شيء كما هو؟ بسطحية شديدة؟! لم لا يحاولون قليلاً أن يفكروا في الكامن الخفي وراء ما نقول؟ لقد قلت كلاماً كثيراً.. سقت مبررات ظاهرها عدم الرغبة، لكن باطنها كان مفعماً بمشاعر الشوق و الاحتياج، أنا فقط أردت أن أقول له ابق معي هنا و سوف نحقق كل ما نريد سوياً و بقوة الحب، أردته أن يأخذني بين أحضانه..افتقدت عناقه، و لو فعلها، أو ربما لو فعلتها أنا!..
#مقبرة_الأفيال
#رواية
بعد العام الأول من الزواج، لم نعد نتعارك على الأصحن و الجوارب و مباريات كرة القدم و مسلسلي المفضل، في العام الثاني بعنا السيارة نظير مبلغ زهيد دفعناه مقدم عام كامل إلى مدرسة ابننا، بعدها لم نعد نتشارك البانو عند الاستحمام، في العام الرابع صرت لا أسأله عن سير عمله، و لا يسأل هو عن (مقبرة الأفيال) حتى هذا الاسم الذي كان يضايقني افتقدته و شعرت بحنين جارف إلى سماعه، في العام الخامس، و حين أصبحنا ننام و كل منا ظهره للآخر، و صبيحة يوم بارد قبل أن نتبادل تحية الصباح، قال: إذاً؟ أطرقت قليلاً و أجبته: أظنه قد آن الأوان. قبلها بأسابيع كانت قد جاءته فرصة للعمل كمصور في إحدى الجرائد في كندا، الحديث عن كيف حصل على الفرصة ليس مهماً، فهي تفاصيل لم أسأل أنا حتى عنها، المهم أن الفرصة قد جاءته أخيراً، كانت مفاجأة غير متوقعة، فرحت لأجله بالطبع، لكنها أربكتني و أوقعتني في الحيرة، و استغرقني الأمر أسبوعين من التفكير المتواصل لأقول: لا، لن أذهب. و هو الذي لم يكن لديه استعداد للتضحية بفرصة عمره، قال: حسناً كما تشائين. لو أنه ألح علي قليلاً، لربما وافقت، قلت له أنني لا أطيق الغربة، و أن عملي هو حياتي و أنه رسالة إنسانية عظيمة ليس من السهولة التضحية بها و بلا بلا بلا..أشياء كثيرة من مثل هذا الكلام الكبير، كلام الإنشاء المرسل، كان جزءًا كبيراً منه صحيحاً، لكنني قلته ليقول: أنا لن أسافر من غيرك، و ساعتها كنت سأسلم له نفسي بكل تفاصيلها، كلمة كنت انتظرها منه لتذيب سد الجليد الذي تراكم بيني و بينه، لكنه قال: كما تشائين! بعدها، متأخراً جداً قال: لو قلت لي ابق من أجلي، لبقيت. كلانا كان يجاهد ليبقي على الآخر.. ليبقي على العلاقة، كلانا تمسك بأهداب الأمل لآخر لحظة، و كلانا تلهف لسماع كلمة واحدة من الآخر، لكن كلانا صمت، و هكذا انتهى كل شيء. اتفقنا في ذاك الصباح البارد على الانفصال، هكذا ببساطة و دون مقدمات، و بهدوء من يناقش حلقة الأمس من مسلسليهما المفضل
"و الولد؟ "
قال، فنظرت إليه و صمت. كنت أعلم أن فرصه هناك أكبر بكثير من فرصه في دولة فقيرة كبلادنا، كنت أقول دائماً أن الحب تضحية، لكنني لم أضح من أجل من أحببت، كان من الممكن أن أتغاضى عن بروده و أبدأ صفحة جديدة أشعلها أنا و أجبره على الانصهار معي، لم يكن ليقاوم، و كان ينتظر، لو أنه لا يريدني لما طلب مني أن أصاحبه إلى كندا، كان سوف يخبرني و يسافر بكل بساطة، كانت محاولته تلك هي الحجر الأخير الذي ألقاه لتحريك الماء الراكد.. أنا لم أفهمه، هو أيضاً لم يفهمني، كان عليه أن يفهمني، لماذا يأخذ الرجال كل شيء كما هو؟ بسطحية شديدة؟! لم لا يحاولون قليلاً أن يفكروا في الكامن الخفي وراء ما نقول؟ لقد قلت كلاماً كثيراً.. سقت مبررات ظاهرها عدم الرغبة، لكن باطنها كان مفعماً بمشاعر الشوق و الاحتياج، أنا فقط أردت أن أقول له ابق معي هنا و سوف نحقق كل ما نريد سوياً و بقوة الحب، أردته أن يأخذني بين أحضانه..افتقدت عناقه، و لو فعلها، أو ربما لو فعلتها أنا!..
#مقبرة_الأفيال
#رواية
 Hitskin.com
Hitskin.com