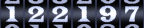استيراد الجاهليات.. بين الماضي والحاضر
كان معظم العرب يعبدون الله وحده على ملة ابراهيم عليه السلام إلى أن جاء عمرو بن لُحيّ، وهو الذي نشأ على أمر عظيمٍ من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدّين حتّى أحبّه الناس، ودانوا له ظنّاً منهم أنه من أكابر العلماء..
ثم إنه سار إلى الشام، فرآهم يعبدون الأوثان،فإستحسن ذلك وظنّه حقّاً لأن الشام محلّ الرسل والكتب، فرجع بصنم هُبل، وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه، ثم ما لبث أهل الحجاز و جزيرة العرب أن تبعوهم لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم.
كان عمرو رجلاً بسيطاً من قبيلة تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، لكنه كان منهزماً خانعاً بهويته، رأى الغرباء فظنهم خيراً منه بمدنهم الجميلة وتقدّمهم الظاهر، وربط ذاك كله بالحجارة التي ينحنون لها ويسألونها ويهدونها بكل سذاجة!
لم يعلم أنّ أهل الشام على تقدمهم الظاهر بحاجة لما عنده من العلم ونور التوحيد، وأنّ ما هم فرحون به لا يرفعهم عند الله شيئاً، إنما أعمت بصيرته أوهام الحضارة وخرافات صيتها الحسن المنتشر،
فإنبهر بالأبنية والقصور ورأى معها الأصنام تعبد من دون الله، فأفتتن بها وكان عليه وزر كل من تبعه في عبادتها، فما نال الخير الذي أراد بتقليد أهل الشام في الدنيا، وخسر الخسران المبين بما ضلّ وأضلّ في الاخرة..
وكم من أحفاد عمرو بن لحي بيننا اليوم..
ينظرون إلى الغرب بعين المعظّم الذي أعماه ضوء المدن وأفقده رشده صخبها، لا يرون فيهم إلا التقدم والتطور والمثالية الفاضلة، ومن ثمّ يسعون جاهدين لأخذ أي قطعة من حياتهم، سواء كانت فيلماً هوليوودياً أو عنواناً نسوياً أو بضع قوانين علمانية، ثم يقحمونها في بلادهم وثقافتهم ظناً أنهم بذلك لحقوا بالركب المشرّف..
و لا الصنم يناسب البيئة الجديدة ولا مستورده ينتفع بجهده شيئاً، والناس يتّبعون القويّ ويقلّدونه بلا تعقّل ولا وعي كما تبع أهل مكة عمرو، وكما تبعهم بعدها باقي العرب.
ولنا في مصير عمرو بن لحي ما يكفي من العظة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رَأَيْتُ عَمْرَو بنَ عامِرٍ الخُزاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ في النَّارِ. (رواه البخاري).
كان معظم العرب يعبدون الله وحده على ملة ابراهيم عليه السلام إلى أن جاء عمرو بن لُحيّ، وهو الذي نشأ على أمر عظيمٍ من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدّين حتّى أحبّه الناس، ودانوا له ظنّاً منهم أنه من أكابر العلماء..
ثم إنه سار إلى الشام، فرآهم يعبدون الأوثان،فإستحسن ذلك وظنّه حقّاً لأن الشام محلّ الرسل والكتب، فرجع بصنم هُبل، وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه، ثم ما لبث أهل الحجاز و جزيرة العرب أن تبعوهم لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم.
كان عمرو رجلاً بسيطاً من قبيلة تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، لكنه كان منهزماً خانعاً بهويته، رأى الغرباء فظنهم خيراً منه بمدنهم الجميلة وتقدّمهم الظاهر، وربط ذاك كله بالحجارة التي ينحنون لها ويسألونها ويهدونها بكل سذاجة!
لم يعلم أنّ أهل الشام على تقدمهم الظاهر بحاجة لما عنده من العلم ونور التوحيد، وأنّ ما هم فرحون به لا يرفعهم عند الله شيئاً، إنما أعمت بصيرته أوهام الحضارة وخرافات صيتها الحسن المنتشر،
فإنبهر بالأبنية والقصور ورأى معها الأصنام تعبد من دون الله، فأفتتن بها وكان عليه وزر كل من تبعه في عبادتها، فما نال الخير الذي أراد بتقليد أهل الشام في الدنيا، وخسر الخسران المبين بما ضلّ وأضلّ في الاخرة..
وكم من أحفاد عمرو بن لحي بيننا اليوم..
ينظرون إلى الغرب بعين المعظّم الذي أعماه ضوء المدن وأفقده رشده صخبها، لا يرون فيهم إلا التقدم والتطور والمثالية الفاضلة، ومن ثمّ يسعون جاهدين لأخذ أي قطعة من حياتهم، سواء كانت فيلماً هوليوودياً أو عنواناً نسوياً أو بضع قوانين علمانية، ثم يقحمونها في بلادهم وثقافتهم ظناً أنهم بذلك لحقوا بالركب المشرّف..
و لا الصنم يناسب البيئة الجديدة ولا مستورده ينتفع بجهده شيئاً، والناس يتّبعون القويّ ويقلّدونه بلا تعقّل ولا وعي كما تبع أهل مكة عمرو، وكما تبعهم بعدها باقي العرب.
ولنا في مصير عمرو بن لحي ما يكفي من العظة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رَأَيْتُ عَمْرَو بنَ عامِرٍ الخُزاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ في النَّارِ. (رواه البخاري).
 Hitskin.com
Hitskin.com