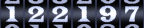أين الخلل الاقتصادي في مصر؟.. بقلم: السيد شبل
مؤكد أن الإرادة السياسية تسبق وجود الموارد (مادية وبشرية) من عدمها، بل أن اكتشاف مدى كفاية الموارد لتحقيق نهضة اقتصادية مبني بالأساس على «إرادة» توظيفها، بالشكل الذي يسد حاجات الشعب المادية والثقافية، وعليه فكل شيء يبدأ وينتهي عند القيادة السياسة التي تمسك بيدها مفاتيح القرار.
بتخصيص الضوء أكثر على التجربة في مصر، فإن الخلل والعائق دون النهضة متجسد في عديد من المسائل، لربما أكثرها طفوًا على السطح، هو ذلك المتعلق بـ«الفساد». وإن كان اختلال الضمير، أحد أسباب التدهور الاقتصادي، إلا انه لا يمكن أن يكون الوحيد، بل إن تركيز الضوء عليه، لا يخلو من غرض «تشويشي» يحول دون الالتفات إلى أسباب أخرى أكثر جذرية، وعلى الأغلب يعود تردي الوضع الاقتصادي إليها بدرجة أكبر، لا يجب -هنا- مثلا، أن نتجاهل أن رئيسة كوريا الجنوبية (أحد الدول التي يُضرب بها المثل في االتقدم الاقتصادي -مع التحفظ-)، رئيستها مدانة بالتورط في قضايا فساد، عبر إفساح دور أوسع لصديقتها في ممارسة عمليات ابتزاز لشركات رأسمالية كبرى، وقد تطيح بها تلك القضايا من على كرسي السلطة، وما يجري في كوريا الجنوبية، يجري في شتى دول العالم، وفي هذا السياق تأتي المحاكمة التي تجري لـ «كريتسين لاجارد» رئيسة صندوق النقد الدولي حاليا، لاتهامها بالإهمال، وهي الكلمة «المخففة» التي استعملتها الصحافة، عوضًا عن التواطؤ مع رجل أعمال فرنسي، حصّل من وراء «إهمالها» أكثر من 400 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة، عندما كانت لا جارد وزيرة اقتصاد فرنسا.
لكن كل «الفساد» السابق لم يحل دون تقدم تلك البلاد، (هذا مع الجزم بأن تقدم «كوريا الجنوبية أو فرنسا» هو تقدم على الصعيد الاقتصادي، ولا يعني بالضرورة تقدم اجتماعي، وإن كانت الأغلبية الشعبية تستفيد من فائض ما يرشح من الطبقات الثرية التي تكتنز ثرواتها من فوائض استثماراتها -نهبها- لموارد العالم الخارجي، إلا أن توزيع الثروة يبقى مخلخلا، والفجوات الطبقية عميقة في الداخل، ولا يجب هنا نسيان أن «كوريا الجنوبية» تحظى بدعم أورو-أمريكي واسع، ويتم فتح الأسواق أمام سلعها، ودعمها بالتكنولوجيا اللازمة وخطط التدريب، كونها تمثل قاعدة اقتصادية يُراد لها أن تكايد وتتفوق على النموذج الاشتراكي الذي تقدمه كوريا الشمالية، كما أنها تمثل قاعدة نفوذ للأمريكيين في شمال شرق آسيا، والمطلوب لهذه القاعدة أن تبقى قوية).
نعود فنقول، أن التركيز على «الفساد» مطلوب، لكن الإغراق فيه استنزاف وتعمية -مقصودة- على الأسباب الحقيقية، منها، على سبيل المثال:
1- استوزار الحكومات المصرية المتعاقبة، للموظفين الكبار في «الكارتلات الغربية» الشركات «متعددة الجنسيات»، ويُستخلص من تكرارها، أنها منهج حاكم للعمل المؤسسي في مصر، مرتبط -ولا شك- بالتبعية السياسية، و«طأطأة» الرؤوس أمام تعليمات مؤسسات المال الغربية، ومنظّريها «النيوليبراليين».. والحقيقة، أنه لا يمكن لعاقل نسج آمال تتعلق بـ (تنمية اقتصادية، وتصنيع، ونهضة مستقلة مبنية على رؤية اجتماعية سليمة، ورفع للصادرات وخفض للواردات)، من هذا الصنف من الحكومات التي تقيم أعمدتها على العاملين في الشركات متعدية الحدود، كون العامل فيها (خاصة لو كان قيادة إقليمية) فهو ابن ثقافتها، التي تقوم بالأساس، على التمكّن من غزو الأسواق، وتحجيم عمليات التصنيع في العالم الثالث وإجهاض التجارب القائمة، بالحروب المباشرة، أو الناعمة عبر تكثيف الدعاية ورشوة التاجر بالعلاوات (bonus) (ولو على مستوى حلوى الأطفال)، ثم تحقيق فوائض ربحية يتم تحويلها للعملات الأجنبية ونزحها للخارج!.
ما المنتظر من مسؤول أو موظف كبير بهذا النوع من الشركات؟
المتوقع -ببساطة- هو صفر كبير فيما يخص الشأن العام، وانحياز مؤكد لخلفيته الوظيفية، والتعامل مع مرحلة العمل الوزاري على أنها مسألة عابرة -مؤقتة- تضيف وجاهة اجتماعية، وتنتهي إلى “بند” يُضاف لسيرته الذاتية، ويحسّن من وضعه الوظيفي المستقبلي، والذي سيتأسس على علاقاته الواسعة التي منحها له المنصب!.
نحن هنا لا نضرب الودع، ومراقبة سيرة طابور طويل من الوزراء، وخلفياتهم المهنية، قبل وبعد العمل في الحكومة، ثم مضاهاته مع حجم إنجازهم، يؤكد ما نذهب إليه، وعبثًا يحاول البعض، عزل مشاريع «خصخصة» و«تفكيك أصول الدولة» التي تم الشروع فيها في عصر حسني مبارك، عن خلفيّات الوزيرين يوسف بطرس غالي، ومحمود محيي الدين، المرتبطة بالبنك والصندوق الدوليين، فالأول، كان يعمل بالصندوق بداية من 1981 ولمدة ست سنوات، قبل أن يتم التقاطه للدوران على عدد من الوزارت انتهت بالمالية، والثاني أنهى خدمته في الحكومة قبل شهور معدودات من يناير 2011، وسافر-بترشيح حكومي- ليتولى منصبُا انتدابيًا في البنك الدولي!.. وعندما يتم فقدان حلقات الوصل تلك تضيع أحد أهم معوّقات النهضة الاقتصادية في بلد مثل مصر.
كذلك اعتماد مبدأ «علمية» المسؤول الوزاري، دون النظر إلى ثقافته ووعيه الاجتماعي والسياسي والتاريخي، هي من ضمن «الحنظل» الذي يتم تبليعه للناس بعد إحاطته بغلاف من السكر، لأن الشخص المتميز عمليًا، بدون وعي، هو من الصنف مضمون الولاء للنظام العالمي في أصله أو نسخته المحلية، فـ «العلمي» النابغ في صنف من العلوم، بدون ثقافة، هو ببساطة، من نوع (الحمار حامل الأسفار)، معبّأ بذخيرة معرفية لكنه يجهل كيفية التصويب، ونوع الهدف، ومن هنا يسهل توظيفه!.. ولعل هذا يفسر إلحاح «الليبراليية» الغربية، دومًا على تمجيد «العلم» المستقل عن الوعي العام (خاصة في نمطه الاغترابي في المدارس والجامعات الدولية).. كونه ينتج “فنيين” مهرة للعمل في مؤسساتهم، لا يسألون، أو يشاكسون، أو يطالبون بما هو أزيد من لقمة العيش (من الجدير، هنا، الإشارة إلى تجربة كوبا، المتميزة في المجال الطبي، عامة، والعيون خاصة، رغم حصار من مطلع الستينات، وهي تدرّس لطلبتها الجامعيين، مواد عن أهمية مد يد العون إلى بلدان العالم الثالث، ومن هنا يأتي تصدرها البعثات الطبية في العالم كله؛ أو تجربة بوليفيا التي قررت افتتاح مدراس لمكافحة الإمبريالية عامة، والأمريكية خاصة، يدرس الطلبة فيها مواد في التاريخ والجغرافيا والسياسة).
2- فتح الأبواب على مصراعيها للاستثمار الأجنبي، بدون ضابط، أو حاكم، أو تحديد مسبق لنوعية المشروعات المطلوبة.. يقترن ما سبق، بتقديم حزمة من «الدعم» لكبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصلت في قوانين الاستثمار في السنوات الأخيرة (وبداية الخيط كان قانون رقم 90 لسنة 1971)، إلى حد منح جملة من الامتيازات «الصادمة»، منها:
إعفاءات جمركية وضريبية تصل إلى عشر سنوات، تخصيص الأراضي -أحيانًا- بالمجان (ورد هذا نصًا في تصريح لإبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق)، منح حق تملك أرض المشروعات للمستثمر بصرف النظر عن الجنسية، تحمل الدولة تأمينات العاملين عوضًا عن المستثمر، وتخفيض بأسعار الطاقة، منع أي جهة من التدخل في التسعير أو تحديد هامش الربح، تحصين العقود من طعن طرف ثالث خارج طرفي التعاقدات (لقطع الطريق على نخب اجتماعية وسياسية قد تتدخل، بالقانون، عند تنبّه الرأي العام لوجود خلل ما، كما جرى في عقود مدينتي التي تم تخصيص أراضيها البالغة 8 آلاف فدان بالأمر المباشر، وبسعر يقل عن السعر الطبيعي في المنطقة، وبالمثل في تعاقد الوليد بن طلال في أراضي توشكى، حين حاز جملة من الامتيازات، كان أقلها شراؤه الفدان بسعر 50 جنيه، ثم لم يستصلح من مائة ألف فدان سوى ستمائة!).
والأخطر -هنا- هو منح المستثمر الحق في تحويل كامل أرباحه، للخارج، في عملية «نزح ربح» صريح، يقوم بها المستثمر قاطعًا الطريق، على استمرارية دوران الرساميل في الداخل، رافعًا الطلب على العملة الأجنبية حيث يتم تحويل الربح (المصري) إليها، مما يعني بالضرورة خفض قيمة العملة الوطنية.
وكان الشاعر جمال بخيت، قد تناول هذه القضية، في أحد مقالاته، أشار فيه إلى أن نقاشَا جمعه بحكم عمله الصحفي، مع وزراء اقتصاديين، وتساءل: « لماذا لا تطرح الحكومة على الشعب المصرى تلك المشاريع.. فالشعب يملك -رسميا- إيداعات فى الجهاز المصرفى تقدر بأكثر من 1500 مليار جنيه، هذا عدا المليارات الموجودة خارج الجهاز المصرفى، وهذاغير الأموال التى يملكها المصريون فى الخارج. وإذا كانت الحكومة تقدم للمستثمر الأجنبى مشروعات مضمونة الربح، وتقدم له تسهيلات ومزايا لتجذبه.. فلماذا لا نقدم كل هذا لأصحاب الودائع فى البنوك المصرية؟.. بأن تؤسس شركات لإدارة هذه المشاريع وتطرحها للاكتتاب العام.. وهكذا تبقى الأرباح داخل مصر (نضيف: ويتسع نطاق الملكية)، وتسهم بالفعل فى زيادة الدخل القومى زيادة حقيقية يعاد ضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى». لكن على ما يبدو أن «بخيت» سمع كلامًا ترحيليًا، غير متجاوب مع طرحه!.
وأنهي، بخيت، مقاله، مشيرًا إلى «رقم 20 مليار جنيه، وهو يخص أرباح شركات المحمول، التى تحول أرباحها سنويا إلى الخارج، ماذا لو كانت شركات المحمول.. شركات مصرية، تحتفظ بكل هذه الأرباح داخل مصر، ألم يكن هذا أجدى؟!.» انتهى.
وطبعا هو أجدى وأنفع!، لكن في الحقيقة، ما لم يقله السادة الوزراء ردًا على طرح الشاعر/ جمال بخيب، هو أن تعليمات مؤسسات المال الغربية تضع «فيتو» على توسيع قاعدة الملكية «الملكيّات العامة»، وتريدها أن تبقى في قبضة «أقليّة»، ويأتي هذا تحت شعار فضفاض، هو «منع تدخل الدولة في الاقتصاد»!، دون التفات إلى أن الدولة تعني ببساطة، المؤسسات الإدراية، والأجهزة، وهي ملك الشعب، أما السلطة، فالمفترض أنها تنوب عن الشعب في إدارة ثرواته، ويمارس الأخير رقابته عليها، في المجالس الشعبية، كما يُفترض، قبل «النيابية» (التي تعزل، بالحقيقة القوى الشعبية عن ممارسة نشاطها السياسي)، وسلطة الحكم بالأخير (اختيار) الشعب في ظل نظام ديمقراطي، أما الرأسمالي الوافد عبر المحيطات، فهو حتى مجهول الاسم والرسم والجنسية، ولا يمارس الشعب عليه أي دور رقابي «مباشر»، ويحظى بامتيازات من «ضرائبه» و«ثرواته» لم يقرّه عليها!.
3- خلصنا حتى الآن، إلى أن مرجع الخلل، لا يُختصر في الفساد، وأنه يعود في قدر كبير منه، إلى غياب «الإرداة» و«التخطيط الاقتصادي»، وضعف «استقلالية القرار»، وتسليم مفاتيح البلاد إلى المستثمر الأجنبي، ووكيله المحلّي، الذي يرتدي ثوب رجل الأعمال، والتراخي أمام أي طرح ينادي بعودة القطاع العام للعب دوره في قيادة خطة التنمية.. لكن القضية لا تنتهي هنا.. وسنحاول في السطور القادمة، عرض ملخص سريع لما قاله «علي القادري» وعرضه «عامر محسن» في الأخبار اللبنانية، يدور في ذات الفلك، وإن كان يتعمق أكثر في تاريخ الاقتصاديات العربية، ومنها مصر، الملخص: «أًصل الأزمة الاقتصادية في مصر، والانخفاض السريع في سعر العملة، لم يبدأ من تحرير “سعر الصرف” (هذه ثمرة تخريب ممنهج)، وإنما من تحرير “الصرف” للعملة الأجنبية (من حق أي شخص -دون استفهام عن الغرض- تحويل العملة الوطنية إلى أجنبية، بما يؤدي لرفع الطلب على الأخيرة، وخفض الأولى)، وتحديد سعر ثابت لها، بصرف النظر عن نشاط “المستثمر” طالِب العملة الأجنبية، وهل هو في حاجة لها لنشاط إنتاجي “جمعي” المردود (فيتم دعمه بتخفيض السعر)، أم نشاط “استهلاكي” لا يفيد سوى شريحة ضيقة، ويؤدي إلى نزيف داخلي في النقد الأجنبي!، إن الأزمة الحاصلة مرجعها إلى السبعنيات، إلى انسحاب الدولة من التخطيط للنشاط الاقتصادي، تكيّفا، مع املاءات مؤسسات المال الغربية، بحيث جرى لها عملية “جزر” ملحوظة، وتخلّت عن دورها في دعم أنشطة وتثبيط أخرى، بحسب حاجة المجموع، كذلك رقابة التجارة الخارجية، مما أثمر تنامي النشاط الاستهلاكي “كمبوندات” و”محلات وجبات سريعة”، وغياب الإنتاج».
أما عن مشاريع البنية التحتية، وهي النوع الذي تتوسع فيه الحكومات التابعة، فيقول « هذه هي الأنشطة المحببة لـ”النيوليبراليين” باعتبارها نشاط دولتي “محايد” لا ينافس القطاع الخاص، بينما الحقيقة أنها أنشطة غير محايدة، وغالبا، ما تكون ذات مردود ضعيف على الأغلبية، لأنها تنحصر في توفير “طرق سريعة” و”مطارات شبيهة بالأوروبية” خدمة لشريحة ضيقة، مرتبطة بالمستثمر الأجنبي، وكما قال كارل ماركس عن القطار الذي بناه البريطانيون في الهند بأنه «من غير فائدة» للهنود العاديين (لأنه موجّهٌ لخدمة مصالح البريطانيين ودورة أعمالهم حصراً)، فإن أكثر البنى التحتية التي تموّلها الدولة الليبرالية هي من طبيعةٍ مماثلة».
ختامًا
لا نزعم الإلمام بمواطن الخلل هنا في مقال، ولكن حسبنا الإشارة إلى بعض المواطن، التي يتم تناسيها، والقفز عليها، والتركيز على حتمية تدخل الدولة لصالح الأغلبية (الحقيقة، أن السلطة الحاكمة تتدخل في كل الأحوال، فقط يختلف الطرف المستفيد من تدخلها، وهل هي الأغلبية؟، أم الأقلية مالكة الثروة والنفوذ؟)، ولا نغالي إن قلنا أن «الدعم» يتم تقديمه في كل الأحوال أيضًا، ولكن، يختلف، كذلك الطرف الذي يحوز عليه!.
ويكفي أن نذكر أن مصر بالستينات، كانت قد نجحت عبر شركة «النصر» للسيارات، بالإضافة، إلى تجميع عدد من الماركات الأجنبية (فيات، وشاهين..)، إنتاج سيارة مصرية «رمسيس2»، بمكوّن مصري في حدود الـ 30 %، وهي تطوير لشركة، برينز الألمانية، وكانت نسبة المكوّن المصري آخذة في الارتفاع، لولا أن المشروع برمّته تلقى «لطمة» في السبعينات، ضمن مشروع تخريبي عام… هل نذكر هذا من باب، البكاء على الماضي؟، لا، بل، نذكره فقط لنستعيد الثقة، وفي إمكانية البدء متى حضرت «الإرادة»، ولنشر هنا إلى، أن دولة مثل «إيران»، رغم أن لها سوابق في مسألة السيارات وتجميعها قبل الثورة وبعدها، إلا أنها حتى العام 1992، كانت تستحوذ السيارات المستوردة على نصف المبيعات المحلية، بسبب هوامش من السياسات النيوليبرالية «الانفتاحية بلا ضوابط» وقتها، رغم أن سنوات ما بعد الثورة شهدت إجراءات يسارية بوضوح تجسدت في (التأميمات، وسياسات دعم السلع الغذائية، والدفع نحو التصنيع المحلي والتنمية المستقلة، وسن قوانين عمل، واعتماد التعسير الإداري، وتوسيع ملكية القطاع العام، والتحكم في التجارة الدولية، وكبح انتشار الاحتكارات الغربية والاستثمار الأوروبي النازح للربح). وفي التسعينات مع بروز أزمة في العملات الصعبة، عاد الاعتبار لفكرة تطوير الإنتاج المحلي للسيارات، فجرى اعتماد سياسة دعم للصناعات الناشئة تم ترجمتها في الرسوم الجمركية المرتفعة التي كبحت استيراد السيارات الأجنبية، ثم تمت عملية تطوير لهذا القطاع (وكانت هناك سوابق في هذا المجال)، وتولّت شركتان حكوميتان هما إيران خدرو وسايبا (خدرو بالفارسية، تعني: السيارة) إنتاج خمس ماركات مختلفة من السيارات بالتعاون مع عدد من منتجي قطع الغيار المحليين نحو 800 شركة خاصة، ومع طوابير من المهندسين المتخصّصين في تصميم المركبات، الذين يعملون في مؤسسات «الدولة» البحثية، وكانت الثمرة ارتفاع المكوّن المحلي للسيارات حتى وصل إلى نحو 80 % من قيمتها الإجمالية، ونهض الإنتاج السنوي في الأعوام الأخير إلى 1,39 مليون مركبة، واليوم تحتل موقع الصدراة بين منتجي السيارات في «الشرق الأوسط»، ورقم «12» على مستوى العالم، وتدور صادراتها على بلدان مثل روسيا وبيلا روسيا والبرتغال والجزائر وسوريا و العراق ولبنان وعدد من دول أمريكا الجنوبية.. وهذه ثمار امتلاك الإرادة والتخطيط الاقتصادي.
مؤكد أن الإرادة السياسية تسبق وجود الموارد (مادية وبشرية) من عدمها، بل أن اكتشاف مدى كفاية الموارد لتحقيق نهضة اقتصادية مبني بالأساس على «إرادة» توظيفها، بالشكل الذي يسد حاجات الشعب المادية والثقافية، وعليه فكل شيء يبدأ وينتهي عند القيادة السياسة التي تمسك بيدها مفاتيح القرار.
بتخصيص الضوء أكثر على التجربة في مصر، فإن الخلل والعائق دون النهضة متجسد في عديد من المسائل، لربما أكثرها طفوًا على السطح، هو ذلك المتعلق بـ«الفساد». وإن كان اختلال الضمير، أحد أسباب التدهور الاقتصادي، إلا انه لا يمكن أن يكون الوحيد، بل إن تركيز الضوء عليه، لا يخلو من غرض «تشويشي» يحول دون الالتفات إلى أسباب أخرى أكثر جذرية، وعلى الأغلب يعود تردي الوضع الاقتصادي إليها بدرجة أكبر، لا يجب -هنا- مثلا، أن نتجاهل أن رئيسة كوريا الجنوبية (أحد الدول التي يُضرب بها المثل في االتقدم الاقتصادي -مع التحفظ-)، رئيستها مدانة بالتورط في قضايا فساد، عبر إفساح دور أوسع لصديقتها في ممارسة عمليات ابتزاز لشركات رأسمالية كبرى، وقد تطيح بها تلك القضايا من على كرسي السلطة، وما يجري في كوريا الجنوبية، يجري في شتى دول العالم، وفي هذا السياق تأتي المحاكمة التي تجري لـ «كريتسين لاجارد» رئيسة صندوق النقد الدولي حاليا، لاتهامها بالإهمال، وهي الكلمة «المخففة» التي استعملتها الصحافة، عوضًا عن التواطؤ مع رجل أعمال فرنسي، حصّل من وراء «إهمالها» أكثر من 400 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة، عندما كانت لا جارد وزيرة اقتصاد فرنسا.
لكن كل «الفساد» السابق لم يحل دون تقدم تلك البلاد، (هذا مع الجزم بأن تقدم «كوريا الجنوبية أو فرنسا» هو تقدم على الصعيد الاقتصادي، ولا يعني بالضرورة تقدم اجتماعي، وإن كانت الأغلبية الشعبية تستفيد من فائض ما يرشح من الطبقات الثرية التي تكتنز ثرواتها من فوائض استثماراتها -نهبها- لموارد العالم الخارجي، إلا أن توزيع الثروة يبقى مخلخلا، والفجوات الطبقية عميقة في الداخل، ولا يجب هنا نسيان أن «كوريا الجنوبية» تحظى بدعم أورو-أمريكي واسع، ويتم فتح الأسواق أمام سلعها، ودعمها بالتكنولوجيا اللازمة وخطط التدريب، كونها تمثل قاعدة اقتصادية يُراد لها أن تكايد وتتفوق على النموذج الاشتراكي الذي تقدمه كوريا الشمالية، كما أنها تمثل قاعدة نفوذ للأمريكيين في شمال شرق آسيا، والمطلوب لهذه القاعدة أن تبقى قوية).
نعود فنقول، أن التركيز على «الفساد» مطلوب، لكن الإغراق فيه استنزاف وتعمية -مقصودة- على الأسباب الحقيقية، منها، على سبيل المثال:
1- استوزار الحكومات المصرية المتعاقبة، للموظفين الكبار في «الكارتلات الغربية» الشركات «متعددة الجنسيات»، ويُستخلص من تكرارها، أنها منهج حاكم للعمل المؤسسي في مصر، مرتبط -ولا شك- بالتبعية السياسية، و«طأطأة» الرؤوس أمام تعليمات مؤسسات المال الغربية، ومنظّريها «النيوليبراليين».. والحقيقة، أنه لا يمكن لعاقل نسج آمال تتعلق بـ (تنمية اقتصادية، وتصنيع، ونهضة مستقلة مبنية على رؤية اجتماعية سليمة، ورفع للصادرات وخفض للواردات)، من هذا الصنف من الحكومات التي تقيم أعمدتها على العاملين في الشركات متعدية الحدود، كون العامل فيها (خاصة لو كان قيادة إقليمية) فهو ابن ثقافتها، التي تقوم بالأساس، على التمكّن من غزو الأسواق، وتحجيم عمليات التصنيع في العالم الثالث وإجهاض التجارب القائمة، بالحروب المباشرة، أو الناعمة عبر تكثيف الدعاية ورشوة التاجر بالعلاوات (bonus) (ولو على مستوى حلوى الأطفال)، ثم تحقيق فوائض ربحية يتم تحويلها للعملات الأجنبية ونزحها للخارج!.
ما المنتظر من مسؤول أو موظف كبير بهذا النوع من الشركات؟
المتوقع -ببساطة- هو صفر كبير فيما يخص الشأن العام، وانحياز مؤكد لخلفيته الوظيفية، والتعامل مع مرحلة العمل الوزاري على أنها مسألة عابرة -مؤقتة- تضيف وجاهة اجتماعية، وتنتهي إلى “بند” يُضاف لسيرته الذاتية، ويحسّن من وضعه الوظيفي المستقبلي، والذي سيتأسس على علاقاته الواسعة التي منحها له المنصب!.
نحن هنا لا نضرب الودع، ومراقبة سيرة طابور طويل من الوزراء، وخلفياتهم المهنية، قبل وبعد العمل في الحكومة، ثم مضاهاته مع حجم إنجازهم، يؤكد ما نذهب إليه، وعبثًا يحاول البعض، عزل مشاريع «خصخصة» و«تفكيك أصول الدولة» التي تم الشروع فيها في عصر حسني مبارك، عن خلفيّات الوزيرين يوسف بطرس غالي، ومحمود محيي الدين، المرتبطة بالبنك والصندوق الدوليين، فالأول، كان يعمل بالصندوق بداية من 1981 ولمدة ست سنوات، قبل أن يتم التقاطه للدوران على عدد من الوزارت انتهت بالمالية، والثاني أنهى خدمته في الحكومة قبل شهور معدودات من يناير 2011، وسافر-بترشيح حكومي- ليتولى منصبُا انتدابيًا في البنك الدولي!.. وعندما يتم فقدان حلقات الوصل تلك تضيع أحد أهم معوّقات النهضة الاقتصادية في بلد مثل مصر.
كذلك اعتماد مبدأ «علمية» المسؤول الوزاري، دون النظر إلى ثقافته ووعيه الاجتماعي والسياسي والتاريخي، هي من ضمن «الحنظل» الذي يتم تبليعه للناس بعد إحاطته بغلاف من السكر، لأن الشخص المتميز عمليًا، بدون وعي، هو من الصنف مضمون الولاء للنظام العالمي في أصله أو نسخته المحلية، فـ «العلمي» النابغ في صنف من العلوم، بدون ثقافة، هو ببساطة، من نوع (الحمار حامل الأسفار)، معبّأ بذخيرة معرفية لكنه يجهل كيفية التصويب، ونوع الهدف، ومن هنا يسهل توظيفه!.. ولعل هذا يفسر إلحاح «الليبراليية» الغربية، دومًا على تمجيد «العلم» المستقل عن الوعي العام (خاصة في نمطه الاغترابي في المدارس والجامعات الدولية).. كونه ينتج “فنيين” مهرة للعمل في مؤسساتهم، لا يسألون، أو يشاكسون، أو يطالبون بما هو أزيد من لقمة العيش (من الجدير، هنا، الإشارة إلى تجربة كوبا، المتميزة في المجال الطبي، عامة، والعيون خاصة، رغم حصار من مطلع الستينات، وهي تدرّس لطلبتها الجامعيين، مواد عن أهمية مد يد العون إلى بلدان العالم الثالث، ومن هنا يأتي تصدرها البعثات الطبية في العالم كله؛ أو تجربة بوليفيا التي قررت افتتاح مدراس لمكافحة الإمبريالية عامة، والأمريكية خاصة، يدرس الطلبة فيها مواد في التاريخ والجغرافيا والسياسة).
2- فتح الأبواب على مصراعيها للاستثمار الأجنبي، بدون ضابط، أو حاكم، أو تحديد مسبق لنوعية المشروعات المطلوبة.. يقترن ما سبق، بتقديم حزمة من «الدعم» لكبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصلت في قوانين الاستثمار في السنوات الأخيرة (وبداية الخيط كان قانون رقم 90 لسنة 1971)، إلى حد منح جملة من الامتيازات «الصادمة»، منها:
إعفاءات جمركية وضريبية تصل إلى عشر سنوات، تخصيص الأراضي -أحيانًا- بالمجان (ورد هذا نصًا في تصريح لإبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق)، منح حق تملك أرض المشروعات للمستثمر بصرف النظر عن الجنسية، تحمل الدولة تأمينات العاملين عوضًا عن المستثمر، وتخفيض بأسعار الطاقة، منع أي جهة من التدخل في التسعير أو تحديد هامش الربح، تحصين العقود من طعن طرف ثالث خارج طرفي التعاقدات (لقطع الطريق على نخب اجتماعية وسياسية قد تتدخل، بالقانون، عند تنبّه الرأي العام لوجود خلل ما، كما جرى في عقود مدينتي التي تم تخصيص أراضيها البالغة 8 آلاف فدان بالأمر المباشر، وبسعر يقل عن السعر الطبيعي في المنطقة، وبالمثل في تعاقد الوليد بن طلال في أراضي توشكى، حين حاز جملة من الامتيازات، كان أقلها شراؤه الفدان بسعر 50 جنيه، ثم لم يستصلح من مائة ألف فدان سوى ستمائة!).
والأخطر -هنا- هو منح المستثمر الحق في تحويل كامل أرباحه، للخارج، في عملية «نزح ربح» صريح، يقوم بها المستثمر قاطعًا الطريق، على استمرارية دوران الرساميل في الداخل، رافعًا الطلب على العملة الأجنبية حيث يتم تحويل الربح (المصري) إليها، مما يعني بالضرورة خفض قيمة العملة الوطنية.
وكان الشاعر جمال بخيت، قد تناول هذه القضية، في أحد مقالاته، أشار فيه إلى أن نقاشَا جمعه بحكم عمله الصحفي، مع وزراء اقتصاديين، وتساءل: « لماذا لا تطرح الحكومة على الشعب المصرى تلك المشاريع.. فالشعب يملك -رسميا- إيداعات فى الجهاز المصرفى تقدر بأكثر من 1500 مليار جنيه، هذا عدا المليارات الموجودة خارج الجهاز المصرفى، وهذاغير الأموال التى يملكها المصريون فى الخارج. وإذا كانت الحكومة تقدم للمستثمر الأجنبى مشروعات مضمونة الربح، وتقدم له تسهيلات ومزايا لتجذبه.. فلماذا لا نقدم كل هذا لأصحاب الودائع فى البنوك المصرية؟.. بأن تؤسس شركات لإدارة هذه المشاريع وتطرحها للاكتتاب العام.. وهكذا تبقى الأرباح داخل مصر (نضيف: ويتسع نطاق الملكية)، وتسهم بالفعل فى زيادة الدخل القومى زيادة حقيقية يعاد ضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى». لكن على ما يبدو أن «بخيت» سمع كلامًا ترحيليًا، غير متجاوب مع طرحه!.
وأنهي، بخيت، مقاله، مشيرًا إلى «رقم 20 مليار جنيه، وهو يخص أرباح شركات المحمول، التى تحول أرباحها سنويا إلى الخارج، ماذا لو كانت شركات المحمول.. شركات مصرية، تحتفظ بكل هذه الأرباح داخل مصر، ألم يكن هذا أجدى؟!.» انتهى.
وطبعا هو أجدى وأنفع!، لكن في الحقيقة، ما لم يقله السادة الوزراء ردًا على طرح الشاعر/ جمال بخيب، هو أن تعليمات مؤسسات المال الغربية تضع «فيتو» على توسيع قاعدة الملكية «الملكيّات العامة»، وتريدها أن تبقى في قبضة «أقليّة»، ويأتي هذا تحت شعار فضفاض، هو «منع تدخل الدولة في الاقتصاد»!، دون التفات إلى أن الدولة تعني ببساطة، المؤسسات الإدراية، والأجهزة، وهي ملك الشعب، أما السلطة، فالمفترض أنها تنوب عن الشعب في إدارة ثرواته، ويمارس الأخير رقابته عليها، في المجالس الشعبية، كما يُفترض، قبل «النيابية» (التي تعزل، بالحقيقة القوى الشعبية عن ممارسة نشاطها السياسي)، وسلطة الحكم بالأخير (اختيار) الشعب في ظل نظام ديمقراطي، أما الرأسمالي الوافد عبر المحيطات، فهو حتى مجهول الاسم والرسم والجنسية، ولا يمارس الشعب عليه أي دور رقابي «مباشر»، ويحظى بامتيازات من «ضرائبه» و«ثرواته» لم يقرّه عليها!.
3- خلصنا حتى الآن، إلى أن مرجع الخلل، لا يُختصر في الفساد، وأنه يعود في قدر كبير منه، إلى غياب «الإرداة» و«التخطيط الاقتصادي»، وضعف «استقلالية القرار»، وتسليم مفاتيح البلاد إلى المستثمر الأجنبي، ووكيله المحلّي، الذي يرتدي ثوب رجل الأعمال، والتراخي أمام أي طرح ينادي بعودة القطاع العام للعب دوره في قيادة خطة التنمية.. لكن القضية لا تنتهي هنا.. وسنحاول في السطور القادمة، عرض ملخص سريع لما قاله «علي القادري» وعرضه «عامر محسن» في الأخبار اللبنانية، يدور في ذات الفلك، وإن كان يتعمق أكثر في تاريخ الاقتصاديات العربية، ومنها مصر، الملخص: «أًصل الأزمة الاقتصادية في مصر، والانخفاض السريع في سعر العملة، لم يبدأ من تحرير “سعر الصرف” (هذه ثمرة تخريب ممنهج)، وإنما من تحرير “الصرف” للعملة الأجنبية (من حق أي شخص -دون استفهام عن الغرض- تحويل العملة الوطنية إلى أجنبية، بما يؤدي لرفع الطلب على الأخيرة، وخفض الأولى)، وتحديد سعر ثابت لها، بصرف النظر عن نشاط “المستثمر” طالِب العملة الأجنبية، وهل هو في حاجة لها لنشاط إنتاجي “جمعي” المردود (فيتم دعمه بتخفيض السعر)، أم نشاط “استهلاكي” لا يفيد سوى شريحة ضيقة، ويؤدي إلى نزيف داخلي في النقد الأجنبي!، إن الأزمة الحاصلة مرجعها إلى السبعنيات، إلى انسحاب الدولة من التخطيط للنشاط الاقتصادي، تكيّفا، مع املاءات مؤسسات المال الغربية، بحيث جرى لها عملية “جزر” ملحوظة، وتخلّت عن دورها في دعم أنشطة وتثبيط أخرى، بحسب حاجة المجموع، كذلك رقابة التجارة الخارجية، مما أثمر تنامي النشاط الاستهلاكي “كمبوندات” و”محلات وجبات سريعة”، وغياب الإنتاج».
أما عن مشاريع البنية التحتية، وهي النوع الذي تتوسع فيه الحكومات التابعة، فيقول « هذه هي الأنشطة المحببة لـ”النيوليبراليين” باعتبارها نشاط دولتي “محايد” لا ينافس القطاع الخاص، بينما الحقيقة أنها أنشطة غير محايدة، وغالبا، ما تكون ذات مردود ضعيف على الأغلبية، لأنها تنحصر في توفير “طرق سريعة” و”مطارات شبيهة بالأوروبية” خدمة لشريحة ضيقة، مرتبطة بالمستثمر الأجنبي، وكما قال كارل ماركس عن القطار الذي بناه البريطانيون في الهند بأنه «من غير فائدة» للهنود العاديين (لأنه موجّهٌ لخدمة مصالح البريطانيين ودورة أعمالهم حصراً)، فإن أكثر البنى التحتية التي تموّلها الدولة الليبرالية هي من طبيعةٍ مماثلة».
ختامًا
لا نزعم الإلمام بمواطن الخلل هنا في مقال، ولكن حسبنا الإشارة إلى بعض المواطن، التي يتم تناسيها، والقفز عليها، والتركيز على حتمية تدخل الدولة لصالح الأغلبية (الحقيقة، أن السلطة الحاكمة تتدخل في كل الأحوال، فقط يختلف الطرف المستفيد من تدخلها، وهل هي الأغلبية؟، أم الأقلية مالكة الثروة والنفوذ؟)، ولا نغالي إن قلنا أن «الدعم» يتم تقديمه في كل الأحوال أيضًا، ولكن، يختلف، كذلك الطرف الذي يحوز عليه!.
ويكفي أن نذكر أن مصر بالستينات، كانت قد نجحت عبر شركة «النصر» للسيارات، بالإضافة، إلى تجميع عدد من الماركات الأجنبية (فيات، وشاهين..)، إنتاج سيارة مصرية «رمسيس2»، بمكوّن مصري في حدود الـ 30 %، وهي تطوير لشركة، برينز الألمانية، وكانت نسبة المكوّن المصري آخذة في الارتفاع، لولا أن المشروع برمّته تلقى «لطمة» في السبعينات، ضمن مشروع تخريبي عام… هل نذكر هذا من باب، البكاء على الماضي؟، لا، بل، نذكره فقط لنستعيد الثقة، وفي إمكانية البدء متى حضرت «الإرادة»، ولنشر هنا إلى، أن دولة مثل «إيران»، رغم أن لها سوابق في مسألة السيارات وتجميعها قبل الثورة وبعدها، إلا أنها حتى العام 1992، كانت تستحوذ السيارات المستوردة على نصف المبيعات المحلية، بسبب هوامش من السياسات النيوليبرالية «الانفتاحية بلا ضوابط» وقتها، رغم أن سنوات ما بعد الثورة شهدت إجراءات يسارية بوضوح تجسدت في (التأميمات، وسياسات دعم السلع الغذائية، والدفع نحو التصنيع المحلي والتنمية المستقلة، وسن قوانين عمل، واعتماد التعسير الإداري، وتوسيع ملكية القطاع العام، والتحكم في التجارة الدولية، وكبح انتشار الاحتكارات الغربية والاستثمار الأوروبي النازح للربح). وفي التسعينات مع بروز أزمة في العملات الصعبة، عاد الاعتبار لفكرة تطوير الإنتاج المحلي للسيارات، فجرى اعتماد سياسة دعم للصناعات الناشئة تم ترجمتها في الرسوم الجمركية المرتفعة التي كبحت استيراد السيارات الأجنبية، ثم تمت عملية تطوير لهذا القطاع (وكانت هناك سوابق في هذا المجال)، وتولّت شركتان حكوميتان هما إيران خدرو وسايبا (خدرو بالفارسية، تعني: السيارة) إنتاج خمس ماركات مختلفة من السيارات بالتعاون مع عدد من منتجي قطع الغيار المحليين نحو 800 شركة خاصة، ومع طوابير من المهندسين المتخصّصين في تصميم المركبات، الذين يعملون في مؤسسات «الدولة» البحثية، وكانت الثمرة ارتفاع المكوّن المحلي للسيارات حتى وصل إلى نحو 80 % من قيمتها الإجمالية، ونهض الإنتاج السنوي في الأعوام الأخير إلى 1,39 مليون مركبة، واليوم تحتل موقع الصدراة بين منتجي السيارات في «الشرق الأوسط»، ورقم «12» على مستوى العالم، وتدور صادراتها على بلدان مثل روسيا وبيلا روسيا والبرتغال والجزائر وسوريا و العراق ولبنان وعدد من دول أمريكا الجنوبية.. وهذه ثمار امتلاك الإرادة والتخطيط الاقتصادي.
 Hitskin.com
Hitskin.com