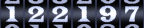الأصولية والإسلام السياسي، مفردات استشراقية أطلقها المستشرقون على تنوعهم منذ عنايتهم بالشرق الإسلامي، تجلى هذا وبرزت ملامحه عندما عهد مستشرقو نابليون إلى استحداث وتأطير وتشذيب بعض المفردات التي تشير إلى الصورة التي يريدون لها أن تنتشر «تجزئة الإسلام إلى معتدل ومتطرف»،
ورسم صورة مكذوبة عن الإسلام والمسلمين،لتتأصل ويسهل عليهم قيادة الوعي الجمعي إلى مبتغاهم التنصيري والاستعماري بالأساس حتى وإن لم يكن هذا الاستعمار عسكريا بشكل مباشر
كما في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ولكن يكفيهم أن يتبنى أفراد من بيننا صنعوهم على أعينهم نفس الخطاب ووجهة النظر،
بل ويصبحوا من المدافعين عنها دفاعا قتاليا حد انعدام حمرة الخجل كونهم ناقلين ومتبنين لحصيلة عمل وجهود لفيف من المتآمرين وهم لهم طائعين وبوقا أكثر نفيرا.
عصر التنوير الأوروبي:
عصر التنوير الأوروبي:
في القرون الأوروسطى (العصور الوسطى الأوروبية) وهذه التسمية لتمييز العصور الوسطى الأوروبية عن عصورنا الوسطى الإسلامية،
فالأولى كانت وبالا عليهم دفعتهم للثورة على رجال الكنيسة المتحكمين فيهم «باسم الدين» تبنى هذه الثورة بادئ ذي بدء فلاسفة التنوير الأوروبيين،
أمثال «سبينوزا ولوك» وهذا على عكس تماما العصور الوسطى الإسلامية
والتي كانت عصور تنوير ونهضة حقيقية «باسم الدين» نعم الإسلام وحده كان هو الدافع الحقيقي لهذه النهضة ومن يختلف معي في ذلك فعليه أن يجيبني عن سؤال حيوي ومهم ألا وهو:
وماذا كان العرب قبل الإسلام؟
وماذا كان العرب قبل الإسلام؟
قبائل متناحرة، يعيشون حياة بدائية دون الحضارة في أبسط تعريف وتوصيف لها،
فهم لم يعرفوا فقه الدولة ولا مفرداتها ولا شكل النظام السياسي الواجب اتباعه ولا القوانين وتصنيفها وتبويبها ولا التعاطي والتفاعل مع الشكل الهرمي للنظام الحاكم،
وإزاء هذه المفردات لا يسعك إلا أن تضع أمام كل منها صفر كبير دال على فراغهم المعرفي والحياتي بها.
بينما رجال الكنيسة في أوروبا كانوا يحكمون باسم الدين دون الاستناد إلى منهج إلهي شامل يقوي دعائمهم،
فقط يتكئون على لباسهم الكهنوتي دون منهج يخاطبون به الجموع، وإن كانوا يدعون غير ذلك ولكن الواقع كان أبلغ في الرد عليهم،
فمن بيع صكوك الغفران إلى قتل العلماء لأنهم هراطقة، أمثال «كوبرنيكس»
وهذا ما دفع الفلاسفة الأوروبيين لاستبعاد الدين تماما من سياسة الدولة بعد أن ذاقوا الويلات على أيديهم،
مما دفع «توماس جيفرسون» لأن يقول:
مما دفع «توماس جيفرسون» لأن يقول:
في حالة اتحاد الدين والسياسة تسقط الدولة، وفي حالة انفصالهما تنتعش.
والحق أنه في ذلك كان محقا لأن رجال الكنيسة ارتكبوا باسم الدين المخازي والمآسي التي أوردتهم موارد التهلكة.
بينما القرآن كتاب تام الأحكام، شامل جامع لكل ما سبقه من شرائع وهذا بديهي ومنطقي لأن الإله واحد،
ولابد أن يكون الدين واحد وإن تعددت الشرائع، وهذا الدين هو الذي أورث العرب المجد الذي حققوه فيما بعد،
ثم غابت أمجادهم عندما تشتت أذهانهم واستبعدوا الدين من حياتهم، ونقضوه عروة عروة فأصبحوا كلأ مستباحا لكل ذي مأرب.
يقول برنارد لويس (مستشرق يهودي صهيوني أمريكي من أصل إنجليزي):
يقول برنارد لويس (مستشرق يهودي صهيوني أمريكي من أصل إنجليزي):
«الإسلام واحد من أعظم ديانات العالم، ودعوني أكن واضحا حول ما أقصده بهذا، باعتباري مؤرخا غير مسلم للدين الإسلامي.
لقد منح الإسلام الراحة والطمأنينة لملايين لا تحصى من الرجال والنساء، فقد أعطى كرامة ومعنى للحياة التي كانت رتيبة، تعيسة، وبائسة، كما أنه علم شعوبا من أعراق مختلفة أن يعيشوا حياة أخوية، وجعل شعوبا مختلفة المشارب أن تتعايش جنبا إلى جنب في تسامح معقول،
كما أنه ألهم حضارة عظيمة عاش فيها المسلمون وغيرهم حياة خلاقة ومفيدة، وهذه الحضارة أغنت العالم بأسره بما حققته من إنجازات،
وعلى شاكلة غيره من الأديان، فقد عرف الإسلام فترات نفخ فيها روح الكراهية والعنف في أتباعه،
ومـن سوء حظنا فإن جزء من العالم الإسلامي وليس كله بل ولا يشكل الأغلبية لا يزال يرزح تحت وطأة هذا الميراث،
ومن سوء حظنا أن غالبية وليس كل هذه الكراهية والعنف موجهة ضدنا في الغرب»
سبق أن تعرضت هنا لمؤلف لـ«برنارد لويس» بعنوان «أين الخطأ» والذي فيه ينفي تماما أن يكون للمسلمين أي منجز حضاري يذكر،
ولكنه في لحظة «صدق العالم» مع نفسه لم يستطع أن يبخسنا حقنا كما فعل مؤخرا قبل وفاته،
لأن التزييف والكذب يطيح بمصداقية العالم والمؤرخ بل وينهيه، فلا يسمع ولا يؤخذ بقوله طالما أنه استند لأباطيل مع سبق الإصرار والترصد.
ولي هنا وقفة،
ولي هنا وقفة،
بداية كيف للدين الذي امتدحه هو نفسه (وهو الماسوني الصهيوني المتعصب) أن يكون بهذا الثقل باعترافه، هو نفسه الذي يورثنا الكراهية والعنف تجاه الغرب كما يزعم، ديننا ليس دين محبة،
الإسلام دين عملي ونحن كبشر أغيار، مشاعرنا متقلبة، ولو كان دين محبة لخضع الآخر لمزاجنا الشخصي، لأهوائنا،
ولكنه نفى ذلك تماما، فالإسلام الذي وصفه بالعظيم هو دين عدل وتسامح مع من نحب ومن نكره،
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)
(المائدة: 
أما العنف والكراهية الموجهة ضدهم،

أما العنف والكراهية الموجهة ضدهم،
فهم من زرعها وهي حصاد سلوكهم تجاهنا على وجه الخصوص، فمن الحروب الصليبية إلى الاستشراق،
فالاستعمار العسكري ثم مؤخرا استعمارا مقنع، بغية الاحتواء الشامل لنا كي نضل ونشقى، هم من أفسد بلادنا وحياتنا ومازالوا،
ولا يتناهون عن منكر فعلوه تجاهنا، بل هم بنيان مرصوص يشدون من أزر بعضهم البعض كي يعملوا على ديمومة فعلهم.
ثم يعترف صراحة أن العالم الإسلامي ليس هو الأشد تطرفا ومغالاة في معاداتهم،
وأن حضورهم في بلادنا طاغ ومهيمن في كل المناحي الثقافية والاقتصادية والدبلوماسية، فلا يعانون ما عنوه في فيتنام وكوبا.
أعداء الله:
أعداء الله:
ويشرح فيما بعد للقارئ أبعاد مصطلع «أعداء الله» وهو الوصف الذي يطلقه المتشددون على حسب زعمه لكل من يقبل بالحضارة الغربية برمتها كقوانين وسياسات وقيم اجتماعية،
ثم يقول فكرة أن لله أعداء وأنه بحاجة لمعونة البشر لتحديدهم والتخلص منهم عصية على فهمه ولكنها ليست مستهجنة،
ثم يناقض نفسه فيقول مفهوم «أعداء الله» شائع في أدبيات العصور الوسطى وما قبلها في العهدين القديم والجديد كما في القرآن.
وهنا أحيله إلى «وليم جاي كار»
وهنا أحيله إلى «وليم جاي كار»
وهو يستصرخ الأمريكان بالتصدي للماسونية التي كانت تزحف تجاه أمريكا قبل مائة عام ونشرت «القيم والقوانين»
التي يتباهى بها الآن ويرى أن من يرفضها متطرف وإرهابي،
وأن أمريكا التي ينتمي إليها كما انجلترا التي ينحدر منها كانت مجتمعات بقيم دينية تحافظ على الشكل الديني التقليدي للأسرة
ويوعزون إلى الله كل فضيلة يجب اتباعها ومراعتها،
لدرجة أن «وليم جاي» كان كلما أسهب لم ينس في رفضه
وتحذيره للمجتمع من التقيم بهذه القيم المنافية لتعاليم الرب أن يستشهد بآيات من الإنجيل التي تدعم موقفه،
وبعد أن خضعت هذه المجتمعات لابتزاز جنود إبليس «أعداء الله» كما نسميهم وصلوا إلى طريق مسدود يهدد سلامتهم،
وأبرز الدلائل الاجتماعية على ذلك استقبالهم لمهاجرين من بلدان أخرى كي يحافظوا على ديمومتهم وإلا انتهوا إلى جملة من العجائز الذين لا يجدون من يخدمهم،
ناهيك عن الدلائل الأخرى السياسية والاقتصادية، فإن لم يسمى من قادهم إلى هذا المصير أعداء الله فما هي التسمية الصحيحة لهم؟
أما وهو الماسوني الصهيوني العلماني
أما وهو الماسوني الصهيوني العلماني
فإنه يريد أن يقودنا إلى عقيدة الماسونية ألا وهي أن لهذا الكون إلهان،
إله الشر وهو الله «تعالى وتنزه عما يصفون»
وإلـه الخير وهو الشيطان،
فيقول هو نفسه أن هذا المعتقد كان قديما في الديانات الوثنية القديمة «الثنوية الإيرانية، والزرادشتية الهندية» على سبيل المثال،
وهذا المعتقد ترك آثاره على اليهودية والمسيحية والإسلام،
وبذلك فإن العالم الكبير ساوى بين الوثنيات القديمة والتي أنشأها الشيطان الذي يمجده وبين الشرائع السماوية المنزلة من الله!!
هكذا هو يعتقد.
ولأن الله قضى بنصرة هذا الدين بالبار والفاجر، فإن لويس يعود ليعترف بنفسه قائلا:
«القرآن بالطبع توحيدي بشكل راسخ، ويؤمن بإله واحد، وقوة كونية واحدة»
بالطبع الإله واحد وليس شركة متعددة الآلهة، والقوة الكونية المهيمنة هي قوة الله.
لويس الذي انتهى إلى أن الشرائع السماوية تأثرت بالوثنيات القديمة والتي مازالت قائمة في صور شتى،
هو نفسه الذي ينتقد الإسلام بضراوة لأنه يرفض قيمه وقوانينه ويوعز إليه فكرة «أعداء الله»
رغم اعترافه بوجودها في اليهودية والمسيحية، ولكن الحرب الآن على الإسلام فقط،
بالتالي يجب أن توضع في هذا الإطار وحده لكي يحاربوا «الإرهاب».
وللحديث بقية إن شاء الله
وللحديث بقية إن شاء الله

 Hitskin.com
Hitskin.com